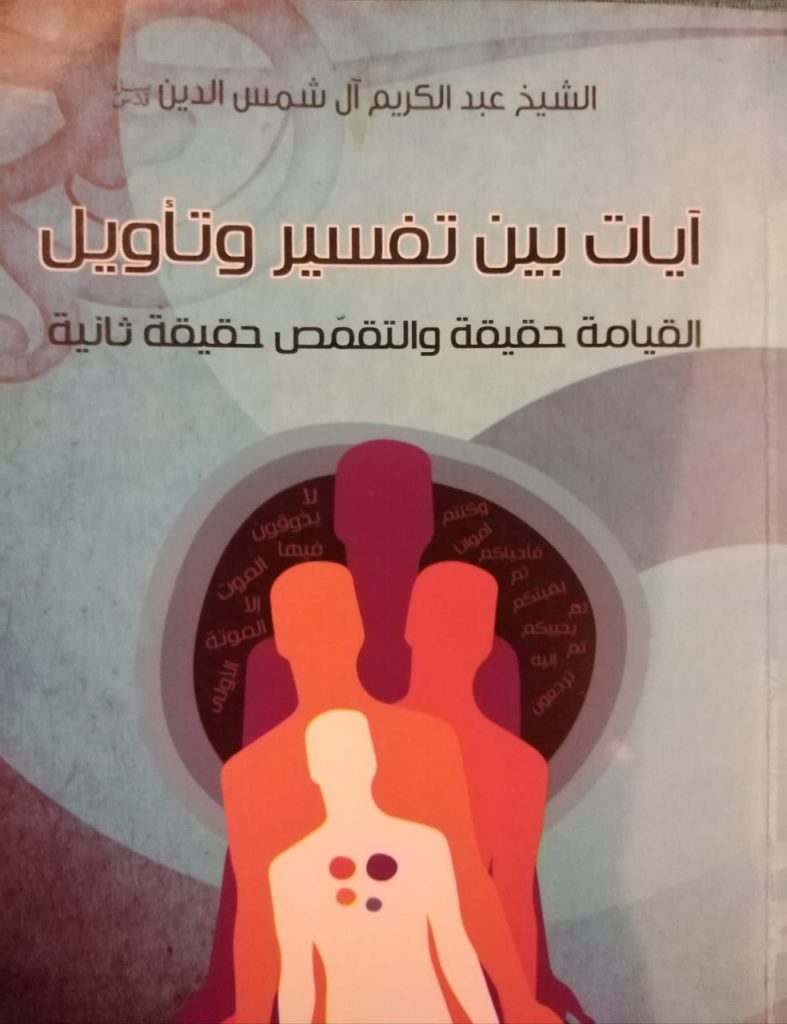الشيخ عبد الكريم شمس الدين([1])
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لا كتاب أصفى وأصدق من القرآن ولا كلام . كيف وهو كلام الله. وكفى بذلك حجةً دامغة وبرهاناً لا أبلغ ولا أسطع.
وفي أكثر من كتاب ومقالة، كتبنا من وجهتنا وكتب أهل الفكر وأولو الألباب من وجهاتهم في تاريخ البشرية، محققين مثبتين مؤكدين، بشتى الأدلة اليقينية، أنَّ هذا القرآن لا ريب فيه تنزيل من رب العالمين. وكفى بالله شهيداً، قوله عزَّ وجل: ﴿ألم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (السجدة: 1 ـ 2).
لذلك كما في كل موضوع مهم من مواضيع الحياة البشرية، حياة الإنسان الموصولة دنياها بالآخرة، لشد ما يطيب لي ويسعدني ويغريني الجهاد في بحثه ـ جهاداً في سبيل الله سبحانه ـ انطلاقاً من القرآن الكريم وانتهاءً بالقرآن الكريم. وتراني كلما قلت هذا أفق أقف عنده، انبلجت أمام بصيرتي آفاق أخر، أعرض واعمق وأجمل، ويبعد مرمى البصر، واكتشف المعنى الأسمى للطموح غير الدنيوي، ويشتد الجناحان، ويطيب التحليق .. وما أحبَّ الله.. وما أحبَّ الله.. وما أعظم الله.. ما أعظم الله.. وما أكرم وما أعطى، وما أعلم وما أرحم، له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.
لذلك و في أفق آخر طيب مغرٍ مسعد، وفقني إليه الله سبحانه وأذِن به، وأرشدني إلى مداميكه و زواياه وحناياه وسقوفه ومضامين لغاته ـ في حدود إنسانية الإنسان، هذا الأفق، هو البحث والتحقيق في موضوع: القضاء الإلهي. فلدى هذا الأفق الكريم، أقف مستلهماً ربي العظيم، ربي الله، أسأله هدايته، وأسأله عونه، واسأله تسديده وترشيده واستكمال هذا البحث، وتيسيره بما يرضيه، ليبارك فيه، ويجعله سبيل خير وتوفيق، واستنارة، ونجاة ورفع درجات، لمن يشاء ولمن يحب من عباده.
مقدّمةٌ
وأول ما نقدم به لهذا الموضوع، موضوع «القضاء الإلهي»، طبعاً من القرآن الكريم، قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً﴾ (الإسراء: 23).
قال الله تعالى ذلك ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ…﴾ فأطاعه أقوام استدعوا إنعامه، وعصاه أقوام استدعوا غضبه، وضل عن سبيله أقوام فتفرقت بهم السبل المؤدية إلى الجحيم.
فمعنى (قضى) هنا في هذه الآية، أي أمَرَ قاطعاً جازماً: ﴿أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً…﴾ .
ونجد هذه الخلاصة الرائعة المترتبة على هذا القضاء الإلهي، فيما علَّم البشرية من دعاء يُدعى به سبحانه في فاتحة كتابه الكريم: ﴿اهْدِناَ الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الْضَّالّيِنَ﴾ (الفاتحة: 6 ـ 7).
ويرد هذا الأمر الإلهي بين دفتي القرآن الكريم، حتى لكأنما قضاؤه هذا ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ…﴾ يلخص القرآن كله: تارة بمضامين القصص القرآني، وتارة بمضامين الأمثال، وتارة بمضامين السور، وكثيراً كثيراً في تفاصيل الآيات والأوامر المباشرة، وهذا نمط منها، قوله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ * وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: 21 ـ 24).
في هذه الفقرة من الآيات أربعُ وقفات ملزمات للعقل البشري، وبالقوة التي يستحيل ردّها أو تلافيها أو تجنبها: الوقفة الأولى: الأمر بالعبادة . الثانية: تبريرها. الثالثة: التحدي المذهل. الرابعة: النذير بالعذاب .
فالوقفة الأولى، التي هي أمره الجازم بالعبادة، تقتضي فهم العبادة، كما يحددها هو سبحانه، جملة في كتابه، وتفصيلاً على ألسن أنبيائه ورسله. فالمعنى المجمل المرادف للعبادة في كتاب الله هو الطاعة. فعبادة الله تبارك وتعالى هي طاعته، طاعته فيما أمر به، وفيما نهى عنه، وفيما شرع من أحكام وسنَّ من سنن وأنهج من مناهج، لحياة الفرد ولحياة الجماعات.
وجعل سبحانه في عبادته مجالات للترقي فيها وبها، من درجاتها العليا ـ للمطيعين ـ درجة الواصلين ودرجات المقربين. وهذه الدرجات تبدأ بالجهاد، وتنتهي بالحبِّ، وبه أي بالحبَّ، الحبُّ الأعظم، ومعه، تتضاءل المتع الحسية المادية، لتحل محلها سعادة هي الأسمى في السعادات، يتضح شأنها مع هذا السؤال: أنت تحب الجنة أكثر أم تحب الله؟ وفي كل حب منهما سعادة، إنما السعادة في الجنان قد توصف بكلام، وإنما السعادة في حب الله عزَّت عزَّته، يكبو عندها الفكر وتضمحل الحروف وكل وسائل التعبير الإنسانية.
ووقفة العقل الثانية في الفقرة القرآنية التي ذكرنا، قلنا هي التبرير . تبرير العبادة: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 22).
ما دامت الغاية من تعبيد الإنسان أو تطويعه، هي مصلحته في الوصول إلى حقيقة السعادة، فإن الله سبحانه لم يفرض عليه أن يتوصل إلى ذلك في ظروف صعبة أو مستحيلة. وإنما جعله ينعم بالطاعات، إن هو أطاع، في ظروف تتلاءم مع بنيته وطباعه التي طبعه الله عليها.
وقوله تعالى في الآية: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء… ﴾.
فلو نظر الإنسان إلى الأرض نظرة المتأمل السوي المعافى في نفسه وبدنه ـ ويكون كذلك مع الطاعات ـ لوجدها من الناحية الحسية قريبة جداً إلى نفسه، وهو طالما أقرَّ بذلك: فتارة سماها وطناً، وتارة مهد طفولة ومرتع صبا ومستودع آثار آباء وأجداد، وتارة يسميها الأم الطيبة …
ولو نظر إلى السماء، لشعر بدافع أو بدوافع إلى التسامي ـ وهو من ميزات خلق الله لها ـ والانعتاق، وعميق التفكر توصلاً إلى الحقائق العليا.
وهو في كلا النظرتين، يجد إذا أمعن النظر، زاوية جمالية، تتسع و تتسع، مع الطاعات، إذ مع الطاعات شمول العافية.. تتسع وتتسع حتى تصبح دائرة كاملة، بل ودوائر، بل و كرةً أرضية، ما أجمل، ضمن كرة سماوية و لا أجمل، ذلك في الحياة الدنيا. وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء…﴾.
أما قوله تعالى: ﴿…وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ…﴾ فيعني استكمل بذلك لكم كل عناصر الحياة، وفي ذلك تكتب كتب ومصنفات وموسوعات، ولا تنتهي الكتابة عما خلق الله في الأرض من مخلوقات، إذا انقطع عنها ماء السماء ماتت، وماتت معها الأرض وتبخرت البحار والأنهار..
فما أغنى وما أجمل هذه الطبيعة التي وضعك الله في أحضانها أيها الإنسان، وما أكرم وما أسمى ما تولَّاك به من العناية والرعاية والعطاءات.. مع الطاعات. هذا في الحياة الدنيا. أما في الآخرة فلك من السعادات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر.
أيها الناس، لكم مع عبادة الله، أي طاعته، سعادة الدارين. ذلك من وعود الله في القرآن الكريم، في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذلك نحسّه ونراه بأم العين وعمق البصيرة، بل ونعيشه بفضل من الله بكل خفقة في قلوبنا، وبين الخفقة والخفقة، نعيشه حالة من التوفيق والهداية والبركات، ليل نهار. ونستدل بالقرآن، ونسافر في القرآن، ونكتشف وننتجع، ونستزيد وما أغزر معينه، وما أعذب رفده، وما أصدق وعده وربنا الله المجيد سبحانه يقول: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 23).
وتلك هي وقفة العقل الثالثة، الموجبة الملزمة.
نكتب الآن وقد مضى على نزول القرآن أربعة عشر قرناً ونيف، دالت فيها دولٌ، وزالت أمم، وظهرت أمم، وكلهم وقفوا وما زالوا يقفون، بمفكريهم وعباقرتهم أمام هذا الكتاب الفريد الجوهر، المعجز المتحدي للعالمين، وقفوا ويقفون يتفكرون ويتأملون، ويحاولون ـ ولا سيما أعداء الله وأعداء دينه ـ تسجيلَ مطعن جدي واحد على هذا القرآن، فلم يجدوا، وهو مستحيل أن يجدوا. بعدما صدمتهم وما زالت تصدمهم البينات والحجج الدامغة والبراهين الساطعة يوماً بعد يوم في عمر هذا الدهر الطويل. ويتحدى البشرية قول الله عزَّ وجل في كتابه المجيد هذا، وعلى الدوام: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ…﴾.
فهل هو البناء اللغوي فقط، وهل هو الجرس الموسيقي إضافة إلى هذا البناء، وهل وهل؟… وتتكاثر الأسئلة… مئات الأسئلة، وتجد في القرآن دائماً لكل سؤال جواباً. وما زال الأمر كذلك، حتى دخل القرن الخامس عشر الهجري ـ الواحد والعشرين الميلادي، قرن التكنولوجيا، والكمبيوتر والإلكترون والمدهشات الحسابية والآلات التي لم يكن يحلم بها الفكر البشري، وإنما الله سبحانه يعلّم ويعلّم، وأين للإنسان ولو قطرة من محيطات علم الله وإطلاقاته. وسلَّطوا الأضواء الحديثة المدهشة على القرآن، واستعانوا بالعقول الإلكترونية السريعة العمليات، بحثاً وتدقيقاً، فما استطاع كل ذلك أن يجد ولو ثغرة ذات بال في هذا السفر المجيد. فركعت الآلات وسجدت الإلكترونيات لله عزَّ وجل ولكلام الله، وستبقى ساجدة إلى قيام الساعة، ولربما سيأتي بعدها جيل من العلماء وكذلك معهم جيل من الآلات والمخلوقات الصناعية، فسيسجدون كذلك كما سجد الآباء الآدميون والآليون وسيبقون ساجدين إلى قيام الساعة.
وتختم الموقف وتحسمه في الفقرة القرآنية تلك، الوقفة العقلانية المفزعة الرابعة، تلك التي بعد التحدي بألهانية القرآن مباشرة، تلك التي هي النذير بالعذاب: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: 24).
﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ﴾ أيها الناس، أي إن لم تستجيبوا لهذا التحدي آتين بسورة من مثل القرآن. ثم يردف سبحانه ويقول: ﴿وَلَن تَفْعَلُواْ﴾ أي ولن تأتوا بسورة من مثله إطلاقاً ولو اجتمع من أجل ذلك الإنس والجن ومن شئتم من خلق الله، أو من صنع أيديكم. مستحيل أن يأتي أحد غير الله، بسورة من مثل القرآن الكريم، كما هو مستحيل أن يدرك أحد من أهل الأرض جميع معاني ووجوه الأحرف النورانية أو مفاتيح السور التي في القرآن، مثل ﴿كهيعص﴾ و ﴿حم عسق﴾ و ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ وغيرها من الرموز القرآنية المطلسمة، والتي يبين أثرها للعارفين، كما يبين أثر أشعة الليزر أو غاما أو غيرها من أنواع الطاقة التي تنبعث من شتى الأجهزة العلمية المعقدة، المصنوعة ـ كما علَّم الله ـ بكفاءة عالية، حيث كما هو معلوم، تُرى الأجهزة، وغالباً، لا تُرى الطاقة، وإنما يظهر أثرها في الأبدان وعامة الأشياء التي تُسلط عليها.
وكلمة ﴿لَن﴾ في اللغة العربية، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَن تَفْعَلُواْ﴾ تفيد، في فقه اللغة، النفي القطعي.
فإذاً، إن لم تفعلوا، وتأتوا بسورة من مثل القرآن، من تلك السور المسكونة بالأسرار، وأنواع وألوان الطاقة، المتداولة بين العلماء والناس ـ والتي هي من خلق الله ـ وغير المتداولة، والتي لن تُعلم معانيها جميعاً وكامل آثارها وفاعلياتها إلاَّ بعد البعث وفي عالم الملكوت، أعني الحروف والآيات النورانية، لأنها ستكون من لغة أهل الملكوت، تلك هي المثاني. ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ﴾ وتأتوا بمثلها ﴿وَلَن تَفْعَلُواْ﴾ ثم مع ذلك كفرتم بالقرآن وبآياته، وبأنه جميعه من لدن الله عزَّ وجل وتبارك وتعالى وبأنه مُلزِم لكم بمضامينه نصاً وروحاً، ﴿فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.
من آمن نجا وسعد سعادة الأبد، ومن لم يؤمن، فما أكثر التحذير والنذير في القرآن الكريم، وهذا منها، ومن أكثرها إفزاعاً: ﴿فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ…﴾ ووقودها ﴿الْحِجَارَة﴾. فأن تكون الحجارة وقوداً للنار، هذا متصوّر، وحاصل عند أهل الأرض، وهو مما ينتج حرارة أشدّ، ولا سيما إذا كانت الحجارة جبالاً صخرية هائلة، حيث يعبر عنها في بعض القرآن بقوله عزَّ وجل ﴿…تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ (المرسلات: 32). ولكن غير المتصور عند أهل الأرض، عملياً في الأرض، أن يكون الناس وقوداً للنار، أي أن بهم تشعل النار وتُسعّر، أي يكونوا مكان الحطب أو ما شابه. فصدق الله العليّ العظيم، هو جبار السماوات والأرض… هو الرحمن الرحيم… وهو المنتقم الجبار: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (غافر: 20).
فإن جميع خلق الله، من ملائكة وإنس وجن وغير ذلك، إذا دعوتهم من دون الله مجتمعين ومنفردين، لا يقضون بشيء، ولا يستطيعون إجابةً و لا عملاً، حتى ولو كانوا من الملائكة المقربين أو الأنبياء والمرسلين أو أولياء الله الصالحين .
لم أؤمن بالتقمُّص إلاَّ لأنه حقيقةٌ قرآنية
في جملة القضاء الإلهي الذي انطلقنا منه في هذا المدخل، حقيقتان قرآنيتان: هما حقيقة الموتة الواحدة، التي لا موت بعدها، وحقيقة التقمص، التي تعني أكثر من موتة أو أكثر من حياة، في عالم ما قبل الآخرة.
ولقد تحدثت عن القرآن، ولقد تحدثت قمم الفكر البشري من قبل وستبقى تتحدث حديث اليقين من بعد، أن القرآن الكريم، هو الكتاب المنزل من لدن الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله، وأنه من الأصفى والأصدق، بين جميع الكلام الموجود، والذي سيوجد بعد تحت هذه السماء الدنيا، وبدون قياس.
لذلك لن أستعين بسوى الله، احتجاجاً بكلامه سبحانه واحتكاماً، دائماً وأبداً، إلى كتابه المجيد. وهو حسبي له الحمد، لا شريك له، عليه توكلت وإليه أنبت وإليه المصير: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ (الزمر: 36 ـ 40).
وكلمة ﴿هُنَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿…إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ…﴾ تعني عامة نفوس الخلائق، من ملائكة وجن وأنواع ودرجات البشر، وكذلك الجمادات من أصنام وأوثان وغير ذلك.
وحيث أني بهداية من الله سبحانه وتسديد، وإذن ورعاية، انكشفت لي حقيقة التقمص في القرآن الكريم، في ثنايا آيات كثيرة من آياته، بين العبارة والإشارة، واللطف والحقيقة، وعملاً بقوله سبحانه واستجابةً لأمره، وحرصاً على رضاه، وتجنباً لسخطه، كما أسلفت في الكلام عن الآية الكريمة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ﴾. [ 159: البقرة ] قررت، ودائماً بإذنه تعالى، أن أكتب في هذا القضاء الإلهي الذي هو حقيقة الحياة الواحدة وحقيقة الحيواة العدّة، وبينهما حقيقة المسخ، أي تحويل الشكل الإنساني، إلى أشكال غير إنسانية.
بين القرآن والمكتبة العالمية
قد لا يبالي بحجية القرآن، من لا يعرف عظمة القرآن وحقيقة القرآن ولا يدري أنه، أي القرآن الكريم، يَرجُح المكتبة العالمية بما فيها من الكتب والموسوعات والتسجيلات والعلوم والآثار.. يَرجُحها جميعاً وبدون قياس. وانه ليحرم القياس، لأن القرآن كلام الله، وكفى بالله هادياً ومعلماً. وبكلمة أخرى أن المكتبة العالمية، بعضاً أو كلاً، يكون لها قيمة إيجابية إذا صدقها القرآن الكريم، وشهد لها بالإيجابية، وشهادة القرآن هي شهادة الله تعالى شأنه، فإذا ندَّ منها، أو نشز ما يعارض كتاب الله، كان هذا النادّ أو الناشز، إما كفراً، وإما خطأً، وإما ثقافةً تبنّيةً.
وليت الأمر عند اللامبالين، يقف عند حد اللامبالاة، أو الرفض او التكذيب، أو العناد، أو الرأي الشخصي أو التشكيك. لو كان الأمر كذلك، لهان وهانت معه المسؤولية، أما وقد قال الله تعالى ما يلي، فما العمل وأين المفرُّ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلاَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سبأ: 31 ـ 33).
وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ الأحقاف: 7).
وهؤلاء الذين يقولون عن الآيات البينات التي تتحدث عن الحق والحقيقة: هذا سحر مبين، أي خداع واختراع وما شابه، موجودون ليس فقط خارج أمة القرآن بل وفي داخلها: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ (البقرة: 16).
مع سيد المراجع وحده (القرآن الكريم)
منذ صباي، كان لله شأنٌ كبيرٌ، في اهتمامي المتزايد بكتابه المجيد بشكل عام من جهة، ومن جهة أخرى ببعض الخصوصيات المصيرية الكبيرة في هذا الكتاب المجيد. وبطريقة متداخلة: هي القراءة في القرآن من جهة، وفي أرض الواقع من جهات أخرى: بين قراءة في كتاب مما في المكتبة العالمية، أو مجلة، أو فيلم، أو سماع مع التبين، حين يمكن التبين، أو أي مرجع آخر أو مصدر من مصادر التراث.
وفي جملة هذه الخصوصيات الكبيرة، كان اهتمامي بقضية التقمص، فقرأت بين مذاهب ومعتقدات الشرق والأقصى، ولا سيما منها الهندية، وبين بعض المذاهب المحلية، أي الشرق أوسطية، وسمعت الكثير، ثم إني كنت أحياناً أسعى للإستماع من ثقات ليس لأنهم يعتقدون بهذا الأمر، وإنما لأنهم على دعواهم عاينوه وعايشوه، ولذلك اعتقدوه وصدقوا به.
إذاً، تجمع عندي الشيء الكثير، لتدعيم هذا الإعتقاد من خارج القرآن. ولما كنت شديد الخوف والخشية من الوقوع في الخطأ أو الزلل أو حتى الشبهة، نحَّيت جميع ما لديَّ من وثائق مكتوبة أو مسموعة، وصممت على الإعتماد على ربي العظيم وحده، في إرشادي إلى نفي هذا الأمر وردّه، أو إحقاقه وإثباته، وفقط في كتابه المجيد. لأني على يقين، كنت وما زلت وسأبقى إن شاء ربي الله الذي لا إله إلاَّ هو، على يقين لا يهتز ولا يتزعزع، وإنما يزيد بعمق واتساع، بأن هذا القرآن، هو كتاب الله الذي ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصّلت: 42). وأنه سبحانه وتعالى أنزله على عبده ورسوله محمّد(ص) ﴿…تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ… ﴾ (النحل: 89).
التقمُّص والمسخ في القرآن
كان من جملة ما استوقفني في القرآن، قول الله عزَّ وجل: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 65 ـ 66).
يخاطب سبحانه اليهود: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ…﴾ أي الذين خالفوا أمر الله، في ابتلاء ابتلاهم به، هو صيد السمك، منعهم عن صيده يوم السبت وحجب السمك عنهم بقية أيام الإسبوع، تربيةً لإرادتهم وإلقاءً للحجة عليهم، فلم يصبروا على ذلك، فاصطادوه يوم السبت عصياناً وعناداً. وقوله تعالى: ﴿…فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ أي مسخهم قردة أذلاء مطرودين من رحمته. إلى هنا إجماع المسلمين مفسرين ومؤوِّلين، على ذلك، أي على حجّية الظاهر وقوة ظهوره. وزيادة على هذا كله فإن في التوراة مصاديق لهذه الحقيقة التاريخية، ولا بدع في ذلك فإن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة ومهيمن عليه كما جاء في القرآن الكريم.
إلاَّ أن اليهود بذلوا جهوداً جبارة، لينفوا حقيقتين: الأولى هي أن الله عزَّ وجل جعل منهم القردة والخنازير، أصلاً حيث لم يكن قبل ذلك في الأرض قردة ولا خنازير، وذلك واضح في قوة بيان النص القرآني في سورة المائدة قوله تبارك وتعالى:
﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ * قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ﴾ (المائدة: 59 ـ 60).
والحقيقة الثانية، هي بقاء الممسوخين مدة أعمارهم وتناسلهم، وذلك سنراه في حقيقة استمرار المسخ والتقمص في الحيواة الدنيا، وبوضوح وجلاء لا يدعان مجالاً لأي شك أو تردد في صدقية هذه الحقيقة.
وبالإسرائيليات المتعارفة المشهورة في تاريخ الدسِّ اليهودي وتحوير الكلم عن مواضعه والطعن في أكباد الحقائق والكذب التاريخي الذي مارسوه وما زالوا يمارسونه على جميع جبهات الحياة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسلام الحنيف، ورصيده المبارك وكنزه الأعظم القرآن الكريم. بهذه الإسرائيليات تمكنوا من أن يدخلوا في كتب التفسير القرآني نفيهم لهاتين الحقيقتين في جملة ما عمدوا إليه من تزوير وتشويه في قضايا أخر. وهكذا فقد وجدنا، وحتى في أجلِّ كتب التفسير.. ربما، في تفسير قوله تعالى: ﴿…فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً…﴾: معمياتٍ وفرضياتٍ، لا سند لها، لا من كتاب ولا من سُنَّة ولا من حديث صحيح ولا من رواية مؤكدة. ولقد استطاعوا أن ينسبوا هذه الأخبار إلى صحابة أجِّلاء أمثال ابن عباس ومجاهد وغيرهما ربما من كبار الأئمة. زاعمين أن هؤلاء القردة المسوخ «بقوا ثلاثة أيام لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا ثم أهلكهم الله تعالى وجاءت ريح فهبّت بهم وألقتهم في الماء» وأنه «ما مسخ الله أمة إلاَّ أهلكها…” ولم يقولوا كم يوماً يبقي الأمة ممسوخة قبل أن يهلكها، ولم يعلقوا على الغاية من قصر المدة ـ التي هي فقط ثلاثة أيام ـ ما داموا سيعذبون بعد ذلك بعذاب أعظم وأبقى. وبأن هذه المزاعم يمجُّها العقل وحتى الذوق السليم، فضلاً عن الحاجة الملِحَّة إلى نص من الكتاب أو من صحيح الأحاديث، نقبلها طبعاً، ولو كان الديدن الذي نعمل في ضوئه وحده، هو القرآن المجيد، ولازم ذلك يقيناً أن يقبلها هو أولاً، أي القرآن العظيم.
وأكثر من هذا كله في طريقة الدسِّ الإسرائيلي وقلب الحقائق: فقد أبرزوا في القرن العشرين رجلاً، قلب كلياً حقيقة أن الله جعل منهم القردة والخنازير، هو (داروين) مؤسساً بحثاً مطولاً ومُعقَّداً، مُسبغاً عليه صفات البحث الموضوعي الأكاديمي، ليخرج منه بالنتيجة المدبَّرة على طريقة «بروتوكولات حكماء صهيون» وهي أن البشر كلهم أصلهم قرود. تماماً لينفوا الواقع المأساوي الذي هو قضاء الله في جماعتهم التي مسخها سبحانه قردةً خاسئين. وذلك كما هو واضح ردّ على الله وطعنٌ مدروسٌ في كتابه المجيد.
نعم، لقد وقع طيبوا القلوب من المفسرين في فخِّ الإسرائيليات كما وقع أكثر الناس في فخِّ «العلامة» داروين في كتابه «أصل الأنواع» الذي استطاعت أبواق الصهيونية أن تجعل منه مفترقاً تاريخياً في مجال الإعتقاد المعاكس للحقائق والنواميس والقضاء الإلهي، القضاء الذي لن تستطيع ردّه أو طمسه، أو تغييره كل محاولات الجن والإنس وبقية الخلائق، فضلاً عن محاولات بني إسرائيل.
وكثيراً ما يقع طيبوا القلوب في فخاخ المفسدين في الأرض، ذلك لأنهم لا يتنبهون إلى واجب الأخذ بالحذر، فطيبة القلب فضيلة، إلاَّ أنها إذا لم تقرن بفضيلة الحذر ومعرفة أصناف البشر، تتحول إلى السلبية التي قد يتسع ضررها، حتى يشمل ليس أمة أو أمتين، وإنما قد يشمل العالم، في تحويل أفكارهم عن مسار الحق إلى مسار الباطل.
وزيادة في طيبة قلوب المفسرين، وإغراقاً في عدم الحذر من عدوهم المتربص بهم دائماً وأبداً، وحتى يقضي الله أمراً كان مفعولا. فإنهم ـ أي المفسرين ـ لم يلتفتوا إلى كامل مضمون الآية الثانية التي بعد قوله تعالى: ﴿…فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً…﴾ وهي قوله عزَّ وجل: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا…﴾ فإن فيها عزّ الحقيقة والطعنة النجلاء للمفسدين والمسرفين ﴿…الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ…﴾ (الفتح: 6).
فأوّلاً: في قوله تعالى:﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾، فقد ذكروا أن الهاء فيها «راجعة إلى الأمة التي مسخت، وهم أهل القرية على شاطيء البحر» ولو كان الأمر كذلك لكان قال سبحانه: فجعلناهم، ولا سيما بعد قوله: ﴿…فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً…﴾ وقيل: إن الهاء راجعة إلى المسخة.. عن الزجاج، أو إلى العقوبة.. عن ابن عباس، أو إلى القرية التي اعتدى أهلها فيها.
والحقيقة ـ وإن كان يجوز مثل هذا التحول في الصياغات الكلامية، وفي القرآن منه الكثير ـ إلاَّ أن ذلك بعنايات ولغايات واضحة. وهنا كذلك الأمر، فإن العناية والغاية أوضح من كل هذا اللبس في تعدد الإحتمالات، وأجدر بأن يكون المقصود، هو التفريق بالخطاب بين العقلاء والبهائم . فمعلوم في اللغة أن العقلاء يُخاطبون أو يُحكى عنهم ويُكنى عنهم بالضمائر المذكرة، وغير العقلاء بالضمائر المؤنثة. وهنا في الآية الكريمة: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ..﴾ واضح أن الخطاب للعقلاء يعني بلغة المذكر ـ ولو كان المجموع ذكوراً وإناثاً ـ ثم قوله تعالى: ﴿.. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ..﴾ كذلك هو خطاب مستمر لعقلاء فلما قال سبحانه ﴿قِرَدَةً﴾، لزم أن يكون الكلام الآتي عنها لغير العاقل، أي بصيغة التأنيث. لذلك جاءت الآية الثانية هكذا: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا..﴾، أي تلك القردة. هذا في أصل توجيه الآيتين. وبعد ذلك لا يمنع من التوسع فيقال أن المقصود كذلك الأمة، أو القرية ـ علما أن القرية لم تُمسخ كلُّها ـ أو العقوبة، على ما نُسِب ـ إذا صحَّ ـ إلى ابن عباس. ولا يخفى أن الإصرار على واحدة من هذه، هو تحكّم بدون مبرِّر ولا مرجِّح.
بقي في الآية الكريمة هذه، الدليل الأوضح والأهم، قوله تعالى: ﴿…نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا…﴾.
قبل أن نتحدث عن الدليل في الآية، نذكر المعنى اللغوي لكلمة نكال: النكال: الإرهاب للغير، وأصله المنع لأنه مأخوذ من النكل وهو القيد. وهو أيضاً اللجام. وسميت العقوبة نكالاً لأنها تمنع عن ارتكاب مثلما ارتكبه من نزلت به . ونكل فلان بفلان تنكيلاً ونكالاً. وزيد في معناها هنا أنها اشتهار وفضيحة وتذكرة وعبرة.
أما معنى قوله تعالى: ﴿…لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا…﴾ فلا يمكن أن يكون إلاَّ ما بين يديها من الأمم التي تراها، وما خلفها، أي خلف هذه الأمم، أي التي بعدها على أساس أن توجه الجميع إلى الآخرة.
وعلى هذا الأساس، من الأقوى بالضرورة، أن يبقى، شكل النكال، أو نموذجه، ماثلاً أمام الناس، على توالي الأجيال والأمم، ليكون دائماً رادعاً للعصاة، فإن لم يكن رادعاً، فسيكون عليهم حجة دامغة، لا تناقش إلا بجدال المبطلين.
وأقوى من كونها رادعاً للعصاة المغضوب عليهم، جعلها سبحانه في مقابل النكال ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ وفي ذلك دليل واضح على أن من فعل مثل أفعال هؤلاء، أي عصى وعاند وتمرد يستحق من العقاب، أو يلحقه من العقاب، مثلما لحقهم وحلَّ بهم من المسخ، تشويهاً لوجوههم وأبدانهم، وتعذيباً لنفوسهم، وتحذيراً وتخويفاً للمؤمنين الأتقياء، لكي يحرصوا على طاعة الله عزَّ وجل والصبر على بلاءاته مهما كانت الأثمان.
التقمُّص والمسخ أمران جاريان في الحياة الدنيا
يُستفاد مما قدمنا، أن التقمص والمسخ أمران جاريان في الحيواة الدنيا للمخلين، أما المطيعون فلا يموتون إلاَّ الموتة الواحدة.
فإذا كان جعل القردة والخنازير محصوراً في اليهود وحدهم فهذا يعني أمرين:
الأوّل: أنه ما دام توالد القردة والخنازير حاصلاً، فهذا يعني أنه بنفس المقدار حاصل المسخ في اليهود.
الثاني: أن التقمص أمر عام في حياة البشرية.
يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى عن صنف من الناس يقولون: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الدخان: 35 ـ 36).
﴿إِنْ﴾ هنا أداة نفي، والمعنى: ما هي إلاَّ موتتنا الأولى. وحقيقة المعنى أن الله سبحانه ينكر عليهم قولهم ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى..﴾ ولو كانت هي موتة أولى، أي موتة واحدة بالنسبة إليهم، لما أنكر سبحانه عليهم ذلك. ولم يكن هناك داعٍ أبداً لأن يورد هذا القسم من هذه الآية الذي هو ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَى…﴾. ثم إن إنكاره تعالى ذلك عليهم، نافياً اعتقادهم هذا، مستدلاً على جهلهم بكفرهم، وهو دعواهم ﴿فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.
فإذاً، إن ما أنكره تعالى من اعتقادهم هذا: أنهم حين يموتون لا تكون موتتهم الأولى، يتضمن أن هناك موتة ثانية على أقل تقدير، وإحياء وإماتة متكررين إلى قيام الساعة على أبعد تقدير.
ومن الآيات التي تحمل في إطلاقها وجهين، هذه الحقيقة، قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ (يس: 12).
فالوجه الأول هو المتعارف، أي الموتة الواحدة يحييهم بعدها الله سبحانه بعد أن يكون قد كتب ما قدَّموا وآثارهم وجعل كل ذلك في كتاب عام لكل فيه كتابه الخاص المفصل المحصية فيه حتى أنفاسه.
أما الوجه الثاني في الآية، وهو الذي ـ لولا العرف الطاغي ـ كان ينبغي أن يتبادر أولاً إلى الذهن، وفيه إشارة واضحة إلى الإحياء بعد الموت ثم الكتابة بعد الإحياء، كتابة ما يقدِّم الذين يحيون من جديد وآثارهم في حياتهم الثانية، أو في كل حياة يحييهم فيها الله سبحانه بعد كل موت، وفي الآية كذلك إشارة ظاهرة بديهية إلى التكليف في كل حياة من الحيوات، مقتضاه قبول توبة التائبين وطاعة الطائعين، ومن ثم تهوين الأمور عليهم ثم قبضهم إلى رحمته. أو العكس من ذلك، أن يختاروا الضلالة على الهدى، ويزدادوا عن الله وعن رحمته بعداً. وما أحسن قول ذلك العاقل الذي أورده الله سبحانه له، كذلك في سورة يس: ﴿وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ﴾ (يس: 22 ـ 23).
الموتة الأولى والأخيرة وبعدها الجنة
قول الله تبارك وتعالى: ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (الدخان: 56 ـ 57).
هذا فريق من الناس، لعلهم الصفوة المختارة، من الأتقياء والصالحين، والشهداء والصديقين، فلا النفخة في بوق يوم القيامة أو في الصور تميتهم. فهم المستثنون من الصعقة، أو من المستثنين، ذلك قول الله عزَّ وجل:
﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾. [ 68: الزمر ].
ولا هي كذلك تفزعهم، فهم المستثنون من فزع يومئذ الذي في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ﴾ (النمل: 87).
ولعلهم هم كذلك الذين لا يسمعون حسيس النار ولا يحزنهم الفزع الأكبر. قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ * لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (الأنبياء: 101 ـ 103).
بينما عامة الناس، غير المؤمنين الصالحين، ينالهم من أهوال الساعة، أي الفزع الأكبر، ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (الحجّ: 1 ـ 2).
ثم إن جماعة الموتة الأولى، أو جماعاتها، ليسوا معنيين بقول الله عزَّ وجل: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ…﴾ (غافر: 11).
ولا بقوله تعالى: ﴿…وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون: 100). كما سنراه مفصَّلاً إن شاء الله تعالى في ثنايا الكتاب.
ولا شهداؤهم جميعاً مقصودون بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿…وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ (محمد: 4 ـ 5).
فالشهداء، مصاديق هذه الآية، ليسوا من أصحاب الموتة الأولى التي في قوله تعالى: ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى…﴾.
وهذا الأمر كذلك سنوضحه بإذنه تعالى في فصول هذا الكتاب.
وحيث إن الآية الكريمة: ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى…﴾. واضحة معانيها كل الوضوح، فسنؤجل الآن البحث في بقية أبعادها إلى الفصول القادمة، إلاَّ كلمة ﴿فِيهَا﴾ الواردة في الآية، فينبغي أن ننوِّه بمعناها لأنها أبرز المفاتيح في أبعاد هذه الآية المميِّزة والمميَّزة .
فقوله تعالى: ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ…﴾ أي في الجنة أو الجنات، أو الفراديس.. على اختلاف تسميات جنات النعيم ودرجاتها. وحيث أن الموتة الأولى تحصل في الأرض الدنيا، فهذه دلالة على أن الأرض الدنيا التي نحن عليها، ستكون في عداد الكرات الأرضية التي تتشكل منها الجنات، طبعاً بعد إصلاح كريتنا هذه، وبعثها بعد موتها من جديد. كما أننا نجد ذلك جلياً واضحاً في قوله عزت عظمته: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (الزمر: 74). فكلمة الأرض هنا تعني جميع الأجرام التي مادتها الأرض، ولا سيما تلك المعدّة لاستقبال أهل رضى الله ورضوانه بعد القيامة، وفي جملتها هذه المباركة التي هي الأرض الدنيا. ولماذا هي مباركة؟ لقوله سبحانه: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا…﴾ (فصّلت: 10).
بين الخلق والجعل
الخلق في الأصل هو ابتداع الأشياء على غير نموذج سابق: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النحل: 3).
والجعل، هو تحويل أو إعمال أو فعل بعد الخلق في أشياء المخلوقات: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ…﴾ (الأنبياء: 33). ﴿…وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ…﴾ (الأنعام: 1). فخلق الشمس والقمر (أي الشموس والأقمار التي في الكون) هو خلق ابتدائي، هو ابتداع على غير نموذج أو محاكاة أو تقليد. وجعل الظلمات والنور، هو خزن هذه أو ذاك أو تركيبهما بعد خلقهما. كخزن الظلمات في البحار، والنور في الفوسفور أو بعض الحشرات التي تضيء في الليل.
ثم يتداخل الأمران: الخلق والجعل، في حاكميته سبحانه لحركة الكون بالحق والعدل والرحمة، فيخلق من المجعول، ويجعل من المخلوق: ﴿…وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ…﴾ (الأنبياء: 30). الماء هنا هو الماء الأصلي المطلق. أما قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء…﴾ (النور: 45). فقد نكّر فيه كلمة ماء، إشارة إلى تعدد أصناف الدواب، والعكس صحيح. والماء هنا والنطفة سواء. ويلقي الضوء على هذا المضمون قوله تبارك وتعالى: ﴿…وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى…﴾ (الحجّ: 5). وهو قول يُفهم مقيداً بقرائن السياق ـ كما ويؤخذ مطلقاً، لوجود الأرحام عند الناس وعند غير الناس مما خلق الله سبحانه أو مما جعل.
ودليل علة الخلق ثم الجعل ثم تداخلهما استطراداً، قوله تبارك وتعالى: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (الزمر: 6).
إلى هنا، أصبح ممكناً جلاء المقصد، وهو التفريق بين الخلق ابتداء، وبين الجعل، إذ من الجعل كعنوان عام، عناوين خاصة بالغة الأهمية، منها المسخ ومنها التقمص، وفيهما يتداخل الجعل ثم الخلق استطراداً.
وهنا نأخذ من سياق ثلاث آيات، مطلبنا، وهو إظهار ما يعنينا في بحثنا هذا، أي ما هو مخلوق أصلاً، لتمييزه فيما بعد عما هو مجعول بالمسخ أو بالتقمص، قوله تبارك وتعالى: ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ… وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا… وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ… وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 4 ـ 8).
ودليل على حالة من الجعل، قوله تبارك وتعالى: ﴿عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (الواقعة: 61).
فهذا جعل بعد الخلق وكذلك بعد الموت، وفي الآية هذه عشرات الإحتمالات عن التبديل والإنشاء المشار إليهما، سواء كان هذا التبديل وهذا الإنشاء بعد الموت في الحياة الدنيا بين مسخ وتقمص، مرة أو مرات، أو كان في الحياة الآخرة. على أن التبديل والإنشاء في الحياة الآخرة يقتصران على ظاهر الشخصية الإنسانية بين سلب أو إيجاب، وليس على أصل الخلقة التي فيها قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ…﴾ (الأنعام: 94). وقوله عزَّ وجل: ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ…﴾ (الكهف: 48).
موتة.. اثنتان.. ثلاث.. بالنصّ الحرفي
قول الله تبارك وتعالى: ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ (الأعراف: 101).
معنى الآية ظاهر، والظاهر عند الفقهاء بالإجماع حجة، ومخالفته تمحّلٌ ولفٌّ ودوران بدون طائل، وعناد لا يغير من الحق والحقيقة شيئاً. والمعنى:
﴿تِلْكَ الْقُرَى..﴾ أي أهل القرى بإجماع المفسرين. ﴿…نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا…﴾ خطاب لرسول الله محمّد(ص) بالضرورة ثم لكل قارىء للقرآن الكريم. أي نخبرك بأخبارها. ﴿…وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ…﴾ أن الله عزَّ وجل أرسل إليهم رسلاً قبلك يا محمّد ﴿…فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ…﴾ أي فَهُم لا يؤمنون بالذي أرسلناك به لأنه هو عينه كفروا به من قبل في الأحيان التي جاءتهم رسلهم به في جيلٍ ماضٍ أو أجيال ماضية، وهو دين التوحيد والاحتكام لرب العالمين والعمل بتعاليمه. وهل المقصود جميع أهل القرى وسحب الحكم عليهم باستحالة إيمانهم؟ طبعاً لا! فقوله تعالى: ﴿…نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا…﴾ إعلام بأن الحكم إنما يعني بعضها وليس جميعها، حيث أن ﴿مِنْ﴾ هنا للتبعيض وليست زائدة.
فهذا البعض، المحكوم بالتقمص، لضرورة حجية ظاهر الآية هو من حيث امتناعه عن الإيمان، مراراً وتكراراً، مصداقاً لقول الله عزت عظمته: ﴿وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ (يس: 10).
وما دام أمر هؤلاء من أهل القرى هو كذلك، أرسل إليهم سبحانه رسلاً قبل عصر محمّد(ص) فما آمنوا، ثم ارسل إليهم محمّداً(ص) فما آمنوا كذلك، وسيبقون كذلك ـ ربما يتكررون ـ وربما ـ إلى قيام الساعة. فبكم موتة وبكم حياة سيمرون؟ تلك الموتات والحيواة ألوان من عذاب الدنيا،، العذاب الأدنى ـ دون الآخرة.
ثم أنه على أدنى الافتراضات، لو أنهم كانوا قبل محمّد(ص) بجيل واحد ماتوا فيه، ثم أدركوا محمّداً(ص) في جيله، ثم ماتوا فيه، فهذه موتتان، ثم الموتة المجمع عليها لعامة الناس يوم النفخ في الصور، فهذه ثلاث موتات بالنص الحرفي، مفتحة فيه الأبواب، أي في النص، لمرات أكثر وأكثر كما نوّهنا آنفاً.
ثم يكفي لنفس هذا المبحث، ثلاث موتات بالنصّ الحرفي، حسماً. آية ثانية، لا تناقش من حيث صراحتها ووضوحها، قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: 243).
المعنى أن قوماً أو أقواماً خرجوا من ديارهم، أي منازلهم وموطنهم، وهم ألوف من الناس، خوفاً من مرض أو خطر داهم يتهدد ـ بزعمهم ـ حياتهم ووجودهم، فأماتهم الله عقوبة على عدم ثقتهم بربهم وحسن توكلهم عليه، ثم أحياهم.
ويبدو للمتأمل في النص، أن الحادثة هذه، وإن كانت خاصة إلاَّ أن الله سبحانه ساقها سوق المثل لجميع الأقوام الذين قد يبتلون بحالات مشابهة، ويؤكد ذلك قوله عزَّ وجل في آخر الآية ﴿…إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ﴾ والشكر اللازم هنا هو على الإحياء في الحياة الدنيا بعد الإماتة، لإعطاء فرصة للتوبة والإنابة وإبراء الذمة، وزحزحتهم ـ إن شكروا واستغفروا عن عذاب الآخرة.
وهذه كذلك، على افتراض الأقل، ثلاث موتات لكل واحد من هؤلاء الأقوام، الذين يُعَدون بالألوف: الموتة التي في الآية ثم الموتة المحتومة عند انقضاء الأجل، ثم الموتة التي من نفخة الصور والتي لا يُستثنى منها إلاَّ من يشاء الله رب العالمين.
المهم، أن في الآية كذلك، دلالة على التقمص، لأن الزعم بأنه سبحانه أحياهم فوراً بعد إماتتهم، أمر فيه تحكّم، وحيث أنه لا دليل في الآية على ذلك، وحيث أننا نعلم عن ﴿ثُمَّ﴾ في القرآن، في قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ أنها قد تتراخى لتصبح زمناً يطول أو يقصُر حسب مشيئة الله جلَّت عظمته. فسنعتبر أن إحياءهم كان لحياة ثانية، غير التي عاشوها في أوطانهم وديارهم عينها. وبهذه الفرصة للتوبة، أي الحياة الثانية على الأرض، يمتنُّ الله عليهم سبحانه، حيث قال: ﴿…إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ﴾.
كم حياة تريد.. لكي تؤمن؟
قال الله عزَّ وجل: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً﴾ (فاطر: 45).
في هذه الآية الكريمة إشارةٌ حتمية إلى التقمص. وجملة معانيها: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ…﴾ أنه سبحانه لو كان يحاسب الناس على ظلمهم وذنوبهم ومعاصيهم لما ترك على ظهرها منهم من يدبُّ على قدمين أو أكثر، يعني لما ترك منهم حياً على وجه الأرض.
وفي ذلك مسألتان: الأولى أن الكلام عن الناس، وفي ذلك حسب عموم القرآن فذلكة سيأتي ذكرها بعد قليل. والثانية أنه ما دام سبحانه يُهلك الفاسقين والظالمين، أي يخترمهم، وقد أخبر هو سبحانه عن ذلك في قوله:﴿…هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الأنعام: 47). ﴿…فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الأحقاف: 35). فلماذا إذن قال في هذه الآية التي نحن بصددها: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ…﴾ وهو في ظاهر القول، لا يترك منهم على ظهرها من دابة، بل يُهلك مَن يُهلك ويُميت مَن يُميت، وهكذا جيلاً بعد جيل؟!… فمن هم هؤلاء الذين أخبر سبحانه أنه يتركهم يدبُّون على ظهرها ويؤخرهم إلى أجل مسمى؟!… وما هو هذا الأجل، الذي اختلف فيه المفسرون، كما اختلفوا كذلك في جواز اخترام من لن يؤمن. رغم إخبار الله عن ذلك في الآيتين الآنفتين.
أما المسألة الأولى، وهي في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ…﴾ ففي القرآن الكريم بشكل عام فصل بين مضموني كلمتي الناس والمؤمنين. والمعلوم عند أهل الذكر، أنه في السور المكيّة بشكل عام، كان الخطاب للأقوام آنذاك، بلفظة ﴿النَّاسَ﴾، ثم في السور المدنية، كذلك بشكل عام، أصبح الخطاب، بلفظة ﴿الْمْؤمٍنينَ﴾ أو ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾. ونكتفي على ذلك بدليل واحد، لكي لا نبتعد كثيراً عن صلب الموضوع، قال تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (الحجّ: 1 ـ 2).
فمحال أن يكون المقصود في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ…﴾ كذلك عامة المؤمنين وأولياء الله الصالحين، ولو كانوا هم كذلك في الأصل من جملة الناس. إذ أنَّ الله عزَّ وجل قد فرّق بعد، بين من آمن وبين من كفر، فخاطب أنصاره بأسماء أبرزها ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وخاطب أعداءه بأسماء أعمها ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ…﴾. أما ما كان مشتركاً فهو قبل التفريق أو لحكمة تظهر فائدتها من القرائن .
ولأنه معلوم أن أنصار الله وأولياءه الصالحين ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (الأنبياء: 103)، فهم أي أنصار الله لا يشهدون أهوال يوم القيامة، المنصوص عليها في قوله عز شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ… يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ أي أن هذه الأهوال من يوم القيامة هي عذاب شديد لمن يراها من الناس، أي لعامة الناس، غير أنصار الله.
ورجوعاً إلى المسألة الأولى التي في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ..﴾ ينسحب على لفظة ﴿النَّاسَ﴾ نفس التعليل وفيها نفس الفذلكة.
أما المسألة الثانية، بعد ما بيّناه حولها، بإذنه تعالى، فيقيناً، أن المقصود بها، أنه سبحانه يميتهم ثم يحييهم على ظهر هذه الأرض، وتلك هي قضية التقمص. أي يحي الناس، عامة الناس ويميتهم، ربما أجيالاً وأطواراً، بين إعطاء فرص لكفار قد يؤمنون ولمشركين قد يوحدون، ولمعاندين قد يتوبون، ثم لمن يعلم أنهم لن يؤمنوا إطلاقاً، فيلقي الحجة عليهم كما على الجميع، ويذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر عدلاً واستحقاقاً.
وهنا يتضح سبب الخلاف عند المفسرين في قوله تعالى: ﴿…وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى…﴾ فمنهم من قال أن الأجل هو يوم القيامة، وهذا مردود طبعاً بما بيّناه بدواً في كلامنا عن المسألة الثانية، ومنهم من قال: «إلى وقت يعلمه الله تعالى أنه لا يكون في بقائهم فيه مصلحة لأَنهم لا يؤمنون، ولا يخرج من نسلهم مؤمن وإنما يؤخرهم تفضلاً منه سبحانه ليراجعوا التوبة، أو لما في ذلك من المصلحة». وفي هذا القول في الحقيقة، إشارات إلى حقيقة التقمص، ولكن أصحابه أبهموها عمداً، ربما، للأسباب التي ذكرناها في المقدمة، فراجع..
ودليل آخر، يقوي ما أصبح محسوماً، نصاً وعقلاً ونقلاً، قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ﴾ (هود: 109).
الخطاب هنا لرسول الله محمّد(ص)، ومن ثم لكل قارىء للقرآن إلى قيام الساعة، فعلى اعتبار الخطاب لمحمّد(ص) يعني لا تكن في شك من أنَّ عبادة هؤلاء هي على سبيل الشرك الذي لا يُغتفر، سواء كانوا يعبدون أصناماً أو أنصاباً أو أشخاصاً يدّعون لهم الألوهة أو بعضاً من الألوهة، وهم ما يعبدون إلاَّ كما كان يعبد آباؤهم وما زالوا يعبدون. أي ما زال آباؤهم السابقون لعهد محمّد(ص) يعبدون في عهد محمّد(ص) بشراً او حجراً. ومن أين هذا الكلام؟ هو قطعاً من لغة القرآن العربية. من عبارة ﴿…إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم…﴾ المعينة للحال والاستقبال. وكيف ذلك؟ ذلك أن الآباء، ارتكازاً على حقيقة التقمص، قد يكونوا قد أصبحوا في أعمار المعاصرين، أو أصغر من أبنائهم أعماراً. وإلاَّ، لماذا أدرج سبحانه هذه العبارة بهذه الصيغة إذا لم تكن فيها هذه الإشارة البالغة الأهمية، إذ بدون هذه الإشارة، كان من الطبيعي جداً أن يُعبِّر عن عمل ماضٍ بصيغة فعل ماضٍ، كما هو سبحانه علَّم العرب أن يقولوا وأن يكتبوا وأن يعبّروا.
ودليل أخير وليس آخراً نختم به هذا الفصل بعون الله تعالى له الحمد وله الشكر، هو قوله سبحانه: ﴿تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل: 63 ـ 64).
قبل أن نُبيِّن المعنى الحقيقي للاية هذه، ولا قوة إلاَّ بالله، نشير إلى أن بعض أجلاَّء المفسرين، يتوصلون إلى الحقيقة، ويذكرونها، صراحة، ولكن دون أن يتعرضوا للعنوان الذي هو التقمص، فيمر القارىء عليها، أحياناً ماطاً شفتيه، وأحياناً مروراً غير مسؤول، وقليلون جداً، هم الذين يتعبدون لله سبحانه بالتدقيق والمحاسبة استجلاءً للحقائق وسبراً لأغوارها. وهذا نموذج من تفسير هذه الآية الكريمة، من كتاب كثيراً ما نجلّه ونوقر صاحبه. قال رضوان الله عليه في تفسير الآية، حرفياً:
﴿تَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ…﴾ يا محمّد ﴿…فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ…﴾ أي كفرهم وضلالهم وتكذيبهم الرسل ﴿…فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ…﴾ معناه أن الشيطان وليهم اليوم في الدنيا يتولونه ويتبعون إغواءه فأما يوم القيامة فيتبرأ بعضهم من بعض.. عن أبي مسلم. وقيل معناه فهو وليهم يوم القيامة أي يكلهم الله تعالى إلى الشيطان إياساً لهم من رحمته.
وفي هذا التفسير للآية الكريمة أحد أمرين: أولهما هو ما احتملناه أن المفسر الجليل، الناقل عن أبي مسلم، قد اعترف بحقيقة التقمص دون أن يصرح بعنوانها. وذلك في صريح قوله: «معناه أن الشيطان وليهم اليوم في الدنيا»، فكيف يكون وليهم اليوم في الدنيا في حياة محمّد(ص) وهم أمم كانت قبل محمّد(ص)، كما هو صريح الآية.
والأمر الثاني، هو أن يكون كلام المفسر مناقضاً لظهور النص لعجزه عن إدراك الحقيقة التي فيه، وتلك هي الطامّة.
أما الاحتمال الآخر في تفسير الآية، ابتداء من قوله: «وقيل معناه فهو وليهم يوم القيامة…” فواضح كذلك، أولاً الوهن في الانتقال إلى الاحتمال مع قوة ظهور النص، وكذلك الوهن في الخلاف.. وثانياً شدة التناقض بين التفسير في قوله: «يوم القيامة» وقول الله تعالى في الآية ﴿…فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ…﴾ أي عهد محمّد(ص)، حيث كان الخطاب لمحمّد(ص)، ثم عهد كل قارىء للقرآن، ما دام الخطاب جائزاً في هذه الآية ومثيلاتها أن يكون لكل قارىء للقرآن الكريم إلى قيام الساعة.
فيا أيها الإنسان، كم حياة تريد بعد الذي بيّنّاه من خلال الآيات الكريمات، لكي تؤمن؟… على أن الحياة الدنيا، أو الحيوات الدنيا كما ترى.. ليست هي الجنة.. وليست هي النعيم المقيم الذي أخبر ويخبر عنه ربنا الكريم، وإنما هي قيد النفس وقيد البدن، وحبس في الجاذبية والضغط الجوي، هذا في أحسن حالاتها.. أما المصائب وأما الابتلاءات والنكبات، وظلم الظالمين، وكدح الكادحين، والصراع، والجهاد الفريضة.. حتى الانعتاق.. والهجرة منتصراً بالله، إلى الله رب العالمين.. فحديث طويل وجليل. وغير ذلك السقوط عن خط الوسط، تسافلاً في الدرجات.. إلى الهاوية. قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون﴾ (الأحقاف: 26).
والآن إلى صلب الموضوع وخِضَمِّه، بإذن الله ربي العظيم وبعونه، تبارك وتعالى عما يصفون وعما يشركون، عليه توكلت وإليه أنبت وإليه المصير.
بين المثقفين والثقافة المنفلتة… والقرآن
خطر لي أن يكون البديل عن هذا العنوان: بين رب العالمين والمثقفين… إلاَّ أني عدلت عن ذلك، وأثبت العنوان الذي يوجب ربط الثقافة بالقرآن الكريم لتكون مقبولة ومعقولة. والسبب في ذلك أن معظم المثقفين مؤمنون بالله العظيم، حريصون على هذا الإيمان فخورون بذلك، يغضبون شديداً إذا اتهموا في إيمانهم أو بنقص أو خلل فيه. ونعم الحرص ونعم الفخر، إلاَّ أن الحكم يتراخى ويتردد قبل القول: ونعم الغضب. لأن الحقيقة بخصوص الإيمان بالله، أنه يتسع ويضيق ويعمق ويطفو، وقد يبلغ درجة اليقين، واليقين درجات. وقد يشوبه الشك والتردّد حتى ليقع في حالة النفاق التي تصنف صاحبها مع الكافرين بل وفي الدرك الأسفل من النار.
وما المقياس في ذلك وما المعيار؟
مجرد الإيمان بالله، إيماناً منقطعاً عن تعاليمه، هو عند الله مردود وبمقتضى تعاليمه. فالإيمان به المقبول عنده سبحانه إنما هو الإيمان المرتكز على ثلاث خلاصات، أو اركان: أولها الإيمان به، وثانيها الإيمان باليوم الآخر وما يتضمن من وعده ووعيده، وثالثها عمل الصالحات. وهنا عند عمل الصالحات، يجد الإنسان العاقل، أو المؤمن، نفسه في مواجهة مع ثقافته، أو مع تثقيف نفسه، إما تثقيفاً إيجابياً منضبطاً بارتباطه بتعاليم الله، أو تثقيفاً منفلشاً منفلتاً، همه أن يجمع من كل نهر بدلو أو حقل بحفنة أو مادة بقبضة أو جهة بنظر. ويزيد الكبر والغرور ـ إذا لم يربط بتعاليم الله ـ كلما زاد الجمع وتعددت ألوان الثقافة وأنواعها، وكلما ازداد الشركاء في المفهوم الثقافي العلماني، مما قد يؤدي، وغالباً ما يكون، إلى العداء للدين، المظنون، جهلاً، ضيقه أو تحجره، من قبل الذين تحولوا عن أرض الدين (المتفرقة كراتها في الكون أعاليه وأسافله ودوائره)،
وعن سماواته، تحولوا عن رحابة واتساع دين الله، ليظلوا قابعين في نسيج العنكبوت الذي هو الثقافة العلمانية، أو الثقافة من غير دين رب العالمين. وهذه، بشأن هؤلاء وأمثالهم ضابطة من تعاليم الله، ضابطة قرآنية، قول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ (الروم: 13 ـ 14).
وما أجمل وأكمل الثقافة المرتبطة بضوابط المسارات والحضارات يعني بتعاليم رب العالمين. وما أنبل وأقوم حينئذ المثقف الذي ما إن يستعرض ثم يعرض ثقافته في ضوء تعاليم الله ملقياً منها الباطل، مثبتاً منها الحق، ثابتاً معه، حتى يصبح من الذين يعملون الصالحات، ويصبح اسمه عالماً، إذ تلك هي صفات العالم ـ والعلماء درجات ـ ثقافة على إيمان وعمل، كلما اتسعت الثقافة وعمق الإيمان وحسن العمل كلما ارتفعت درجة العالم وقد أنزل الله تعالى لذلك مقاييس وموازين، قلما تفوت الخلق، ولئن فاتت الخلق لا تفوت الخالق فهو سبحانه بكل شيء محيط: قوله تعالى: ﴿…إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء…﴾ (فاطر: 28)، وقوله سبحانه: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ..﴾ (الزمر: 9). ويعمّ هؤلاء وعده سبحانه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ (الروم: 15).
وما السبيل لنيل ثقافة واسعة وإيمان عميق وعمل صالح، ليصح أن يعدّ المثقف من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾ (الروم: 22).
هذه الآية الكريمة مدعاة ودعوة للثقافة، لثقافة حقيقية واسعة وإيجابية. وفيها تحدّ للمثقفين، إذا عقلوا، وعدلوا، فسوف يعلمون كم هو الإنسان المثقف محدود وضعيف في مواجهة عناصر الآية الكريمة هذه ومدلولاتها.
ففي القسم الأول من الآية قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ…﴾ إشارة إلى أن ما يعرفه أو يلم به المثقفون عن السماء هو ما تحت السماء الدنيا إضافة إلى مادة تركيب السماء. حتى أهل الاختصاص على تميزهم الكبير عن المثقفين العاديين من حيث سعة الاطّلاع وعمقه، يظلون محدودي المعرفة بالنسبة لما فوق السماء الدنيا، هذا إذا استطاعوا يوماً أن يدركوا أبعاد أو آفاق هذه السماء الدنيا وحدها. وما يقال عن ما بعد السماوات، يقال عما بعد هذه الأرض، من أجرام أرضية، ليس تحت سمائنا الدنيا هذه، وإنما فوقها، أي عبر سبع سماوات يدّعيها صادقاً الدين الحنيف. ويدعو الناس للتفكر فيها وقد كشفها القرآن المجيد، ويعتبر هؤلاء المفكرين المكتشفين أو العاملين في مجال الكشف، إذا كانوا مؤمنين، يعتبرهم ويسميهم أولي الألباب، أي أصحاب العقول الكبيرة السديدة. قوله تبارك وتعالى، في خمس آيات تجتمع فيها أبرز صفات المثقفين الذين يزكيهم الله سبحانه ويبارك في ثقافاتهم وعلومهم ويزيدهم من فضله، ولا سيما منهم الشاكرين: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأِّوْلِي الألْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران: 190 ـ 194).
وحصيلة الأمر بعد هذا المخزون الثقافي الذي لا بد أن يتفاوت بين عالم وعالم وعامل وعامل، هي في الآية السادسة في سياق هذه الآيات، قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ…﴾ (آل عمران: 195).
يبقى التحدي الآخر، في الآية الكريمة التي قلنا أنها دعوة و تحدّ للمثقفين، قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾.
فاختلاف الألسن هو اختلاف لغات البشر، واختلاف لغات البشر، وتعددها مع تعدد الأجناس، والألوان، والتواريخ والقارات والتضاريس والمناخات وغير ذلك، يعني تعدد الحضارات، والأمم، والشعوب، وهات دلوك وخض خوض السابح الماهر، واملأه وخزّن من الثقافات والألسن في ملايين مواضيعها وتفريعاتها، ما يسعه عمرك، وإلى كم سيتسع فهوناً هوناً في نظرك إلى ثقافتك، وكذلك إلى ثقافة غيرك، إلاَّ إذا كانت بتسديد من الله وتأييد من الله، وتوفيق من الله، ونفع لك فيها ولعباد الله، فاشكرنّ الله عليها وحده لا شريك له، وتجنب الشركاء في العلمنة ورفض الحق واتباع الباطل، وتفكر في خلق السماوات والأرض… واذكر الله قياماً وقعوداً… تكن من أولي الألباب، أي مثقفاً أصيلاً أو أصلياً.
ونحن مع المثقفين
كثرة من مثقفي العصر، وعبر اطلاعاتهم الواسعة، ألمّوا بشيء من اعتقادات القائلين وبحماس شديد، بالتقمص. وكان لا مانع عندهم من تصديقهم، لا سيما مع تقديم البينات، بين كتاب مقروء وشريط مسموع ومشاهد. مما أدى ويؤدي بأصحاب هذا الاعتقاد وبمصدقيهم، إلى أن ينكروا خلاف التقمص، أي الموتة الواحدة، وبعدها البعث والنشور، والثواب و العقاب، والجنة والنار.
كما أن أهل الاعتقاد بالموتة الواحدة ـ عرفاً ـ ينكرون بشدة دعوى التقمص، وربما تهكموا على القائلين بها. مما أدى ويؤدي بهذه الطبقة من المثقفين ـ وفيهم فلاسفة كبار ـ إلى الحيرة العامة، ولا سيما الحيرة الفلسفية. كما ظهرت بالنتيجة الفلسفة المادية التي طبعت القرن العشرين عميقاً بطابعها الحجري. وطبعاً، إننا لا نعتبر هذا الأمر هو سبب الفلسفة المادية أو الدافع إلى الإلحاد، فإن لذلك اسباب وأسباب، وإنما منها ـ كما ذكر ـ هذه الشبهات التي غلفت الحقائق. إلاَّ أن القرآن المجيد، الذي أنزله الله على رسوله محمّد(ص) وبعثه به للناس كافة، كشف الحجب عن هذه الحقائق التي يعاينها الناس كل فريق من جانب. فكان حريَّاً بنا ـ كما كان حريَّاً بغيرنا ممن ألفت أو نبّه أو صرح بذلك ـ أن نكتب في هذا القضاء الإلهي، داعين إلى الله سبحانه، بالأدلة التي هو تعالى أثبتها في أصدق وأسلم كتاب يحمله اليوم كوكبنا هذا السيار، عنيت القرآن العظيم، نادباً أو موجباً على العلماء أن يظهروا للناس ما بيّنه سبحانه لهم في الكتاب ـ كما أسلفنا عن مضمون الآية ذات العلاقة. فتنفتح العين الثانية لمن كان ينظر في كتاب الكون والتجربة والمعاناة، ويعتقد فقط بالتقمص، كما تفتح لفلاسفة المادة جميع أعينهم، بعد إغلاقها عن حقيقة هيمنة الله عزَّ وجل، وحقائق الإحياء والإماتة، مرة واحدة أو مرات متعددة، وكذلك قيام الساعة والحساب، والثواب والعقاب، والتخليد إما في نعيم أبدي وإما في جحيم سرمدي.
ونحن مع المثقفين في لزوم انتصافهم من هذا التناقض المطروحة أضداده في سوح الفكر العالمي.
ولكن من المنصف؟ والموضوع كما لاحظنا، واسع ومتشعب، وذو أبعاد وأعماق، وأسرار وغيوب؟ يقيناً، يستحيل على الناس كل الناس، وعلى الخلق جميع الخلق، أن يلمّوا أو يحيطوا بكل هذه القضايا، قضايا الموتة الواحدة، لصنف من الناس عبر أجيال البشرية، أو التقمص مرة أو اثنين أو … أو.. أو إلى قيام الساعة وكذلك المسخ وأسبابه، وبدايته وغايته، إلى آخر ما هنالك من البرزخ وحقيقته، وأمكنته وأزمنته، والشهادة وأنواعها ودرجاتها ودرجات أصحابها.. إلى أسئلة كثيرة، لولا القرآن الكريم. كتاب الله الذي ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ…﴾ (فصّلت: 42) والذي أنزله سبحانه: ﴿…تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ…﴾ لبقيت هذه التساؤلات موضوع حيرة وانسدادات أمام العقل تتراوح آثارها بين الضياع والضلال وبين انفجارات الأدمغة، إما يأساً، وإما انسداداً أمام الفكر والبصر والبصيرة. بسبب الكفر، وبسبب العناد والكبر والإعتماد على غير الله وعلى غير كتاب الله.
المسخ وأسبابه، وهل توقَّف عند القردة والخنازير؟
لقد تأكدت يقيناً، حقيقة المسخ بشهادة القرآن الكريم، وكذلك بشهادات من الطبيعة والآثار وتاريخ الحياة على كوكبنا هذا الأرضي، ويكفي للتثبت من ذلك أن نقرأ تاريخ «النشوء والتطور» عند «داروين([2])” ثم نعكس النظرية التي بنى عليها هذا التاريخ، فنبدّل العنوان العام لأبحاثه بأحد هذه العناوين: «تاريخ التسافل البشري» أو «تاريخ المسخ على الأرض» أو «الحيواة البرزخية» أو أي عنوان آخر يكون مدخلاً لهذه الحقيقة.
والحق يقال، أننا استفدنا من عكس داروين للحقيقة، حيث أننا نعتبرها بعد عرضها على القرآن، من عطاءات الله لنا على يد داروين، وإنما بعد قلبها رأساً على عقب، بتوفيق منه سبحانه وهداية، وبتأكيد وتسديد من كتابه المجيد، ولا سيما بالبراهين الدامغة التي في آيات المسخ، أي جعل بعض الناس قردة، وبعضهم خنازير، ثم الإشارات إلى مسخ بعض أنواع الكافرين وجعلهم صماً بكماً عمياً، وجعل آخرين بصفة واحدة أو بصفتين من هذه الثلاث.
فحيث أن القرآن المجيد، أكد حقيقة المسخ قردة لأصحاب السبت من اليهود. ثم أكد حقيقة المسخ لآخرين من اليهود كذلك قردة وخنازير، فإنه أكد كذلك أن المسخ حقيقة عامة يجريها في خلقه ـ في باب العقوبة والعذاب في الحياة الدنيا، هذا فضلاً عن جعل القردة والخنازير فقط من اليهود تمسكاً بالنصوص. أما عن المسخ الخاص الجاري في اليهود، فقد ذكرنا في هذا المدخل ما يؤكد ذلك، كما سنلحق هذه التأكيدات بأخرى أوضح منها وأدق في سياق الفصول التالية إن شاء العليّ القدير.
وبقي أن نذكر، بعض الشواهد القرآنية على حقيقة المسخ العام، من ذلك، قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ﴾ (البقرة: 6 ـ 7).
هذا فريق من الخلق، محسوم كفرهم، وقد تكرر في القرآن عنهم كلام يقطع بأنهم لن يهتدوا أبداً. وحيث أن الله سبحانه قضى بدرجات من العقوبات وكذلك العذاب في الحياة الدنيا، وفي آيات كثيرة، فحتماً ستكون درجات العذاب لهذا الفريق، فريق الكفر المحسوم أمره، أكبر من أن تكون عقوبات أو أنواعاً من القصاص يراد منها الردع أو التربية أو التأديب أو رفع الدرجات.
ولم لا يجعل هؤلاء مسوخاً، مما يرى في البر والبحر وأجواء السماء. وكم من هذه المخلوقات حرّم الله لحمه، كما حرّم القردة والخنازير عند خاتم النبيين(ص) وخاتم الكتب المنزلة، وخاتم الأديان. عنيت محمّداً(ص) والقرآن العظيم والإسلام الحنيف.
ثم ما معنى قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ…﴾ ولماذا الإصرار في التفسير على أن المعاني في مثل هذه الآية مجازية، ولماذا يقدم المجاز على الحقيقة، ما دامت القرائن موجودة تفيد الحقيقة قبل المجاز، لا سيما وأن الأصل هو الحقيقة وليس المجاز، هذا أولاً، وثانياً لماذا التفرد بالمجاز ما دام الأمر قرآنياً، يعني أنه يتسع لجميع الاعتبارات الحقيقية والمجازية ولا سيما مع الآيات المطلقة التي لا يحدها الخاص ولا المعيّن ولا أية قرينة أو مانع من موانع الأصول، هذا إذا كان علم الأصول علما منزلاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما هو كلام الله عزَّ وجل، وهيهات هيهات أن يقاس ولو بعض قياس، بكلام الله عزَّت عظمته.
ونفس هذا الكلام يقال عن مثل قوله عزَّ وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ * صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ﴾ (البقرة: 8 ـ 18).
في هذه الآيات، أنماط من الناس، بين أهل كفر وشرك ونفاق وكذب وإلحاد، وفساد وإفساد، إذا اطلع عليها الإنسان العاقل السويّ، يتأزم ويشتاط منهم غضباً لله، ويتعجب من مجرد وجودهم، بين العقلاء والأسوياء، يغضب ويتعجب الإنسان السويّ، وهم لا يعصونه هو، ولا يكذبونه هو، ولا ينكرون وجوده أو حقه، أو عدالته ورحمته، أو عذابه ونقمته هو، وإنما هم يعصون الله، ويكذبون بآياته، وقد ينكرون وجوده، وفي جميع الحالات ينكرون كل ما يرضيه، ويفعلون كل ما يغضبه، فكيف تكون نقمته، وكيف يكون عذابه، ومن قال أن العقوبات وأنواع العذاب، مؤجلة إلى قيام الساعة؟ ومن يقول بذلك فإنه لم يقرأ القرآن، أو كأنه لم يقرأ القرآن، هذا الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل. يعصون الله ويحادون الله ويكفرون بالله، ويمكرون ويضحكون ويستهزئون وبمن وبماذا. ﴿فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الصافّات: 87) والعزة له جميعاً، والقوة له جميعاً، وله الكبرياء وحده في السماوات والأرض، وهو المنتقم الجبار، قاصم الجبارين، ومذل المتكبرين، ومدرك الهاربين، ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الحشر: 24).
ولماذا لا يمسخهم وحوشاً وحشرات وما بين ذلك. على درجات كفرهم وظلمهم وعتوهم، وهزء المستهزئين ونفاق المنافقين. أوليس هو سبحانه: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (البروج: 15 ـ 16). ثم يوم تقوم الساعة يحشرهم إليه جميعاً كذلك في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، كل موقف فيه الف سنة مما تعدون.
ونحن، بهذا، لا نقول ما يجب على الله سبحانه فعله، معاذ الله، ومن نحن وما نحن بجانب ألهانية الله الذي لا إله إلاَّ هو، أو بجانب كبريائه وعزته: «ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ» فهو سبحانه الملك الحق المبين، وإنما نحن نتحدث عن قضائه في خلقه، عن بعض من قضائه وبعض من جزائه: ثوابه وعقابه. بإذن منه تبارك وتعالى وهداية ورعاية وتسديد خائفين خاشعين أمام وعيده في قوله جلَّت كبرياؤه: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (الحاقّة: 44 ـ 47).
﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ﴾ (البقرة: 18). هذه آخر آية في العشر آيات التي ذكرنا. فهل المعنى مجازي أم حقيقي.
ما دام المسخ حقيقة لا لبس فيها، فإن الدعوى قائمة لذلك مع البينة أن معنى الآية حقيقي أصلاً، إلى إمكان أن يكون مجازياً في بعض الدرجات، يعني هو حقيقي ومجازي، ولكن الحقيقة هي التي تغلب فيه.
يقول علم الحيوان أن الخلد أعمى، يحصل على رزقه كدّاً ونكداً حافراً طريقه في باطن الأرض، طبعاً في ظلام دامس، وهو لا يميز بين النور والظلمة. ويقول علم الحيوان أن الخفافيش كذلك عمي، وهي تطير وتحلق في الأجواء وبين المساكن المتقاربة والأشجار، ولا تصطدم بشيء، إذ تهتدي إلى طرقها لا بالأبصار ولكن بواسطة الرادار، الذي جهزها الله به سبحانه. وفي أعراف الناس إذا أرادوا أن يصفوا إنساناً بالإفساد والحقارة ينعتونه بأنه كالخلد، وإن أرادوا أن يتهموا أناساً بالجهل والعمى والتسكع والهوان يقولون كالخفافيش، ويقول علم الحيوان ويقول… ويتحدث عن عجائب خلق الله وآياته في خلقه، ولكن العلم قليلاً ما يقول بل ونادراً ما يقول أن هذه مسوخاً كانت هذه صفاتها عندما كانوا بشراً أسوياء: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ * صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ﴾ (البقرة: 16 ـ 18).
وحيث إن الكفر درجات، والشرك والنفاق كذلك درجات، فهل يمسخ جميع هؤلاء وعلى درجاتهم؟
مضامين الآيات وفي نفس السياق في سورة البقرة، تقول لا. فإن من الناس من هم أقل كفراً ونفاقاً، يبقى لهم سمعهم وأبصارهم، وإنما مهددين بإذهابهما تبعاً لسلوكهم وتبعاً لمشيئة الله فيهم. وهذا الفريق من الناس هذا مثله: قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: 19 ـ 20).
وبعد هذه التفاصيل والأمثلة، عن هذه النماذج، ينتقل سياق الآيات الكريمة نُقْلةً بكلام عن مصير المؤمنين سريعة، يشعر معها المتأمل الرشيد أن الحقائق ممثلة كما في الوقائع كذلك في العبارات… فهي توحي أن لا فواصل ولا عقبات بعد موت المؤمنين، فهي تبشرهم أنهم من الموت… إلى الجنة. فلا برزخ ولا حيوات ولا مسخ والعياذ بالله: قوله تعالى، مذكرين أنه في نفس سياق الآيات التي رأينا في سورة البقرة:
﴿وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة: 25).
أسباب المسخ الجاري في بني إسرائيل
بعد أن ذكرنا أسباب المسخ عامة في فرقاء من الناس، بقي علينا أن نذكر وباختصار، أسباب المسخ الخاص، أي المسخ الجاري في بني إسرائيل.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾ (البقرة: 61).
وعلى ذلك، فإن حكاية الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة خاسئين، لم يكن مسخهم لأنهم فقط اعتدوا في السبت. فاعتداؤهم في السبت كان السبب المباشر للمسخ. أما الأسباب غير المباشرة، فهي في الآية الآنفة التي فيها: ﴿…ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ…﴾ و﴿…بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ﴾.
والأسباب غير المباشرة، هذه التي تلخصها الآية الكريمة، هي التي من جرائها أصلاً، جعل منهم القردة والخنازير. وليس فقط القردة. فمسخ الذين اعتدوا في السبت قردة خاسئين، كان بعد مسخ فرقاء من بني إسرائيل وجعلهم ابتداءً: القردة والخنازير.
والأهم في هذا الأمر، أن الأسباب غير المباشرة هذه، التي توجزها الآية الكريمة، هي باقية فيهم. وما دامت كذلك، فهم معرضون دائماً وأبداً للمسخ قردة وخنازير، اي أن المسخ أمر جارٍ فيهم، ما داموا يعتدون في السبت أو في غير السبت، كما اعتدوا في ذلك السبت التاريخي الذي جعله الله سبحانه لهم تذكاراً وعبرة، كما جعله تذكاراً وعبرة للعالمين، يخوفهم به من جهة، وهو محل خوف مرعب، ويحذرهم من جهة ثانية من الخصوصية التي انطبع عليها بنو إسرائيل، وأسباب مسخهم غير المباشرة، الكامنة فيهم، المسلطة عليهم إلى يوم يبعثون.
فكلما اعتدى منهم أفرادٌ أو اعتدت جماعات، مفسدين في الأرض عاصين الله تعالى، مغرقين في العدوان، عن تصور وتصميم، كلما مسخ الله أولئك الأفراد أو تلك الجماعات، قردة خاسئين، أو قردة وخنازير.
وغنيٌّ عن القول، ونحن في بدايات القرن الواحد والعشرين الميلادي والقرن الخامس عشر الهجري، أن بني إسرائيل في دولتهم المحتلة لأرض فلسطين وقطاعات من أرض الدول العربية الإسلامية المجاورة، وبالأسلوب الإرهابي الذي يحملونه أحقادهم التاريخية ويطبعونه بأسباب مسخهم الكامنة فيهم، والذي يتمثل بأشد ألوان العدوان لؤماً وغطرسة وتجبراً، بالقوة العرضية التي ابتلاهم الله سبحانه بها، غني عن القول أن كل ذلك سيعود عليهم بالويل والدمار والهزيمة الموعودة المنكرة، فضلاً عن مسخهم قردة وخنازير، بعد استحقاق الأسباب القائمة الدائمة فيهم، مسخاً بوجهيه الحقيقي والمجازي، وهذا تطبيع لهم من الله سبحانه في مقابل محاولاتهم تطبيع المسلمين الموحدين الأبرياء والنصارى أصدقاءهم ـ الألدّاء ـ لتبقى على جباههم مدى الدهر، آثار الآية الكريمة، قول الله عزَّ وعلا، وتبارك وتعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُون﴾.
هذا فصلٌ من كتاب «القيامة حقيقة و التقمص حقيقة ثانية»، للعلاّمة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين رضوان الله تعالى عليه.
طبعاً هذه العجالة لا تفي الكتاب حقَّه، إنما أوردناها لإعطاء فكرة عامة حول موضوع الكتاب، فمن أراد التوسع ندعوه للتواصل مع جمعية «سماحة العلاّمة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين الخيرية الثقافية»، تلفون: 70/909050 ـ 70/646164.
([1]) عالم متبحر، وأديب شاعر، له آراء عقائدية وفقهية عديدة مخالفة لمشهور العلماء. من لبنان.
([2]) داروين (Darwin) (1809 ـ 1882): عالمٌ طبيعي إنجليزيّ. أسَّس نظرية التطور للعالم العضوي. له كتاب «أصل الأنواع..» فصَّل فيه القضايا الأساسية لنظرية التطور. له كتاب «سلالة الإنسان والانتخاب بالنسبة للجنس» (1871) عرض فيه انحدار الإنسان من الأسلاف الحيوانية (الموسوعة الفلسفية: 175).