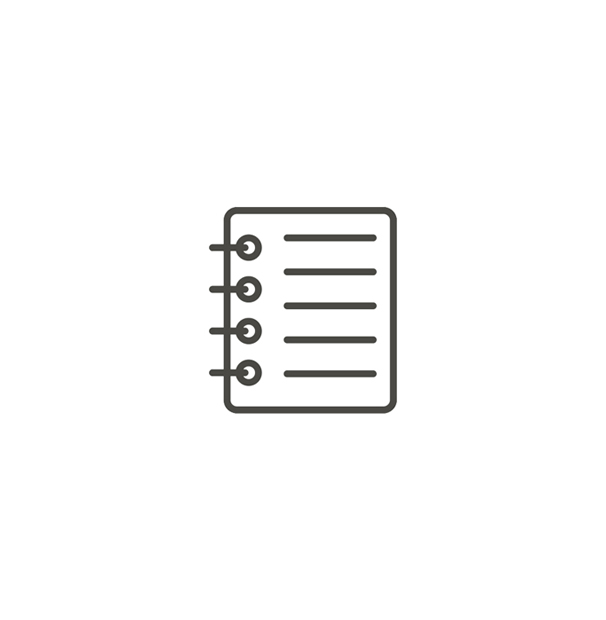د. إيمان شمس الدين
عندما نتحدث عن فعل (عمل) فنحن نتحدث بالمضمون عن وجود أفراد ومجتمع وتفاعل وانفعال، أي إن ما نطلق عليه مصطلح أمة أو شعب أو مجتمع، فإن ذلك يعني المعادلة التالية:
الإنسان + هدف + تخطيط + منهج + أدوات + فعل + فاعلية (تطبيق) = نتيجة وثمرة وتغيير
وهناك نوعان من الأفعال أو الأعمال:
الأول: عمل مأجور، أي عمل في قبال أجر.
الثاني: عمل تطوعي هادف بدون مقابل ويطلق عليه أيضا عمل رسالي.
«العمل الرسالي هو العمل الذي يقوم به الإنسان لأجل هدف، ولأجل تحقيق هدف. بطبيعة الحال، العمل هذا يعتبر خطوة في سبيل كمال الإنسان، أو بالتعبير الإسلامي يعتبر عبادة، والحديث الشريف يقول: العبادة سبعون جزءاً، أفضلها العمل. والعمل الرسالي هذا، لا يرتبط بكمية الأجر سواء كان الأجر قليلاً أو كثيراً. فالعمل متقن، يعني من مميزاته، عدم البخس في العمل والاتقان. فالحديث الشريف يقول: الذي يبخس في عمله، يخون هذه الأمة، والحديث الشريف يقول: رحم الله من عمل عملاً، فأتقنه»([1]). فالعمل الرسالي هو عمل هادف بخطة لها وسيلة وآليات تطبيقية، لتحقيق حركة وعي رسالي ينهض بحاضر الأمة ومستقبلها.
الفرق بين العمل الرسالي والعمل المأجور
ويختلف العمل الرسالي عن العمل المأجور بالأمور التالية:
1ـ العمل الرسالي قائم على التطوع، أو حتى قد يكون مقابل أجر، ولكن أجر رمزي لأنه ليس وظيفة يستأكل منها صاحبها، ويسعى في عمله لأجل تحقيق أهداف قيمية إنسانية، بالتالي هو يصنع مجتمع حركي فاعل متكافل حيوي، قائم على التنافس والتعاضد، والتنافس نتاج طبيعي للاختلاف في الكفاءات والقدرات والقابليات، فيكون فيه التنافس على أساس التكامل والتعاضد، لا على أساس الصراع والخلاف. بالتالي تكون نتاجات العمل الرسالي مجتمع حي حركي متكافل، تحكمه منظومة قيم إيجابية، وضمير أخلاقي حي. وهناك فرق بيت التمايز والتميز، فالتمايز له محمول سلبي في دلالاته، قد تكون سلبياته على مستوى الفرد والمجتمع صراعات، يندفع صاحبها من منطلق الأنا والفردانية لتحقيق مصالحه الشخصانية، فيمارس كل أنواع التشهير والإسقاط بحق المنافسين الآخرين والإلغاء والإقصاء للآراء الأخرى بل حتى حرف الأفكار عن دلالاتها ومراداتها، لإسقاطها كمشروع نهضوي كليا. بينما التميز تنافسي يفتح ساحات الفعل الاجتماعي لكل الطاقات، ويستخرج كل إبداعات الفرد لهدف تطوير المحيط، وهنا الدافع ليس الأنا، بل الذات وفطرتها على العمل والتميز.
2ـ العمل المأجور، هو عمل في قبال أجر وغالبا أجر مالي، بالتالي يتحول فيه الفرد إلى آلة، كلما زاد من كفاءته وقدرته في العمل، وزاد إنتاجه المادي للجهة التي يعمل لديها، كلما زاد أجره، بالتالي يكون هنا المجتمع مجتمع طبقي قائم على الصراع لا التنافس، تغيب عنه القيم الإنسانية، وتحضر القيم المادية، وتتشكل فيه الطبقات على أساس رأسمالي جشع، يغيب عنه الحركية والحيوية والتكاتف والتعاضد، وهذا توصيف لواقعنا المعاصر حيث تهيمن الرأسمالية علي العقول الاقتصادية في العالم، وبالتالي تشيد أنظمتها في الوظائف على أساس القيم الرأسمالية التي حولت الإنسان إلى آلة، عليه أن يراعي دوما كفاءتها، وتطويرها، لا لأجل الكمال والتكامل المادي والمعنوي، بل الكمال المادي الذي يطور مهاراته المادية وتجعله يعيش دوماً في صراع الديمومة والبقاء، مع نظرائه.
وهذا لا يعني أبداً أن كل عامل مقابل أجر بالضرورة هو عمل غير رسالي أو مذموم، أو قائم على أسس مادية، بل وفق ما ورد في الروايات أن العمل عبادة، وأن الكاد على عياله كالمتشحط بدمه في سبيل الله، ولكن نحن هنا في صدد التمييز بين فعل الوعي المتعلق بالمثقف وغيره، لأن أصل العمل الذي يخدم الناس حتى لو كان مقابل أجر، قام صاحبه به على أكمل وجه، دون أن يقصر في وظيفته فإن ذلك عمل رسالي وخدمة للمجتمع وهو عمل صالح، لكنه ليس تغييري ولا يتعلق بوعي الناس. فالخدمة الصالحة تتعلق بما يقوم فيه الإنسان من خدمات توصف بذاتها صالحة في حق المجتمع، لكن الإصلاح هو عمل منظم بخطة مدروسة، وأهداف سامية وأدوات وآليات تطبيقية صالحة يقوم بها نخبة، ويقدمون لأجلها تضحيات كبيرة تعمل على تغيير فهم الناس وإصلاح محيطهم، فهو عمل متعلق بالمجال الإدراكي للمجتمع وتصويب مساراته المعرفية والسلوكية.
العمل الرسالي
عادة ما يتأرجح الفعل والتفاعل بين الإفراط والتفريط، خاصة على مستوى الآراء التي تستقرئ النص بأدوات علمية، وتستنبط الأحكام من أدلتها الظنية، وتشخص الإشكاليات الاجتماعية إما من منطلقات خاصة لها أبعاد شخصانية، أو أنها بعيدة عن الواقع في استقرائها له، وكانت العدالة النفسية من عناصر الحضور الخامل والنادر، وهو ما يمكن استقراؤه من المناهج والمسارات الموجودة عبر التاريخ.
ومن الملاحظ أن الهدف الرسالي هو آلي أكثر منه غائي، كونه سبيل وطريق لهدف أسمى وهو رضا الله، وكون الرسالة مودوعة في رحم الحركة ومرتبطة بها ارتباطا عضويا وظيفيا، يترتب بهما وعليهما سويا إحراز الأثر الخارجي على مستوى الفرد والمجتمع.
فأيّ دعوة تكتنز العلم لا يتبعها تطبيق وعمل، فهي دعوة تبقى في فضاءات بعيدة لا يمكن إحرازها لأثر حقيقي في محيط الفرد والمجتمع، فحراك المثقف الرسالي على سبيل المثال، علميا وثقافيا إذا كان مجردا عن العمل وبعيدا عن الواقع، سيتحول إلى مجرد نظريات لا تحدث أي تغيير في بنية وعي المجتمع المعرفية والسلوكية.
فالفكر صحيح أنه متقدم على العمل لكنه غير منفك عنه، بل لا قيمة للفكرة في عالم الحقيقة إلا إذا تم تنفيذها كمشروع في ساحات العمل الرسالي الناهض بالعقل والوعي.
فحراك المثقفين منقسم بين أهداف رسالية باتت غاية في ذاتها، لكنها مفرغة من الحركية التطبيقية، وتدور في طاحونة التنظير والتبليغ فقط، رغم ما للتبليغ من أهمية كبيرة لكن أهميته تكمن في كونه محركا بالأفكار إلى مشاريع عمل تنفذ وتطبق، كي تحول المجتمع تدريجيا لمجتمع مُوَحِّد، ليتحول إلى تبليغ عاطل عن العمل. خاصة مع عدم التزام كثير من المثقفين بأغلب ما يدعون إليه ويطرحونه من أفكار، وهو ما ينافي الآية الكريمة: ﴿أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴾ (البقرة: 44)، وهي غاية في الصراحة في مقصود خطابها والفئة المستهدفة بها.
وبين أهداف حركية لكنها فارغة من المحتوى التأسيسي الأصيل، هو مجرد حراك كمي يقوم به أفراد يملكون عزما وعقلا وقّادا بالأفكار كالمثقفين، وحيويةً فذة، أي هم طاقات لكنها واقعا طاقات مهدورة وعاطلة عن التنظير، خلاقيتها للأفكار عالية لكنها أفكار لا تخضع لمبضع التنظير والتشذيب والتقريب من الواقع، وإنزالها بعد ذلك بآليات صالحة للتطبيق، أفكار تخلط الحق بالباطل، والغث بالسمين، تحتاج غربلة تدمج بين النص والعقل بأدوات أصيلة ومنهج متقن له مراجعه الفكرية والمنهجية. أو أنهم عمال تنفيذيون بمهارة عالية، لكن دون وجود خطةً منهجية وأهداف رسالية مرحلية واضحة، يقود عملهم التغير اللحظي المرحلي المنفعل مع متطلبات المجتمع والسياسة.
وقد قال الله في محكم كتابه: ﴿الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً﴾ (الكهف: 104)؛ ﴿وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون﴾ (الأحزاب: 80).
هذا الحراك الكمي غالبا أفراده لا يمتلكون الأهلية الحقيقية في قيادة المشاريع المثمرة واقعيا، كون قراءة مجموعة كتب والمشاركة بمجموعة مؤتمرات ووجود مجموعة مشاريع، لا تعتبر معيارا حقيقيا وواقعيا منفردا في قياس أهلية الفرد، بل المعيار الكيفي لابد أن يجتمع مع الكمي وليس العكس، في تقييم أهلية الأفراد للقيام بنهضة المجتمع على كافة الأصعدة، فكل منا له سعة فهم وإدراك تختلف عن الآخر، وترتبط بمدى سعي الإنسان لتطوير قابليته وفهمه وإدراكه ومدى إدراكه للحق والحقيقة. هذا فضلا عن دخول المحسوبيات في ترشيح الشخصيات وليس الكفاءة، حتى في الوسط الرسالي الإسلامي غالبا يكون الترشيح في بعض أوساط الحراك الرسالي والثقافي، إن وجد في بعض الساحات، قائما على ترشيح شخصاني وليس معياري، يغلب عليه مدى طاعة المرشح ومدى التزامه بالولاء لهذه الجهة، وقد يكون يملك مقومات علمية وعملية، لكن أصل ترشيحه يكون لتلك الأسباب لا لمقوماته وكفاءته.
وهو ما يتضح جلياً عندما يختلف هذا الشخص مع تلك الرموز فيتم إقصاءه بسب ممارسته للنقد والتقويم([2])، وهو ما يفسر عند الرموز في عقلية العالم العربي والإسلامي بأنه خرج عن مبدأ الطاعة، رغم كفاءته وأهليته العالية، لكن لمجرد انتقاده واعتراضه تسقط كل تلك المؤهلات.
والأهلية هنا لا تعتني إلا بالكفاءة والقدرة والاقتدار، ومدى اتزان النفس وتخلصها من الهوى وميلها للحق والحقيقة، وثباتها على الحق وقدرتها على تنفيذ الخطط بفعالية عالية، وخلاّقي إبداعية تصب في صالح بناء الإنسان ووعيه. وامتلاك قدرة على اكتشاف مكامن الخلل في المشاريع الفكرية والثقافية، وفاعلية في تصويبها وسد ثغراتها بما يصب في سبيل الله لا سبيل الرموز.
وأستطيع القول: إن كثيراً من كوادر العمل الرسالي ومن المثقفين الرساليين خاصة، تتعاطى مع الدعوة الرسالية والعمل في سبيل الله بطريقة نسبية، بحيث تصبح أي فاعلية لها علقة بمدى ما تحققه من مصلحة للكادر ولرضا القيادات، التي بيدها مصالح ومقدرات هذا التيار أو ذاك.
لكن العمل الرسالي الحقيقي يجعل الكيف هو المعيار الحاكم، واجتماع الكم والكيف هو نور على نور في تقييم الكفاءات الموجودة.
إننا نحتاج لرسالية حراكية منتجة وإن لم تحرز ثمارها على المدى القريب، لكن إن كانت أهليتها عالية ومنهجيتها سليمة مستوية على صراط مستقيم، فإن ذلك حتما سينتج ثمارا وإن كان على المدى البعيد.
فالمطلوب في ذاته ليس العمل والتبليغ والحصول على الوجاهات الاجتماعية، ليصبح التأثير والسيطرة أكبر على وعي الناس وفق رغبات من يتصدى، وهي ممارسة شبيهة بممارسة المستبدين في السيطرة على وعي الناس بتجهيلهم وتوجيه وعيهم باتجاهات رغبات المستبد، ولكن الاختلاف هنا أن المثقف يستخدم علمه ووعيه ونضجه في السيطرة على وعي الناس، وتنصيب نفسه مستبدا بالعلم على عقولهم، وإنما المطلوب من العمل الرسالي هو إحراز رضا الله من خلال العمل وفق إرادته هو جل شأنه وتحت رقابته هو لا رقابة الناس والمسؤولين، وهو ما يمكن الإنسان من إتقان عمله حينما يستشعر رقابة الله أكثر من استشعاره لرقابة غيره، و الرسالية الحراكية سبيل إلى هذا الرضا، وكي نهتدي السبيل لابد أن تكون أدواته ومنهجه مستوياً على الصراط المستقيم، ويكون مقترنا كيفه بكمه وقوله بفعله، ومحرزاً للعدالة على كافة المستويات، ومعتدلا لا يميل إلى الافراط ولا إلى التفريط.
فلا حراك ثقافي رسالي دون حركية هادفة لتحقيق ملكوت السماء على الأرض، ولا حراك أرضي دون توسله بالرسالية الملكوتية السماوية كمنهج يستقيم عليه.
أما انتشار ثقافة الكم الحراكي لمجرد إثبات الذات([3]) التي جبلت على حب العمل، فإن النتائج ستكون عكسية، كما في الحراك الثقافي المتجرد من أي حراك تطبيقي رسالي.
فالثقافة الرسالية الحركية تتطلب ضوابط، تضبط إيقاعها وفق أسس سليمة تحفظ لها تحقيق غايتها في رضا الله بتوسل آليات ومنهج سليم.
ولو قمنا باستقراء واقع أغلب الساحات في العمل الثقافي الرسالي، وخاصة الإسلامي منه، لوجدناها تشترك في عدة مشتركات تعتبر نقاط ضعف أخلاقية ومنهجية في العمل الثقافي الرسالي العام وهي:
التاثُّر بسلوكيات علمانية وإنْ بشكل غير مباشر
ومن أهمّ وأخطر هذه السلوكيات هي:
1ـ انحسار العمل الثقافي الرسالي فقط في الأماكن الدينية كالمساجد والمراكز الإسلامية والتابعة لكل تيار وحزب، وعدم وجود رؤية للانتشار الاجتماعي والتواجد في مؤسسات الدولة وفق برنامج مدروس. وهي علمنة مبطنه وعزل للدين عن باقي المجتمع ومسارات الحياة. ولقد كان للشيخ محمد مهدي شمس الدين وصية في كتاب الوصايا تقول: «أوصي أبنائي وإخواني الشيعة الإمامية في كل وطن من أوطانهم وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم، أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم، وأن لا يميزوا أنفسهم بأي تمييز خاص، وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعاً خاصّاً يميزهم عن غيرهم، لأن المبدأ الأساس في الإسلام ـ وهو مبدأ أقرته مدرسة أهل البيت عليهم السلام ـ هو وحدة الأمة، التي تلازم وحدة المصلحة، ووحدة الأمة تقتضي الاندماج وعدم التمايز»([4]).
2ـ البراغماتية السلوكية في التعامل مع الأفراد، فالذي ينفع المشروع وفق إرادة قيادة المشروع كان له الحظوة، وإلاّ يتم تهميشه وعدم توظيف أي طاقة أو الاعتداد بعقله مهما كان وازناً وراجحاً، وخاصة أن معايير النفع غالباً هي معايير شخصانية بعناوين دينية، كالطاعة والولاء والانضباط، فالطاعة تكون للقيادة البشرية، وهنا لا نرفض مبدأ الطاعة، لكن نرفض توظيفه في سبيل شخصاني لا سبيل رضا الله، وتحويله من مفهوم نسبي إلى مطلق، بمعنى أن طاعة القيادة غير المعصومة، هي طاعة نسبية تتوقف على حكمة القيادة وبصيرتها ومصداقيتها ومدى انضباطها على الحق ومدى عدالتها النفسية وإنصافها وكفاءتها العلمية والعملية، من باب قبح اتباع العالم للجاهل، وانتهاجها لمنهج البحث عن الحقيقة والتزامها الأخلاقي القيمي، أما الطاعة المطلقة فهي لا تكون إلا لله ولمن عصم الله تعالى.
هذا فضلاً عن عدم تقدير العاملين كما يجب، فمن لا يتفق مع المنهج العام يتم تهميشه([5])، بل ويتم غالباً إهماله اجتماعياً([6]) حتى في التواصل الإنساني الممدوح عقلاً ونصّاً.
3ـ تعطيل الطاقات الثقافية لمجرد اختلاف وجهات النظر([7])، فيكون بذلك قاطع طريق لسبيل الله، وتفعيل من يتوافق مع وجهات النظر، حتى لو لم يكن أهلاً، وهذا يعود لفقدان منظومة القيم والمعايير المتصلة بالسماء، وتحولها لمنظومة قيم ومعايير نسبية بشرية.
4ـ رفض النقد والتقييم بحجة الاستهداف وعدم شقّ الصف، مع أن وجود الأعداء لا يعني السكوت عن الأخطاء، بل يجب مع وجود الأعداء النقد والتقييم لسد الثغرات وعدم فسح المجال لمن استهدفنا من النفوذ والاختراق من الثغرات.
5ـ الانغلاق على الذات، وما أعنيه الجلوس داخل الصندوق وعدم محاولة الخروج من مألوف ومشهور المحيط، وهنا لا أدعو لخروج دفعي صدامي، وإنما لخروج تدريجي تصحيحي تغييري للمحيط، كون العمل الرسالي أحد أهم أهدافه التغيير الإيجابي وتصحيح مسيرة المجتمع وصناعة وعي وازن، وهو ما يتطلب انفتاح اجتماعي وعلى كافة المستويات والآفاق، وخلق مشتركات يمكن من خلالها إيجاد أرضيات تعاون مع كافة فئات المجتمع ومكوناته، بل يتطلب مواكبة للزمان والمكان ومتغيرات المجتمع والمحيط الداخلي والخارجي، للمواكبة والمواءمة القائمة على أسس سليمة منهجية، حتى لا يكون العامل بعيداً عن لغة المحيط، ولا يدرك حجم المتغيرات فتسبقه القافلة بينما هو يقف عند محطة القطار القديم المتهالك.
6ـ غلبة أصالة المجتمع على الفرد، وهي مس اشتراكي غير مباشر في الوعي والسلوك، حيث تقدم مصلحة الجماعة على المصالح الطبيعية للفرد([8])، ويغلب العقل الجمعي على قاعدة «خيركم من جمع العقول لعقله» وهي قاعدة تعمد إلى الاهتمام بكل العقول الناهضة والفاعلة، وجمعها لتحدث توازناً في الرأي والفكرة، وبالتالي في الرؤية والسلوك والعمل. هذه الغلبة تكون نسبية، فغلبة أصالة المجتمع تكون في العمل والتنفيذ، وغلبة أصالة الفرد على المجتمع تكون في القيادة ووضع الخطط والاستراتيجيات، حيث يتصدى أفراد دون انتخابهم، وإنما لمجرد الأقدمية غالبا يتصدون لوضع الخطط والاستراتيجيات في كافة المجالات.
بينما وازن الإسلام بين الأصالتين، وكانت العدالة حاكمة بينهما بحيث في مواقف قدم إحداهما على الأخرى بما يحقق التوازن ومصلحة المجتمع العامة، وهو ما يجب أن تعيه الحراكات الرسالية وتضع خططها وفقه.
7ـ تهميش المرأة وحصر عملها في التنفيذ([9])، وعدم وجودها في مراكز القرار والتخطيط، هذا فضلاً عن عدم الدفع باتجاه ارتقاء خطابها لمعطيات الزمان والمكان، وحصره في دائرة ضيقة مكانياً وزمانياً ومذهبته، ليكون مقتصراً على فئة، وعدم مواكبته لأهم الإشكاليات التي تواجه المرأة في المجتمع على كافة المستويات، هذا الحصر هو نوع من العلمنة في عزل الحراك الثقافي عن باقي المجتمع، ومرافق الدولة المختلفة، نتيجة مذهبة الخطاب وعدم تحويله لخطاب عالمي.
8ـ ومن مظاهر المس العلماني في أغلب الحراكات الثقافية الرسالية هو ديننة الخطابات والدعوات وبأساليب قديمة، وما أعنيه بالديننة هو الخطاب الوعظي وغير المواكب لمتطلبات العصر، وأهم الإشكاليات التي تعاني منها المجتمعات، وحصره في إطار ضيق من الدين نتيجة فهم ضيق للنصوص، وتحييد العقل عن امتلاك مكنة التشخيص، وإقصائه عن حاجات الناس وقضايا المجتمع وراهن العالم وتطورات الحدث، بذلك يكون تم تقليص الفهم الديني إلى إطار ضيق لا يهتم إلا بجانب من جوانب حاجات الإنسان وجانب من حاجات الروح.
9ـ هناك تهميش للقيم والمبادئ والأخلاق غالبا في كيفية التعاطي بين الإنسان ونظيره الإنسان، ومن أبرز المصاديق هو الإسقاط الاجتماعي للشخص الذي يختلف مع الجهة المنتمي إليها، سواء اختلاف في وجهات النظر وقيامه بالنقد والتقييم، أو اختلافه مع آليات العمل ومنهجياته ومحاولته للإصلاح والتصحيح، الذي غالباً يجابه بالرفض والإقصاء وينتهي بالتسقيط الاجتماعي.
وهو سلوك شبيه بحملات الوسائل الإعلامية التي تسيطر عليها دول الكبرى، بحيث تعمد إلى تزوير الحقيقة وتسقيط الجهات المناوئة لتلك الدول، فهو سلوك استكباري علماني، يفصل مساره عن القيم الدينية والأخلاقية.
هذا المس العلماني والاشتراكي لكثير من منهج وسلوك الحراك الثقافي الرسالي في كثير من المجتمعات، هو نتيجة غياب الدراسات الفاعلة حول رؤية الإسلام للعمل الثقافي الرسالي والإدارة، أو وجود دراسات لكن كثير من الجماعات الرسالية يغيب عن منهج عملها التنظير والتخطيط الاستراتيجي والمرحلي، ولا يوجد لديها غالبا مطابخ فكرية تعمل على رسم الخطط ودراسة الواقع ومعطياته، والخروج برؤية شرعية منهجية وفكرية كاملة.
إن المطلوب في ظلّ ترهُّل كثير من التيارات الرسالية الإسلامية، وتراجعها في مواكبة المجتمع ومتطلبات الجيل الشاب، هو نهضة شاملة قادرة على تقديم مشروع مثقف فاعلي تغييري تدريجي وليس دفعي، تحكمه قوانين السماء ومنظومة قيم ومعايير أخلاقية وإنسانية، يضع للكفاءة أولوية، وللتخطيط والمنهجة خيارات ناجعة، ويضم في حساباته الجيل الشاب والمرأة.
وخاصة أن العولمة استطاعت أن تقدم بدائل جاذبة وتلبي طموحات الشباب وإن مادياً، وإن وجود هذا الكم من الخلل في العمل الثقافي الرسالي خاصة القيمي والمعياري والمنهجي، هو ثغرة تدفع لتسرب الأجيال وهروبها من الدين لا لأنها ترفضه، بل لأن من تصدى لنشر الدين عمليا لم يكن أهلاً، أو لم يكن مؤهلاً وقادراً على المواءمة والمواكبة وسد الثغرات.
إن جاذبية الدين للإنسان فطرية، لكن عملانياً نحتاج تطبيق هذه الجاذبية وتنزيلها للواقع، لنجد الناس تدخل إلى دين الله أفواجا، لا دين الرموز والقادة، وهو ما يتطلب قيادات وعاملين ربانيين يتخلصون من الأنا، ويجعلون همهم رضا الله، فلا يكونوا قطاع طرق عن الله، بل جسوراً إليه.
العمل الرسالي أو ما يمكن تسميته أيضاً العمل التطوعي وخاصة في المجال الثقافي والمعرفي، يعاني من خلل رئيس ومحوري وهو تصدي الأكفأ والأكثر استحقاقا.
الكفاءة والاستحقاق والأثر
الاشتغال على منطقة الوعي اشتغال يتطلّب توفر عدة شروط في المُشْتَغِل، وإذا ما كنا نتحدث عن المثقف ووظيفته ومسؤوليته، بالتالي نحن نتحدث عن امتلاكه لعدة أمور قبلية تستبق حراكه الاجتماعي وتصديه:
1ـ امتلاكه القدرة والتي تعتبر البناء الأساسي والتحتي، والذي يُفَعِّل عزيمته للسعي وكسب المعارف والخبرات والتجارب في المجال الثقافي، وهذه القدرة والمُكْنَة هي التي تشكل له القاعدة في إمكانياته.
2ـ الكفاءة، وهي مجموعة ما يملكه من معارف وعلوم وخبرات ومهارات تجعله الأكثر قدرة على التصدي اجتماعيا من غيره، وهذا يثبته فعله الثقافي وتأثيره في المجتمع، والكفاءة هنا لا تقتصر على الملكات المادية التي تركز على كم المعارف والعلوم، بل على نوعها، ولا تقتصر على كفاءته الظاهرية، بل إن كفاءته الباطنية تعتبر المنطلق والأساس لتحقيق الكفاءة الظاهرية، وهو ما لا يمكن أن يتضح للعيان إلا من خلال سلوك المثقف الاجتماعي ونوعية ما يطرحه من معارف ووعي.
3ـ الفاعلية، فقد تجتمع في المثقف القدرة والكفاءة، لكنه لا يكون فاعلاً، وأعني بذلك فاعليته في تحقيق أهدافه وإبداع طرق لتوظيف ثقافته في رفع منسوب الوعي، وحل الإشكاليات الثقافية والمعرفية التي يواجهها مجتمعه الداخلي والخارجي، وطرق الحل التي يجب أن تتناسب وعصره وما يواجهه من تحديات.
ولكنْ لماذا يجب على مَنْ يتصدى لهذه الوظيفة أن تتوفر فيه هذه الشروط؟
إن من أهم الآثار التي تترتب على توفر هذه العوامل في المتصدي للعمل الثقافي والمعرفي هو:
1ـ المصداقية، فإذا ارتبطت كفاءته الظاهرية بكفاءته الباطنية وكان حراكه الاجتماعي يفكك الإشكاليات المعرفية، ويحقق حركة وعي حقيقية تؤثر على حراك المجتمع، فإن ذلك يعزز من مصداقيته بين الناس، ويوثق العرى بين المجتمع والمعرفة.
2ـ الثقة: تحقيق المثقف الكفؤ لمصداقيته الاجتماعية يؤدي لبناء جسور الثقة بينه وبين مكونات المجتمع والدولة بكافّة الاتجاهات، بالتالي يجعله مرجعية معيارية ومعرفية، يتم من خلالها تقييم المعارف وفقها، ويصبح بذلك حارس لوعي الناس، ومعزز لعلاقتهم بهويتهم.
3ـ الأمانة، يصبح بعد إثبات مصداقيته وتعزيز ثقة الناس به، أميناً على عقولهم ووعيهم من الاستلاب والاغتراب، ومن كل محاولات الاستعباد، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان كفؤاً يمتلك قدرات معرفية في تشخيص الخلل، ورؤية الواقع خارج كل الأطر التي تُسَوِّرْ عقول الناس وتمنعهم من رؤية الواقع كما هو.
لذلك يعتبر تصدي غير الكفؤ في كافة المجالات، وخاصة المعرفية والثقافية أمراً مرفوضاً ومذموماً عقلاً وشرعاً، بل هناك روايات صريحة تذمّ تصدّي غير الكفؤ، وتنهى عن ذلك.
وهذا التشديد في التأكيد على تصدي الكفاءة، هو لما لهذا التصدي من آثار عظيمة على المستوى المعرفي والقيمي، والأخلاقي، والمعياري والمبدئي.
لذلك أول شرط في تصدي المثقف اجتماعياً هو كفاءته، والكفاءة لا تحدّد بالكم من المعارف فقط، بل أيضا بنوعها، ولا تحدد بالكفاءة الظاهرية فقط، بل بكفاءة الظاهر مع الباطن.
([1]) محاضرة حول العمل الرسالي والعمل المأجور، للسيد الإمام موسى الصدر، ألقيت في يوم الأحد ٢ نيسان ـ إبريل ١٩٧٢م. المصدر: مركز الإمام موسى الصدر للدراسات والأبحاث.
([2]) مثقف مقهور وممارسة قهرية.
([3]) حول الذات وتفصيل أبعادها يمكن مراجعة كتابي «الإصلاح والتغيير مطالعة في التأسيسات والإشكاليات والمعوقات».
([4]) وصايا الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين: 17، دار النهار، ط1.