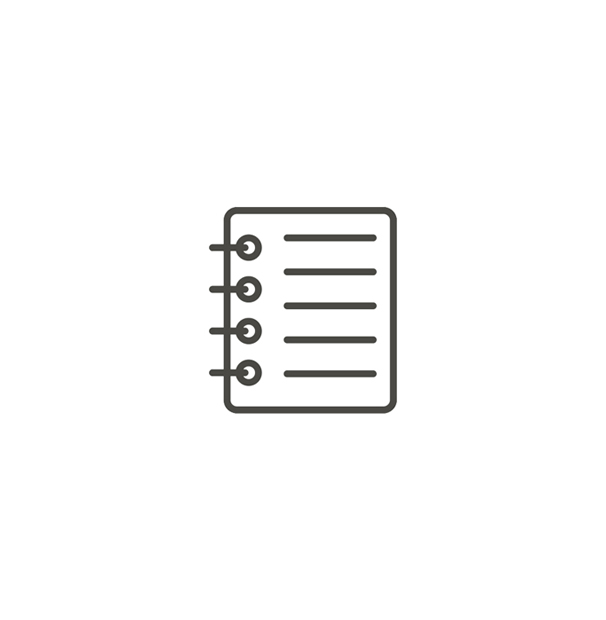الشيخ حسين المصطفى
من أخطر الأمور التي تتداعى إليها المفاهيم المنساقة هو عدم فصل الخطيب الحسيني عن عالم الدين (الحوزوي)، مع أنّ الواقع المعرفي يأخذ بنا إلى أن هناك تمايزاً جوهرياً بين الوظيفتين، فعالم الدين (الحوزوي) تقوم أدواته على المماحكة العلمية الاستدلالية التي تخضع لقانون علمي دقيق، بينما الخطيب الحسيني فلا يراعي هذا الجانب المعرفي، وبالتفات بسيط إلى ما يعرض على القنوات الشيعية نجد المفارقة كبيرة بين الوظيفتين.
وعدم الجرأة في فصل الوظيفتين أدّى إلى فوضى معرفية وازدواجية في معايير الحوزة التي تؤمن بالعلم والمنطق من جهة وبين ما تلقيه على المنبر من جهة أخرى.
وتحكم المثقف في عالمنا الإسلامي هواجس النهوض الحضاري، وهي هواجس أكبر من أن يحيط بها مثقف أو يتصدرها طالما أنه لم يعِ تراثه وعياً كاملاً، فلا يتاح له أن يعيش حالة التوازن بين ماض يريد العزوف عنه ومستقبل يطمح إليه، ويتسبب ذلك عادة بالقطيعة مع التراث والتي تتبدّى بأشكال مختلفة، وهي قطيعة تترسخ معالمها من خلال ما يستوحيه من نظم وافدة لا تنتمي بحال إلى هذا التراث.
وفي المقابل يتسلَّح عالم الدين بما يفتقر إليه المثقف من نظم تراثية (شبّ عليها وشاب). ولكنه مع ذلك قد يقع في أسر هذه النظم بحيث يتعسر عليه أن يتجاوز ما يمكن تجاوزه فيها، ويعود السبب في ذلك إلى الطرق التي من خلالها يهضم التراث والتي قد لا تفسح في المجال لمثل هذا التجاوز فيما لو أسيء فهم التراث الديني.
ولا أقصد بهذا أن أفصح عن لبِّ المشكلة القائمة بين المثقف وعالم الدين بمقدار ما قصدت إلى الإفصاح عن المراد من المثقف هنا ولو بنحو الإشارة والإجمال ومن دون الدخول في التحديدات المملة، فإنه ليس من المفارقات الكبرى أن يقوم عالم الدين بمهمة المثقف أو العكس، ولكن عالم الدين يغدو مثقفاً، كما أنّ المثقف يكون مدفوعاً بالحميِّة الدينية في تلك الحال.
ومهما يكن فقد تطرقتُ فيما يلي إلى بعض النواحي التي قد تسلط بعض الضوء على مجالات يظهر فيها الخلاف بين المثقف والعالم الديني:
أـ سطوة الأسس الفكرية
إنّ الإنسان محكوم في رؤيته للواقع لشبكة من المؤثرات والمنظومات الفكرية التي درج عليها في أثناء تكوينه الذهني. ونظراً لتفاوت المنطلقات والأهداف التعليمية ما بين الحوزة والجامعة، فإنّ الواقع سوف ينعكس في ذهنية المتلقي عموماً، وبالتالي يتبلور فهمه للأشياء بالكيفية التي تشكلت بها ذهنيته الثقافية. ولهذا ربما قد نفاجأ حين نجد أنّ المشكلة التي يعاني منها الطرفين واحدة، ولكن مع اختلاف في المنطلقات والأهداف وحدّة التباين في الرؤية أيضاً.
فالعلم لا يكون علماً إلا بمقدار ما يلامس الواقع. وبهذا الاعتبار، سوف تقف بين المثقف والعالم الديني من جهة، والواقع الذي ينتمي إليه كل منهما من جهة ثانية فاصلة، هذه الفاصلة يمكن أن نعبر عنها كما يلي:
1ـ واقع لا ينتمي إلى الأسس الفكرية «المعاصرة»، والمطلوب في هذه الحالة تغيير الواقع بما يتناسب مع تلك الأسس كشرط للانطلاق. وتلك هي مشكلة المثقف.
2ـ وواقع ينتمي إلى الأسس الفكرية «التراثية»، ولكن مع وجود مساحة فاصلة تستدعي تطوير الخطاب وتحيينه وتفعيله لمعاصرة الحدث. وتلك مشكلة عالم الدين.
ب ـ التخصُّص سلاحٌ ذو حدَّيْن
العلوم الإسلامية متمحورة حول النص، ومن مميزات النص الديني أنه شمولي، ونظراً لتعقيد الواقع فإنّ ربط النص بالواقع يستدعي العمل على إيجاد التخصص في مجال العلوم الدينية، في حين يفتقر الواقع التثقيفي الديني عموماً إلى هذه التخصصية، ويتسم العالم الديني بالشمولية على مستوى الطرح.
فالدارس الأكاديمي ينظر إلى العلاقات والروابط القائمة بين التيارات الفكرية بنظرة كلية شاملة في محاولة استجلاء معالمها الرئيسية وذلك من خلال مقارنة أوجه الاختلاف فيما بينها والحدود التي تفصل بعضها عن بعض، ولكن من دون الدخول في المعطيات المباشرة للظواهر المدروسة.
بينما الدارس الحوزوي يغرق في المعطيات المباشرة، بحيث يكاد أن تغيب عنه المعالم الكلية الفاصلة بين هذه التيارات الفكرية غالباً، ولكنه يمتلك بذلك وعي الحقيقة في تفاصيلها وهمومها الآنية. وفرق كبير بين التحليق بعيداً عن الأرض، وبين الاحتكاك الحميم بها.
ج ـ البعد الأيديولوجي في تفسير الظاهرة
ينظر إلى التفسير المادي النافي للتفسير الغيبي، على أنه واحد من الأبعاد الإيديولوجية التي تدخل في نسيج البناء العلمي، بحيث تتشكل على أساسه الهوية العلمية. وهذا يكشف عن بعض وجوه التفاوت في المنطلقات الفكرية بين المثقف وعالم الدين.
فحين ينطلق المثقف وعالم الدين لمعالجة قضية ما من قضايا الواقع المعيش، مثل قضية «الإصابة بالعين» أو «الجن» مثلاً، هنا سوف يعمد المثقف إلى تحليل هذه الظاهرة على الأسس العلمية، وإذا لم يجد لها تفسيراً ضمن النطاق الفيزيائي، أو النفسي التجريبي… سوف يعمد إلى رفض هذه الظاهرة. وهو في رفضه لها لا ينطلق من أسس علمية طبعاً، فيكفي أن تنتفي القدرة العلمية على سبر أغوار الظاهرة حتى يتبرر بذلك نفيها عن الواقع المقبول لديه!
بينما عالم الدين لا يتوقف عند الإثبات المادي المباشر لهذه الظاهرة طالما أنّ النص قد برر للاعتراف بها، وطالما أنّ العقل لا يرى استحالتها، وطالما أنّ العلم القطعي لم ينطق بكلمته بعد، وحتى في صورة إفصاح العلم عن رأيه إزاء الظاهرة، فإنّ الكشف عن البعد المادي لا ينفي وجود البعد الغيبي أصلاً.
ومهما يكن فإنّ التعارض هنا في المعطيات المادية بين الدين والعلم لا يعدو أن يكون وهمياً وغير حقيقي. وهذا يشبه إلى حد كبير التعارض الموهوم في مجال العلوم الإنسانية، حيث يتم إخراج القضية بصرة صراع ما بين الدين والعلم. وقد يسعى المثقف بدافع من الاعتداد العلمي، إلى تقديم تصوراته بصفتها ناجزة ومكتملة، مع أنه وبمقتضى العلمية ذاتها تميل التصورات العلمية أن تكون حيوية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تقديم العلم نفسه على أنه منهجية وطريقة في البحث لا أكثر.
د ـ الفصل بين الأحكام والموضوعات
قد يثير البعض قضية أنّ الفقيه يعمل على إنتاج الحكم الشرعي للواقع من خلال خبراته الأصولية والفقهية، وأنّ المثقف ينتج الواقع الذي ينطبق عليه الحكم ويحدده، ويرى في هذا تكاملاً معرفياً. وهو يسعى بهذا لإجراء نوع من المصالحة التبرعية، كالتي تكون بين الخصوم، بحيث لا تستند إلى أساس سليم.
فلا ينبغي تبسيط الأمر بحجة الحصول على وفاق بين عالم الدين والمثقف، بحيث تتم المصالحة على أساس ما يشبه التعاقد التصافقي، ويتم تبادل الأدوار على أساس تكافؤ حصصي. فإنّ مثل هذا التكامل قد ينفع فيما لو كانت المشكلة نابعة من تجاوز كل من الأطراف لمجال اختصاصه والتعدي على مجال اختصاص الآخر. كما هو الحال في نمط تعامل كنيسة العصور الوسطى مع المثقفين. حيث لم تكن الكنيسة تملك رصيداً دينياً مباشراً يخولها الإمساك بالسلطات الزمنية، ومع ذلك فقد نالت نصيبها من السلطان على أساس التعاقد المصلحي الآني.
أما في حالتنا نحن، حيث يكون للفقيه اختصاصه الكلي الشامل للأحكام والموضوعات، فإن توزيع الأدوار بالشكل المطروح سوف لن يعدو عن أن يكون إجحافاً بحق أحد الأطراف ينعكس أثره سلباً على الواقع بعينه. فقد أعطى التصور الإسلامي للفقيه سلطة تشمل حتى مجالات التشخيص في الموضوعات الكلية.
هـ ـ الفصل بين التنظير والواقع
ينظر المثقف إلى أنّ تجدد العلوم الدينية أمر ضروري لمماشاة الواقع المتغير، بينما يصر العالم الديني على صياغة علومه الدينية على أساس من علوم الفلسفة والمنطق والرياضيات… نظراً لما تحظى به هذه العلوم من تماسك.
ويرى المثقف أنّ هذا التماسك يتأتى من كون هذه العلوم تعبِّر عن فكر مستقل نسبياً أو كلياً عن الواقع، وبالتالي تتسم هذه العلوم بطابع الهيمنة على الواقع ومحاولة إخضاعه واحتوائه كلياً أو جزئياً. ويعزو المثقف التخلف على مستوى الواقع إلى هذا التماسك الذي جعل من الدين فكراً غريباً لا يستجيب لمتغيرات الواقع وتحولاته، ولا يشبع طموح الإنسان المسلم أو يروي غليله في شيء… وبالتالي ينبغي أن ترتبط العلوم الدينية بعجلة العلوم الإنسانية من اجتماعية وسياسية واقتصادية ونفسية… وهي علوم تتسم بكونها أكثر التصاقاً بالواقع من غيرها.
وقد يبدو أنّ مهمة المثقف هنا تتحدد في إطار تفسير الواقع الديني بما يتلاءم مع توصيف بنية هذا الواقع بمعزل عن الأهداف المعيارية وإطلاق الأحكام. بينما تكمن مهمة العالم الديني في تغيير هذا الواقع بما يسمح له بالتكيف مع ما تصبو إليه النظرية، وذلك بصفته محيطاً بأبعاد النظرية الدينية من جهة، ومبلغاً رسالياً من جهة ثانية. فالمثقف أشبه بالباحث الذي يصف الواقع ويسجل توصيات ذات طابع نقدي، أما زمام التكييف والتغيير فيقع على عاتق العالم الديني. وإذا صح هذا الكلام، فإنّ إشكالية العلاقة بين المثقف والعالم الديني تظهر إلى السطح بمقدار ما يتجاوز أحدهما مجال اختصاصه ليصدر الأحكام فيما هو من مجال الطرف الآخر.