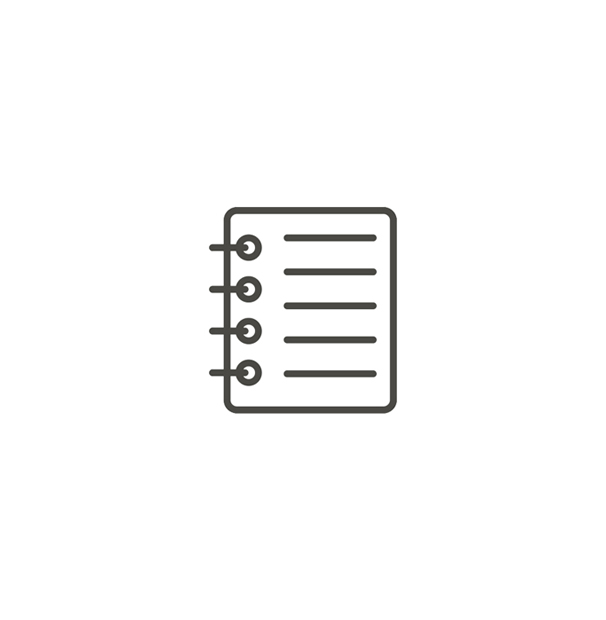إيمان شمس الدين
إن القراءة التاريخية المنصفة، هي القراءة التي تبتعد عن أي أهواء طائفية ومذهبية وتدرس حراك الشخصيات التاريخية المهمة والمعصومة على أنه حراكا هادفا لتحقيق غايات عليا أهمها رضا الله تعالى وتوحيده على الأرض، وإقامة العدل ورفع الظلم عن المظلومين مهما كانت مذاهبهم ومرجعياتهم الفكرية، لأن الظلم ومواجهته لا يختص بإنسان دون إنسان، وصريح القرآن يخاطب رسول الله قائلا: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”. لتوحيد الجبهات في وجه الظالمين والمستكبرين مهما كانت هوياتهم وانتماءاتهم، لأن الظلم والاستكبار لا يخص جهة دون جهة وفئة دون فئة.
ونحن هنا لا ننكر نقل الاحداث التاريخية، ولكن ننكر تقديس هذه الأحداث والوقوف عندها بطريقة تبث الفتنة والفرقة وتضرب وحدة الصف، بدل أن تحقق أهداف هذه الأحداث وغاياتها وعللها.
فالقراءة المقاصدية والغائية المنصفة للتاريخ والبعيدة عن الأهواء والمنطلقات الشخصانية والمذهبية والطائفية، هي الكفيلة في أن تجعل من تاريخنا كتابا ذاخرا نبني منه مستقبلا مشرقا وحضارة بناءة، ونخرج من أسر الأموات إلى سماء الأحياء لنرسم لهم الحاضر بأصالة الماضي وثقافة الحاضر، فلكل حقبة زمنية أهلها وهم المسؤولين عنها، والقرآن يؤكد حينما يروي قصص الأولين على عدة أمور أهمها:
١. أخذ العبر والدروس من تلك القصص.
٢. استلهام السنن والقوانين التي تحكم التاريخ.
٣. أن تلك الأمم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولسنا معنيين بأفعالهم بل معنيين بالاعتبار منهم وأخذ ما يصب في الطريق المستقيم، وعدم تكرار ما قاموا به وأدى لتفتتهم واندثار هويتهم وحضارتهم ومكتسباتهم ومنجزهم المعرفي.
فالسنن التاريخية حتميات تقع مهمة تمظهرها كواقع على إرادة الإنسان واختياره، وهما العلة التي بها تكتمل العلة التامة، و من يسير عكس السنن فإن سيره سيصل إلى نقطة مفصلية، لتنقلب ضده الأمور بعد ذلك وتعود المسيرة نحو سيرها الطبيعي التكاملي.
المثقف وأزمة التاريخ:
تختلف البنية المعرفية للمثقف ما بعد العولمة، عن بنيته ما قبل العولمة، وهو ليس اختلافا في الجذور وإنما في التشكيلات المعرفية الفوقية، التي ضعضعت عند بعضهم الأصول بسبب الكشوفات المعرفية التي أماطت اللثام عن حقيقة التاريخ، ومدى وثاقة ما تم نقله إلينا من رواية تقص علينا أحداثه بما تحمله من موروث ديني من جهة، وما تحمله من دلالات ومحمولات معرفية من جهة أخرى.
وخاصة مع إماطة اللثام عن مناهج علمية رصينة في قراءة التاريخ، استطاعت رسم خارطة طريق أولية لأحداث التاريخ في الماضي، وكيف على ضوء هذه المناهج تهاوت كثير من المسلمات المعرفية، التي شُيِّدت عليها ووفقها كثير من الأفكار والمعتقدات والمسارات، وانهيارها بعد تطبيق المناهج الجديدة في قراءة التاريخ عليها، قوض أغلب تلك التركيبة الذهنية المعرفية المرتبطة بها. خاصة مع غياب الممارسة النقدية السليمة، والتسالم الإطمناني في النقل بين الشخصيات العلمية الكبيرة، التي طغت عليمتها وعظم إنجازاتها رغم بشريتها على الجو العلمي العام، وساهم ذلك في نشوء هيبة علمية في ذهنية اللاحقين، منعتهم عن النقد والتقييم والمراجعة لنتاجهم المعرفي ونقلهم التاريخي خاصة فيما يتعلق في النصوص الدينية، أو ما يتعلق بالأحداث التاريخية بشكل عام والمشهد الديني فيها بشكل خاص، مع اكتشاف مخطوطات جديدة وحفريات أماطت اللثام عن حقب تاريخية كشفت لنا مشهدا آخرا من التاريخ الموروث كتابة ونقلا.
طبعا نحن هنا لا نقيم المناهج القارئة للتاريخ، ولا ما توصلت له من نتائج، ولكننا نوصف مسارا معرفيا في شكل البنية المعرفية وكيفية تكوينها ومصادر هذه المعرفة التي شكلت معارف المثقف، والمؤثرات التي لعبت دورا في تغيير هذه البنية وتقويض بعض أسسها، أو تغيير بعض مساراتها ومسلماتها، بل وثوابتها.
ومع تطور الحركة العلمية ومناهجها في قراءة التاريخ، وما تحقق من انكشافات على يد كثير من روادها، وإعادة استثمار هذه المناهج من قبل المتخصصين في التاريخ الاسلامي، و كشف كم التزوير الذي تم في كتابة التاريخ من قبل المؤرخين أو ضياع أحداث تاريخية لأسباب أهمها:
١. قيام السلطة الحاكمة بالهيمنة على عملية كتابة التاريخ، من خلال شراء كثير من العلماء والمؤخرين بشكل مباشر أو غير مباشر، ودفعهم لكتابة تاريخ يتناسب ومرادهم وطموحات السلطة.
٢. ونتيجة هذا الدس من قبل السلطة تولد رد فعل معاكس من قبل تيار حاول كتابة التاريخ، لكنه فعل ذلك كرد فعل، وهو ما قد يخضعه لانفعالات ذاتية تجعله غير موضوعي في النقل، وغير منصف حتى مع السلطة التي لا يواليها، فينقل التاريخ من وجهة نظره هو.
٣. هناك من حركته العصبيات المذهبية والقبلية، وتحت شعار الدفاع عن الدين، أو الكذب بحجة الحفاظ على مدرسة هو ينتمي إليها، فقام بكتابة التاريخ ونقل الموروث منطلقا من هذه المنطلقات والتحيزات، التي عادة تبعد المؤرخ أو الراوي عن الموضوعية والإنصاف العلمي، بل تمنعه من التحيز للحقيقة حتى لو خالفت مراده وأهدافه.
٤. هناك من كتب التاريخ ورواه ونقل الموروث بموضوعية وإنصاف، لكن هؤلاء قلة، وقد تصدى عبر التاريخ لهم إما السلطة الحاكمة، أو المخالفين لهم مما لا يريدون للتاريخ أن ينقل كما هو، فتمت إما ملاحقتهم، أو تم إخفاء كل منتجهم المعرفي وروايتهم التاريخية المنصفة، وقد كشفت بعض حملات التنقيب عن الأحافير والآثار، عن بعض المخطوطات المهمة في تلك الحقب الزمانية.
٥. الحروب وما خلفته من دمار طال المكتبات الإسلامية بما فيها من مخطوطات وموسوعات، كان تضم كثير من أحداث التاريخ ونصوصه خاصة النص الديني، وحرق كثير من المكتبات الخاصة ببعض الشخصيات الدينية، لأسباب بعضها مذهبي وطائفي، وبعضها جاء نتيجة الحروب الداخلية أوالإغارات من قبل الأعداء الخاوجيين.
إذا نحن أمام أزمة ثقة بالمنقول من الموروث، لا تدفعنا للرفض المطلق له، ولا التسليم الأطمئناني الساذج إليه، بل تدفعنا لفتح باب دراسة هذا التاريخ على مصراعيه للمتخصصين، واستخدام المناهج الحديثة في عمل حفر عميق في بنيته الداخلية والخارجية، وإعادة كتابته بعد تخليصه من التزييف الذي أحكم الخناق عليه، وأيضا يدفعنا إلى توثيق حاضرنا بطرق منهجية علمية تحفظ هذا الحاضر من أي محاولات تزوير للأجيال القادمة، لحل إشكالية وأزمة الثقة بالموروث التاريخي التي ظهرت كسمة في هذا العصر بعد العولمة.
والمثقف الناقد للإطمئنان التواضعي من قبل كثير من العلماء والنخب لما نقل من التاريخ، عليه أيضا أن لا يقوم بالرفض المطلق للموروث التاريخي بحجة فقدان الثقة ضمن تفكير عشوائي غير منظم، بل عليه أن يبدأ الحفر لمعرفة الموروث التاريخي الواقعي وأحداثه الصحيحة والاستفادة من سننه وتجربته البشرية في حاضره، وهو ما يتطلب منه تفكيرا منظما، يبني فيه رؤيته فكرة فكرة دون القفر من العام إلى الخاص أو بالعكس، ودون الاكتفاء بالنظرة السطحية للتاريخ، بل عليه الولوج إلى العمق والحفر في الداخل بتأني وصبر ليصل إلى نتيجة علمية رصينة غير متحيزة. “لأن عشوائية التفكير قد تفقد النقد قدرته على إضابة كبد الحقيقة، بل قد تقضي في بعض الأحيان إلى ضبابية الأفكار، والابتعاد عن جوهر الموضوع، وإرباك العمليات البحثية بتطويل المسافات عليها”[1].
إذا المثقف أمام مطلبين:
1 – الأول: دراسة الموروث التاريخي دراسة منهجية معمقة غير عشوائية، وإعادة قراءته وفق مناهج علمية رصينة تكشف غثه من سمينه.
2 ـ كتابة الحاضر وأحداثه ومجرياته بطريقة علمية منهجية، تحفظ هذا الحاضر من محاولات التزوير، حتى ينقل للأجيال اللاحقة كتاريخ دون أن يحمل عقدة الثقة و الدس، التي عانى منها المثقف مع تاريخه قبل تمحيصه.
ويمكن لهتين الخطوتين أن تتما في موازاة بعضهما البعض.
ويمكنهما حل كثير من الأزمات والإشكاليات المعرفية الراهنة، التي ظهرت نتيجة التناقضات الكثيرة في الأفكار المعرفية، التي تعتبر العمدة الرئيسية في تشكيل بنية المعتقدات والثوابت المعرفية. بل إشكالية أزمة النظرية مع التطبيق في كثير من الموروثات التاريخية خاصة الدينية منها.
مصادر المعرفة من دراسة التوثيق إلى توثيق الدراسات/ مقاربة أولية:
أغلب المعارك الفكرية والمعرفية التي تدور رحاها حول الوجود تعود في جذورها إلى مصادر المعرفة البشرية، وما يترتب على هذه المصادر وينبني على أساسها كل مسارات البشر في هذه الحياة، ورسم معالم عيشهم من السياسة إلى الاجتماع إلى الاقتصاد، بل إلى كل شيء يخص مسار الإنسان في هذه الدنيا.
ولست هنا بصدد استقراء شامل لكل المدارس وتفرعاتها شدة وضعفا انطلاقا من مصادر المعرفة وتصنيفات هذه المدارس ووفقها، لكنني سأسلط الضوء على المدرسة الإسلامية، التي تبنت مصادر معرفة اختلفت في منطلقاتها عن باقي المصادر.
وكان محور الخلاف بين الجميع هو الله وصلاحياته و مداها، كون منطلقات تبني أي مصادر ستؤول في نهاية المطاف إما للاعتراف بوجود الله وامتداد صلاحياته للانهاية، أو نكران وجوده بالأصل، أو الاعتراف بوجوده وتضييق مساحات صلاحياته في التشريع والتوجيه.
لذلك اعتبرت نظرية المعرفة من حيث مصادرها وقيمتها من أهم مقدمات كل العلوم، بل هي قاعدة الانطلاق لكل العلوم الفوقية، وهنا تكمن خطورة الأمر وعظم مسؤولية المتصدين في مجالات المعرفة والعلم.
المدرسة الإسلامية ومصادر معرفتها:
تبنت المدرسة الإسلامية بكل تفرعاتها خمس مصادر للمعرفة، لكنها تباينت شدة وضعفا في مراتب تلك المصادر وأهميتها وقيمة كل مصدر ، وتقدم أحدها على الآخر.
وما يهمنا هو فقط مصادر المعرفة التي اعتمدتها المدرسة الإسلامية.
اعتبرت هذه المدرسة أن مصادر المعرفة البشرية هي:
– الحس
– التجربة
– العقل
– النقل (القران والسنة التي يمثلها الحديث)
– الوجدان
حجية الحديث : توثيق وتصنيف:
و سأسلط الضوء على مصدر المعرفة المتمثل بالتقل وبالذات الروايات، التي تنقل لنا سنة النبي ص من قول وفعل وتقرير.وحجية الحديث تعتمد على سنده ومتنه، بمعنى أن يجتمع فيه صحة السند والمتن.
وقد خاض علماء الإسلام لأجل موضوع السند معارك رجالية طويلة، خاصة كلما ابتعدنا عن عصر التشريع، وظهرت وفقا لذلك مدارس كثيرة ومناهج كثيرة وأدوات كثيرة، وثقت رجالا وضعفت آخرين، ثم مع التقادم ظهرت وثائق تاريخية وأدلة جديدة، وثقت بعض الضعفاء وضعفت بعض الأقوياء، هذا فضلا عن تطور العلوم وعلم الآثار و مناهج قراءة التاريخ، والتي كشفت للباحثين ثغرات كبيرة في طرق النقل ورجالها، وملابسات تلك العصور، وهو ما جعل هذا المصدر المعرفي طريقا شائكا طويلا للحصول على يقين أو علم مفيد للاطمئنان.
وهذه التجربة النقلية وما رافقها من صعوبات عاشها الباحثون بأنفسهم تكشف لنا عن أهمية ليس فقط دراسة التوثيق، بل أهمية توثيق كل هذه الدراسات توثيقا محكما يمنع أي محاولات مصادرة وتحريف وسرقة أو حتى طمس، مع تعدد وسائل التقل والتوثيق والحفظ اليوم، خاصة أن دراسة هذه التوثيقات كشفت للباحثين الصعوبات التي تواجههم من حيث البحث والتحقق، أو حتى من حيث احراز الاطمئنان بالصدور، أي في بعدها الخارجي التحقيقي أو في بعدها النفسي التوثيقي.
وهو ما يدفعنا لعدم تكرار هذه المعاناة مع الأجيال القادمة، ومحاولة تلافي كل الأخطاء المقصودة أو غير المقصودة التي وقع بها أسلافنا ، وتلافي كل المخاطر التي كانت سببا في اندثار وثائق أو محوها أو تحريفها. لأن أهمية هذا المصدر تكمن في كونه أحد مصادر التشريع والتقنين المهم في حياة الإنسان، وهو مصدر ثابت إلهي مخالفته أو عدم الاطمئنان إليه والتأكد من صدوره يؤدي إلى زعزعة إيمان الأجيال اللاحقة، وزعزعة الوثوق في الصدور بل حتى في الوجود.
ولدينا هنا مرحلتين في موازاة بعضهما البعض:
.١ المرحلة الأولى وهي توثيق كل الدراسات التي تمت بخصوص علم الرجال ) الأسانيد) و مناهج البحث الجديدة، وكل ما طرح من إشكاليات واقعية على مناهج البحث القديمة وعلى الأسانيد، وكيفية معالجتها و الأدوات التي توصل لها الباحثون للوصول إلى أقرب قيمة توثيقية.
.٢ توثيق تاريخنا المعاصر وكل أحداثه العلمية، وكل تفاصيله السياسية والاجتماعية والاقتصادية، توثيقا محكما، وحفظه في عدة طرق تضمن عدم تحريفه وانتقاله من جيل إلى جيل، وعمل تشفيرات توثق المصدر والصدور، لتوفر جهدا على الأجيال في البحث وتوثيق الصدور. وهو ما يتطلب تخصيص مركز بحثي لتوثيق الدراسات ودراسة التوثيقات، والقيام بأرشفتها وفق أحدث الطرق التي يمكنها الحفاظ على دقة الناقل وتوثيق المنقول، وهناك نظم جديدة اليوم كالتشفير الصوتي والصوري وحتى الرقمي، يمكنها تجاوز عقبات الماضي في التوثيق، والتأسيس لمنهج توثيق متطور يتلافى كل محاولات التزوير والتحريف والاختراق، خاصة للدراسات الموثقة، و التوثيقات التي تمت على كل الدراسات الحديثية السابقة.
وهناك وسائل اليوم مبتكرة يمكنها فعليا حفظ المعلومات والدراسات بطريقة مشفرة، ووضع لكل دراسة شيفرة محددة تؤكد صدورها وحفظها من التحريف، وهو ما يتطلب جهد تكنولوجي وبحثي وكتابي باستخدام أحدث المناهج في القراءة التاريخية، لتوثيق راهننا وملابساته، وتوثيق دراستنا البحثية حول الحديث وطرق إثبات حجيته، وهو أيضا ما سيوفر جهدا كبيرا على الأجيال اللاحقة، ويقلل مساحات التشكيك في التراث التي وقعنا في عصرنا اليوم رهينة المطالبات بها، وأدخلت كثير من جيل الشباب في تشكيكات كبيرة، نتيجة عدم منهجة التراث وإعادة بنائه وفق قواعد علمية رصينة تزيل عنه التشكيك، وتوثق صدوراته الصحيحة وتغربل الغث من الثمين، دون رمي الغث ولكن دون اعتماده كحجة دون وجود قرائن تثبت حجيته حاليا.
بما يعني عمل تصنيف منهجي للتراث من حيث شدة التوثيق والوثوق، بحيث يحفظ كل ما وصل إلينا من تراث، لكنه أيضا يميز بين ما هو موثوق الصدور ، وما هو لا قرينة فيه ولا له بالتالي مشكوك الصدور.
لذلك حتى لا يقع اللاحقين فيما وقعنا به بسبب السابقين، على المختصين الالتفات لهذا الموضوع، والمباشرة في عمليات توثيقية محكمة لكلا المرحلتين، والمراكمة عليها كلما تقدمت التكنولوجيا لتنقل من جيل إلى جيل بطريقة علمية مصنفة تصنيفا منهجيا، شريطة العمل بروح إجمالية منفتحة على كل المصادر الحديثية، وما أعنيه بالروح الإجمالية، هو أن يقبل الشيعة بصحة مجمل ما جاء في مصادر السنة الحديثية، كما يقوم السنة بقبول صحة مجمل ما جاء في مصادر الشيعة الحديثية، والإجمال يحل معضلة مهمة في التوثيق والوثوق من حيث منهج الاستقراء المنطقي، وفي ذات الوقت يحافظ على كل التراث الإسلامي، ولكن وفق تصنيفات علمية تميز بين ما هو حجة وما هو ليس كذلك، خاصة مع وجود مشتركات قاعدية مهمة في نظرية المعرفة وهو اعتبار الحديث مصدرا من مصادر المعرفة البشرية الثابتة عند كل المسلمين، ولكن الاختلاف يكمن في تفاصيل كل مدرسة في مصنفاتها السندية، وفي منهج التوثيق، وهو ما يمكن معالجته من خلال هذا النوع من التوثيق الذي تم اقتراحه في هذه الورقة الأولية. وقد يعالج هذا النوع من التوثيق إشكاليات كبيرة في مشروع الوحدة الإسلامية، ويقدم خطوة هامة للأمام في وحدة الصف وتقليل الفجوة بين الفرق الإسلامية معرفيا.
[1] الشيخ حيدر حب الله ـ التفكير النقدي ـ محمد باقر الصدر أنموذجا