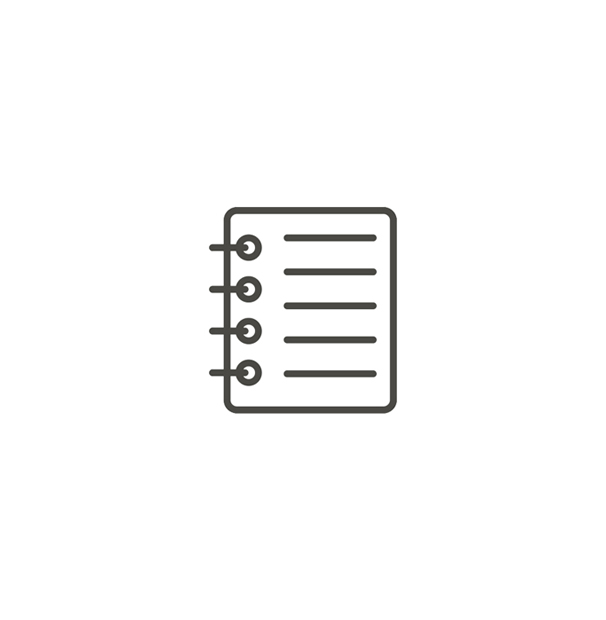حيدر حبّ الله[1]
تحرير وتنظيم بقلم: الشيخ سعيد نورا
تمهيد
رفع منذ حوالي عقودٍ عديدة شعارٌ، عرفه ضمناً المسلمون منذ قديم الأيام، وقد نجد له بعض النصوص القرآنية التي تؤيّده بمعنى من المعاني، وهو شعار (الإسلام هو الحل)، ورغم كون هذا الشعار ليس سوى ثلاث كلمات، لكنّ حجمه أكبر حتى مما تصوّر الذين صاغوه أنفسهم؛ لأنّه يحمل الكثير من التحدّيات على الإنسان المسلم، وعلى المشروع الإسلامي والمؤسّسة الدينيّة.
عندما نقول: (الإسلام هو الحل)، ثم نلاحظ قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف: 96) أو قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: 66)، ندرك أنّ هذه النصوص الدينيّة تعتبر أنّ نتيجة الإيمان والتقوى تحمل معها رفاهيةً اقتصاديّة، ونزول البركات من السماء والأرض، فعندما نقول: الإسلام هو الحل، فهذا يعني أنّ تطبيق الشريعة الإسلاميّة وتنزيل القيم الدينيّة هو الحلّ للمشاكل والأزمات، فيجب أن تظهر هذه الآثار الإيجابيّة على الأرض من وراء تطبيق الإسلام، وإلاّ فلا معنى لقوله تعالى ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أو لقوله: ﴿لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ بعدَ أن علّقها على الإيمان والتقوى.
أسئلة مشروعة عن نتائج التجربة الإسلاميّة
من هنا يظهر تساؤلٌ كبير: بعد أن مرّ المشروع الإسلامي بعقود من الزمن الإسلامي العام، منذ رفاعة الطهطاوي في القرن التاسع عشر الميلادي، مروراً بجمال الدين وخير الدين التونسي ومحمد عبده، ومحسن الأمين وصولاً إلى الخميني والمطهري ومحمد باقر الصدر وموسى الصدر وغيرهم، في كلّ هذه المسيرة وبعد مرور قرابة قرن من الزمن على دخول المشروع الإسلامي أرضَ الواقع، ظهرت تساؤلات لم تكن بحسبان ربما حتى الذين أطلقوا المشروع نفسه، وهذه التساؤلات هي تساؤلات الواقع: أين هي آثار تطبيق الإسلام على حياة الإنسان المعاصر؟ أين هي آثار النعمة والرفاهية في حياة الإنسان المسلم؟ إذا كان الإسلام هو الحل حقاً، فلماذا لا نرى آثاره الإيجابيّة على أرض الواقع؟
هذه أسئلة مشروعة ووجيهة جداً، وليست بالضرورة نابعةً من نوايا خبيثة، ونحن مطالبون بأن نقدّم لها جواباً.
نهجان في التعامل مع أسئلة الواقع
هناك طريقتان في الجواب عن هذا السؤال:
الطريقة الأولى: وهي تنطلق من القواعد العامة والمقدّمات العلميّة للوصول إلى النتائج، وهذا ما نسمّيه الاستدلال من الأعلى إلى الأسفل، أي ننطلق من القواعد الكلّية لإثبات المدّعى.
الطريقة الثانية: وهي تنطلق من الواقع والمصاديق الميدانيّة لإثبات المدّعى، وهو ما نسمّيه الاستدلال من الأسفل إلى الأعلى، هذه الطريقة ترجع في روحها إلى الاستقراء والتتبّع.
أمّا الطريقة الأولى، والتي اعتاد عليها الفكر الإسلامي المدرسي، ففيها نستطيع أن نراجع نصوص الكتاب والسنّة أو القواعد العقليّة لنُثبت جدوائيّة الإسلام، وأنّه الحلّ لمشاكل الإنسان، كأن نستحضر الآيتين السابقة الإشارة إليهما آنفاً، وهما دالتان على أنّ الإيمان والتقوى هما سبب رفاهية الإنسان ونزول البركات من السماء والأرض، فإذا لم نجد هذه الآثار على أرض الواقع، فإنّ هذا يعني أنّنا لسنا في تلك الدرجة من الإيمان والتقوى، ولا نراعي شرع الله كما هو.
كما يمكن التمسّك بدليل عقلي، من حيث إنّ الله تبارك وتعالى عالمٌ بجميع مصالح العباد، فالدين الذي ارتضى لهم هو الطريقة الوحيدة لخلاصهم ونجاتهم، فإذا لم نرَ آثاره الإيجابية على أرض الواقع، فهذا ليس إلا من جهة عدم تطبيقه كما يجب، وإلا لا يتخلّف المعلول عن علّته، فعدم وجود المعلول دليلٌ على عدم تحقّق علّته.
أمّا الإنسان المعاصر اليوم ـ ومنه الكثير من شباب المسلمين ـ فقد لا تقنعه هذه الطريقة كثيراً، ولو كانت في نفس الأمر والواقع حقّةً؛ لأنّ الإنسان المعاصر متأثر بالمنطق الوضعي الذي يحاكم القضايا على قدر آثارها الملموسة.
أمّا الطريقة الثانية، التي يفترض بالفكر الإسلامي أيضاً أن يشتغل عليها؛ إذ يمكن أن تخدم شأن الدين اليوم بالخصوص أكثر من الطريقة الأولى، وهي الطريقة التي نسميّها: طريقة استخدام المنطق الإحصائي في ملاحظة آثار الدين على حياة الإنسان. وهذه الطريقة منسجمة مع قواعد المنطق الوضعي، ولهذا فهي تستطيع إقناع المخاطب المعاصر.
ولكي نوضح الأمر نذكر مثالاً عن استخدام هذه الطريقة للإقناع: لنفرض أنّنا نريد أن نقنع الآخرين بأنّ الصيام في شهر رمضان المبارك له دورٌ كبير في تنمية المجتمع وتعاليه، فبدلاً من أن نستحضر الآيات القرآنية أو الروايات الشريفة، نذهب مباشرةً إلى أرض الواقع ونقوم بإحصاءات ميدانيّة لنرصد الآثار الإيجابيّة والسلبية لصيام شهر رمضان على المستوى الاجتماعي، وقد نصل إلى أنّ معدّل الجريمة في المجتمعات الإسلاميّة في شهر رمضان أقلّ من سائر الشهور؛ لأنّ الناس يعيشون في جوٍّ من التقوى والإيمان والدعاء والتوجّه إلى الله سبحانه، مما يخفض عندهم حالة اللامبالاة والعصيان لله سبحانه. إذا قمنا بهذا النوع من الإحصاءات والرصد الميداني لتأثيرات شهر رمضان على حياة المسلم أو المجتمع الإسلامي، فقد نجد الكثير من المعلومات التي قد لا ندركها نحن في حياتنا اليوميّة وانطباعاتنا الساذجة.
قراءة منفعيّة للدين من زاوية أخرى (الدور النفسي)
في الغرب، حتى بعض الملحدين والذين لا يؤمنون بالمسيحيّة نفسها، استخدموا الدين استخداماً براغماتيّاً (منفعياً)؛ فمنذ بدايات القرن العشرين، ظهر توجّهٌ في الغرب أعاد السؤال حول الدين بطريقةٍ أخرى: لماذا يجب أن نواجه الدين؟ إنّنا ومنذ القرن الخامس والسادس عشر نحارب الدين، ونحمِّله مسؤوليّة تخلّفنا، لكن مع ذلك لماذا نحاربه؟ دعونا نستفيد منه بشكلٍ أو بآخر. وسبب هذا التحوّل عندهم في الموقف من المسألة الدينيّة هو أنّهم لاحظوا أنّ المفاهيم والقيم الدينيّة تلعب دوراً إيجابيّاً في حياة الإنسان على بعض الصعد، وأهمّ دورٍ تلعبه هو الدور النفسي.
لقد لاحظ هؤلاء وغيرهم أنّ الدين يخفّف من آلام الإنسان التي تظهر إثر اصطدامه بالواقع أو احتكاكه به، فإذا تعرّض إنسانٌ غير متديّن لمشكلةٍ على أرض الواقع، كأن تُقطع رجله أو يُصاب بمرضٍ ما، فسوف تظهر عليه علائم الإحباط، والاكتئاب.. والكثير منهم يدخلون في أمراض نفسيّة صعبة، أما الإنسان المؤمن والمتديّن فإنّه يستطيع أن يتجاوز هذه المصائب بسهولة مستعيناً بالمفاهيم الدينيّة، فحينما يربط الدين بين مفهوم الأجر والثواب ومفهوم المصائب الدنيويّة فإنّه يستطيع أن يرفع ثقل وحمولة الواقع ويخفّف عن كاهل الإنسان الكثير من الهموم والغموم.. فعلى المستوى النفسي هذه المفاهيم عظيمة جداً لا يُستهان بها، ولو بصرف النظر عن واقعيّتها وحقانيّتها في نفسها.
إنّ هناك مفاهيم دينية كثيرة تلعب دوراً مهماً في تهدئة نفوس الناس وتخفّف من حالة الاحتقان النفسي الموجودة في المجتمع، وتقوِّي الشخصيّة لدى الإنسان، وهذا ما لمسه حتى الذين لا يؤمنون بالدين، فأرادوا أن يوظِّفوه في مجال الطبابة والراحة النفسيّة، بل حتى في مجال الشفاء النفسي.
مع ستيفن كوفي في تجربته
ولتوضيح الفكرة أكثر أذكر تجربة الشخصية الأميركيّة المشهورة ستيفن كوفي (2012م)، فقد كان يعتقد بأنّ الدين من شأنه أن يحلّ لنا الكثير من مشاكلنا النفسيّة والسلوكيّة، خاصّة تلك الشائعة في الغرب وكانت من ضرائب الحداثة والتكنولوجيا، والتي بدأت تنتشر مؤخّراً في البلدان الإسلاميّة أيضاً، مثل الانتحار، والإحباط، والاكتئاب، والفراغ، والغربة، واللاانتماء، والعبثيّة، والعدميّة، وانعدام الثقة، والشكوكيّة، والتسابق مع الزمن، وغير ذلك.
يبدو أن ستيفن كوفي ـ وهو الحائز على دكتوراه في التعليم الديني ـ كان يعتقد أنّ الدين بإمكانه أن يحلّ لنا بعضاً من هذه المشاكل النفسيّة، فاستخدم بعض مفاهيمه ومقولاته في هذا السبيل، دون تحويل خطابه إلى خطاب ديني مباشر، مبتكراً (نظريّة التحكّم بالذات أو بناء الذات)، وألّف كتاباً أسماه (العادات السبع للناس الأكثر فعاليّة)، ثم بعد عشرين سنة (بدايات الألفيّة الثالثة) ألّف كتاباً أسماه (العادة الثامنة من الفعالية إلى العظمة)، ويتضمّنان دورةً تدريبية على بناء النفس في مجال العمل الإداري والوظائف وفي مجال مواجهة أزمات الحياة المعاصرة.
حينما نقرأ هذين الكتابين الرائجين رواجاً كبيراً، والمترجمَين إلى عشرات اللغات، ربما لا نكاد نجد فيهما ـ من وجهة نظري الشخصيّة ـ سوى المفاهيم الدينيّة التي تشكّل بنية الأفكار العمدة فيهما، دون أن نستهدف بكلامنا هذا نوعاً من الدعاية أو الترويج للدين، بل نقصد توصيف الأشياء على ما هي عليه فيما نراه، ممّا يكشف عن أنّ ثمّة فكرة كامنة عنده أو تلاقٍ واضح لديه في أنّ الدين قادر على المشاركة في علاج أو الوقاية من العديد من المشاكل النفسيّة لعصرنا الحديث.
إذا قرأنا هذين الكتابين، نجد أنّ أكثر من 90% من المفاهيم الموجودة فيهما موجودةٌ حقّاً في الكتاب والسنّة وفي تراث علماء أخلاق المسلمين والتراث المديني المسيحي واليهودي، كلّ ما في الأمر أنّه حوّل هذه المفاهيم الأخلاقيّة والتربويّة إلى قواعد للعمل الإداري، وإلى قواعد نفسية لبناء الذات بطريقة حديثة مبتكرة، بدل أن تبقى شبه مشلولة بالطريقة التي قدّمها السابقون وغير قادرة على التأثير ـ بالشكل التي هي عليه ـ في عصرنا الحاضر.
مفهوم الآخرة ودوره في مواجهة الأزمات
يمتاز هذان الكتابان ـ وأمثالهما ـ بلغتهما السهلة، وبالتنظيم القصصي الواقعي الذي ينتهي بقواعد في العمل الإداري والعلاج النفسي، ولو أردنا أن نأخذ مثالاً هنا، أمكن الحديث عن مسألة العلاقة الجدليّة بين المشاكل والتصوّرات المسبقة عنها، فليست المشكلة هي التي تؤثر دوماً على نفسيّة الإنسان، بل هي تصوّراتنا المسبقة التي تفسح للمشكلة أن تحطِّمنا أو تفرض عليها التراجع. فإذا كنت أعتقد بأنّ كلّ همّي في الحياة هو أن أصبح رئيساً للمركز الفلاني أو المؤسّسة الفلانية ولم أنجح، فمن الطبيعي أنّ فشلي هذا سوف يترك تأثيراً كبيراً على نفسيّتي، وسأصاب بالاكتئاب، والإحباط، وضعف الشخصيّة، وفقدان الثقة بالنفس.. أمّا إذا اعتبرتُ حياتي الدنيويّة جزءاً من حياةٍ طويلة ـ آخذاً بعين الاعتبار الحياة بعد الموت ـ ونظرت إلى هذه المشكلة من الأعلى، فسوف تصغر المشكلة بالنسبة إليّ، وسأرى أنّ هناك خطّاً طويلاً جداً من العمر، وأنّ الحياة الدنيا إنّما هي جزءٌ بسيط من هذه الحياة الطويلة، هذا شيء طبيعي جداً، يمثل معادلة منطقيّة بسيطة لا يحتاج فهمها إلى تكلّف وعناء.

(العلاقة الجدلية بين المشاكل والتصوّرات المسبقة عنها)
إذن، كلّما وسّعنا أفقنا في قراءة الحياة، ورأينا أنّ هناك حياةً خالدة بعد الموت، استطعنا أن نتجاوز المشاكل بقدرة أعلى؛ لأنّها تصغر بشكل تلقائي بالنسبة إلى هذه الحياة الطويلة، وكلّما ضيّقنا اُفقنا في قراءة الحياة، ولم نرَ إلا هذه الحياة الدنيا، فلا نستطيع أن نتجاوز المشاكل إلا بصعوبة عالية؛ لأنّها سوف تكبر وتحطّم شخصيّتنا وثقتنا بأنفسنا.
وبهذا نعرف أنّ لدينا القدرة على أن نتحكّم بمشاكلنا العميقة مستعينين بالمفاهيم والتربية الدينيّة، من هنا يملك الإنسان المؤمن قدرة تجاوز الأزمات؛ لأنّه يملك شخصيّةً قويّة. ولا نريد أن نحصر الحلول والعلاجات بالمفاهيم والتربية الدينيّة السليمة، بل نهدف هنا للكشف عن العلاقة الإيجابيّة بين الأمرين دون أن نحذف خيارات أخَر أو أساليب أخَر مخارجة للدين، قد يمكنها أن توصل الإنسان للسلامة الروحيّة والنفسيّة، فهذا ليس محلّ بحثنا هنا، علماً أنّنا لا نريد أيضاً أن نزجّ رؤوسنا في الرمال كي لا نرصد التأثيرات السلبيّة أحياناً لمفهوم ديني هنا أو هناك.
كما لا نقصد بالدين هنا الجانب الاعتقادي الذهني أو الجانب الشرعي الفقهي المتصل بخصوص علاقات الإنسان بغيره بما هو جسد غالباً، بل نذهب إلى الحديث عن الدين بما هو رحلة أخلاقيّة وروحيّة، بحيث يصبح مفهوم الآخرة تجربة معنويّة تربويّة، وليس مجرّد فكرةٍ ذهنيّة خالصة، وندّعي بأنّ الأنبياء جاؤوا لأجل هذا النوع من البناء العقدي في حياة البشر، لا لمجرّد العقائد الخبريّة، كما هي الصورة التي ربما تستوحى من نتاج الكثير من علماء الفلسفة والكلام.
نحو عودةٍ للتراث الديني بحثاً عن قواعد تذويب الأزمات الداخليّة
فكرتنا هنا هي العودة إلى التراث الديني؛ بحثاً عن مثل هذه القواعد التي تساعدنا للخروج عن المشاكل والأزمات، وعلى سبيل المثال هناك مفهوم ديني ـ أخلاقي يساعدنا كثيراً في رفع العداوة والحساسية النفسيّة في العلاقات الاجتماعيّة، حيث قال الله تعالى في قرآنه الحكيم: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ ولاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت: 34)، وكذلك ورد في السنّة الشريفة: (صِل منَ قطَعَك)[2]، فإذا واجهنا مشكلةً في علاقتنا بالآخرين، فإنّ بمقدورنا أن نخرج بسهولة وبسلام من هذه المشكلة مستعينين بهذا المفهوم الديني، وبدل أن نعاني من حساسيةٍ نفسيّة تجاه الآخرين، نرتاح من المشكلة النفسية، بل نستطيع أن نحوّلها إلى حلّ ليصبح وليّاً حميماً لنا.
إذن، لو نظرنا في مفاهيمنا الدينية، فنحن نملك مصادر غنيّة من القواعد والحلول للخروج من الكثير من أزمات الحياة النفسيّة والروحيّة، لكن المهم توظيف هذا القواعد، وكيفيّة استخراجها وإعادة تنظيمها وتقديمها لإنسان العصر الحديث.
ومن اللازم عليَّ هنا أن أؤكّد أنّنا لا ندّعي الشموليّة، ولا ندّعي الحصريّة، ولا ندّعي أنّ كلّ صغيرةٍ وكبيرة فسبيل حلّها هو التراث الدينيّ فقط وفقط، وأنّه لا دور للعلوم الإنسانيّة والطبيعية الأخرى هنا، كلّ ما في الأمر هو المشاركة الدينيّة في علاج أزمات الإنسان المعاصر للذهاب به نحو حياة معنويّة وروحيّة أكثر سلامة وسعادة، بمفهومٍ مترقٍّ للسعادة لا يهبط بها أو يتسافل.
في الفترة الأخيرة، نجد توجّهاً ملحوظاً نحو علم الأخلاق والعرفان؛ لأنّ الناس يجدون في العرفان والأخلاق حالةً من الراحة النفسيّة، البكاء وحده حالة من الراحة، البكاء في مناجاة أو في دعاء أو في مجلس عزاء أو ما شابه ذلك، هذا نوع من التنفيس للاحتقان الداخلي الأمر الذي يؤدّي إلى الراحة النفسيّة، طبعاً كلّ شيء مع الاعتدال ـ بلا إفراط ولا تفريط ـ في البكاء والضحك وغيرهما.
إذا استطاع شخصٌ أن يوظّف بعض المفاهيم في الديانة المسيحيّة ويحوّلها إلى مدرسة فكرية في الغرب، فإنّ بإمكاننا في التجربة الإسلاميّة أن نقوم بمثل ذلك؛ لأنّ تراثنا الإسلامي ثريٌّ بمثل هذه المفاهيم. لكنّ التحدّي الأكبر يكمن في إعادة توظيف هذه المفاهيم بهدف تقديمها كعلاجات لإنسان اليوم، عبر فهمه وفهم قضاياه بدقّة، وتجريد المفاهيم من حرفيّتها التاريخيّة؛ لاقتناص رسالتها المركزيّة.
إنّنا نواجه اليوم أزماتٍ اجتماعيّة وتربويّة، وعلى المؤسّسة الدينية تحمّل المسؤوليّة إلى جانب سائر الأطياف في المجتمع، والله وليّ التوفيق.
الهوامش
_____________________
[1] محاضرة ألقيت في مجمع الاتجاه القرآني في إيران، عام 2007م.
[2] هذا التعبير ورد في رواية طويلة نقلها الشيخ الصدوق في (كتاب من لا يحضره الفقيه 4: 177 ـ 179)، وکذلک نقلها المحدّث النوري عن تحف العقول في (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل 9: 11).