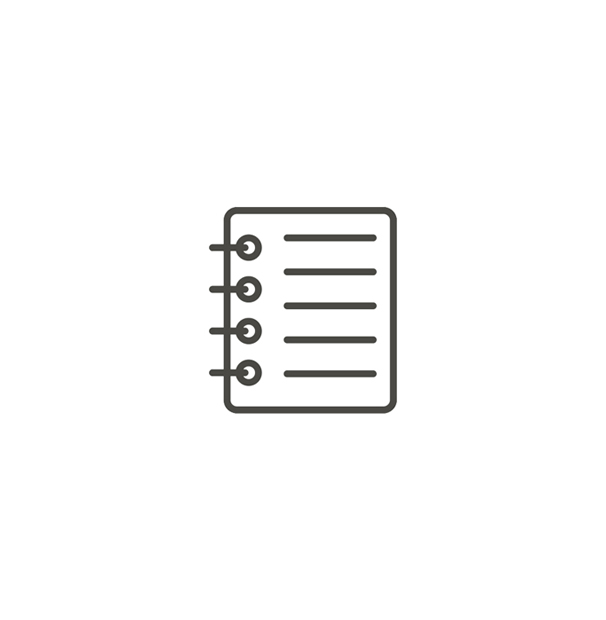جوهر البحث وملخصه العام
كثيرٌ من المفكّرين والنّخب ورجالات الدّين كتبوا (ويكتبونَ) عن الأخلاق وأهميتها ودورها، ودعوا (ويدعون) لتربيةِ الأجيال وإصلاحِ الفرد أولاً بالارتكاز على الأخلاق، لأنّ الفردَ ـ في نظرهم ومعتقدهم الأيديولوجي ـ أساس أي إصلاح وتغيير ونهضة وتطور مجتمعي، وهو كلام صحيح نظرياً، فالأخلاق والقيم جوهر التربية وتنشئة الفرد في سياق عائلته ومجتمعه.. ولكنه عملياً كلام مغلوط وتحليل غير واقعي ومثالي، ولم تعرف البشرية له سبيلاً في تاريخها كله منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل… فالفردُ مجبولٌ على حبِّ الذّات والمَصلحة الخاصة، وعنده حاجاتٌ أساسية يجب تحقيقها وتلبيتها والاستجابة لها.. ولا توجدُ أية آلية حقيقية وواقعية وعملية لتحقيق ذلك سوى بناء أرضية قوية ورصينة للحقوق والعدالة، بمعاييرها وحدودها الأساسية المعقولة.. من هنا يأتي قولنا أن الحقوق أهم من الأخلاق بل ومتقدّمة عليها في سياق البناء المجتمعي الناظر للتقدم والإنتاج والازدهار.
والحقوق عند إنجازها هي التي تربّي الفردَ وتُصلحُه وتَسيرُ به على طريق الأخلاق والفضائل الحميدة.. بمعنى أنها تحرّض فيه الوازع الأخلاقي..
فالحقوق أولاً وثانياً وثالثاً، ومن ثم الأحكام والقوانين والأخلاقيات.. ولنكفّ في أفكارنا وآليات تعاطينا مع المسألة الأخلاقية عن تبنّي مثاليات ورومانسيات فكرية أيديولوجية (دينية وغير دينية) لا علاقة لها بالنفس والحياة والواقع البشري والوعي الديني المسؤول..!!.
مقدّمة البحث
لا يمكن فصل الأخلاق عن الحقوق، فهما مرتبطان ببعضهما ارتباطاً شبه عضوي.. فالأخلاق كقواعد للسلوك البشري، وكقيم مطلوب من الإنسان السير في ضوئها على صعيد علاقاته وتعاملاته الخاصة والعامة، لا يمكن تحريكها بفعالية منتجة في حركة الفرد والمجتمع وصولاً للازدهار الفردي والمجتمعي، من دون أرضية ملائمة قوية وصلبة من الحقوق الفردية المجسّدة والمصانة كأنظمة قانونية مضمونة وحاكمة، تنطلق من الإقرار بأهمية وجود الفرد كأساس ومحور في الوجود كله..
وهذا يأتي كجزء أساسي من وظيفة الدولة، حيثُ أن الإنسان الفرد هو جوهر بناء هذه الدولة، لتكون عملية تأمين حقوقه هدفاً وغاية عليا لعملها ووظيفتها.. وهذا التأمين الحقوقي إذا صح التعبير هو الذي يضمن تنفيذ وتحقق الفضائل والكمالات الأخلاقية بصورة تكاملية على صعيد صناعة فرد منتج وقادر على القيام بدوره في إنتاجية المجتمع ككل والإسهام الفاعل في تطويره وازدهاره.. لأن الإنسان الحاصل على حقوقه في مجتمعات العدل والمساواة والكرامة الإنسانية هو الأكثر اندفاعاً لتمثل معايير القواعد الأخلاقية فيه.. وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأخلاقي والسلوكي في المجتمع..
وهذا ما سنحاول تسليط الضوء الفكري عليه في مجمل البحث القادم..
المبحثُ الأوّلُ: في معنى الأخلاق والحُقوق، لغوياً واصطلاحياً
أوّلاً: الأخلاق لغوياً واصطلاحياً
معنى الأخلاق لغةً
الأخلاق جمع خُلُق (بضمِّ الخاء واللام)، والخُلُق هو الدِّينُ والطّبع والسّجية والمروءة؛ وحقيقته أنّ صورة الإنسان الباطنة ـ وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها ـ بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها([2]). قال الرَّاغب الأصفهاني: «والخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل واحد… لكن خصَّ الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخصَّ الخُلْق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة»([3]).
ويُقالُ: خالِصِ المؤمن وخالِقِ الفاجر، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثوابُ والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنيَّة أكثر ممَّا يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة، ولهذا تكرَّرت الأحاديث في مَدح حُسن الخلق في غير موضع([4]).
معنى الأخلاق اصطلاحاً
تحدّثَ الجرجاني في تعريفاته عن الخلق قائلاً: بأنَّه «عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدرُ عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجةٍ إلى فكرٍ ورويَّة، فإنْ كانَ الصّادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقاً حسناً»([5]).
وعرف ابن مسكويه الخلق بأنه «حالٌ للنفسِ، داعية لها إلى أفعالها من غيرِ فكر ولا رويَّة.. وهذه الحالُ تنقسمُ إلى قسمين: منها ما يكونُ طبيعيّاً من أصلِ المزاج، (كالإنسان الذي يحرّكه أدنى شيء نحو غضب، ويهيج من أقل سبب، وكالإنسان الذي يجبنُ من أيسر شيء، أو كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه، أو يرتاع من خبر يسمعه، وكالذي يضحكُ ضحكاً مفرطاً من أدنى شيء يعجبه، وكالذي يغتمُّ ويحزن من أيسر شيء يناله)؛ ومنها ما يكونُ مستفاداً بالعادة والتّدرُّب، وربما كانَ مبدؤه بالرويَّة والفكر، ثم يستمرُ أولاُ فأولاً، حتى يصيرَ مَلَكَةً وخلقاً»([6]).
والملكة هي كيفية نفسانية بطيئة الزوال، بينما الحال هي كيفية نفسانية سريعة الزوال([7])، اتفق ابن مسكويه وابن سينا على أنّ الخلق كيفية وهيئة راسخة تخصُّ النفس، واختلفا في درجة زواله عنها هل هي بطيئة أم سريعة.. ولعلّ الاختلاف نجمَ عن لحاظ تمكن الخلق في النفس، فإنْ كان في أول درجات التمكن فيها، بحيث يزول سريعاً، كمن يتدرب على فعل الكرم وحسن الظن بالآخرين، فإنه يزول سريعة في الأيام الأولى فيكون حالاً، بينما مع تقادم الأيام وتوالي التمرين وكثرة الممارسة، فيترسخ لديه هذا الفعل حتى يصبح ملكة.
كما عرّف بعضُ الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأنها عبارة عن مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، التي يحددها الوحي، لتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحوٍ يحققُ الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه([8]).. كما عرفوها بشكل عام من حيث أنها فرع من فروع الفلسفة التي تدرسُ السلوكَ البشري من وجهة نظر الصواب والخطأ، الخير والشر، السعادة والواجب.. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن البحث عن أنظمة القيم التي تدعم هذه المفاهيم.. وبالعموم يشيرُ مفهوم الأخلاق إلى جُملة من المبادئ «Principes» أو المعايير «Normes» المتعلقة بالخير والشر، والتي تتيح إمكانيَّة النظر في الأفعال الإنسانيَّة، ومن ثم الحكم عليها بالقبول وعدم القبول؛ فهذه المعايير بمثابة نواميس كونيَّة، تنطبق على كل الأفراد من دون استثناء، على الرغم من اختلاف المجتمع الذي ينتمون إليه؛ لأنَّ أساسها كوني وليس خصوصياً([9]).
ثانياً: الحقوق لغوياً واصطلاحياً
الحق في اللغة مشتق من الجذر (ح، ق، ق)، تقول «حق الأمر يحق»، بكسر الحاء وضمها في المضارع، حقاً أي ثبت ووجب، والحقّ هو الثابت واللائق والصحيح، والأمر المتحقق وقوعه، والحقيقة في العُرف هي مطابقة الاعتقاد للواقع.. وفُسِّر الحق عند أهل اللغة تارة بأنه خلاف الباطل، وتارة بمعنى الوجوب والثبوت، والظاهر أن الثاني نتيجة تلقائية للأول.. فقد قالَ صاحبُ المقاييس «حقّ: الحاء والقاف أصلٌ واحد، وهو يدلُّ على إحكام الشيء وصحته، فالحقُّ نقيضُ الباطل»، ثم قال «ويُقال حقَّ الشيء: وجب»([10]). وهكذا قال المصباح «الحق خلاف الباطل»، ثم قال «وهو مصدر حقّ الشيءُ من بابي ضرب وقتل إذا وجب وثبت،… وحققتُ الأمر أُحِقُّه إذا تيقّنته أو جعلته ثابتاً لازماً»([11]).
نعم إن مفهوم الحق في اللغة العربية يتداخل في أحيان كثيرة مع لفظ الواجب.. أي هو يشير إلى حق الشيء إذا ثبت ووجب، فأصل معناه لغوياً هو الثبوت والوجوب، وهو مصدر الفعل حقّ، وجمعه حقوق أو حقاق.. وكذلك فالحق يُطلق على المال والملك الموجود الثابت، ومعنى حق الشيء وقع ووجب بلا شك([12]).
وأما الحق اصطلاحاً، فهو يختلف بين النظرة الدينية والنظرة العلمانية أو الوضعية.. فالبعض يرى أن الحق سلطة أو قدرة إرادية يتحصّلها الشخص من القانون الوضعي البشري.. أي أنه سلطة يمنحها القانون لشخص يتمتع بالإرادة([13]).. وهناك بعض آخر يعتبر الحق مصلحة يجب تنفيذها برعاية القانون وحمايته، حيث يتم النظر للحق هنا من خلال موضوعه، وليس من خلال صاحبه([14]).. وهناك خط ثالث يعتبر الحق إرادة ومصلحة بالوقت نفسه.. وخط رابع يعتبر أن الحق استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه ويرعاه([15]).
المبحثُ الثّاني: الأخلاقُ والاستقرارُ الأخلاقي في الإسلام
أولاً: الأخلاقُ في المنظورِ الإسلامي (منبعُها ومصدرُها، وأفقها)
ركزَ الإسلامُ في بنيته الاعتقادية والمعرفية والدعوتية على القيم الأخلاقية كأصلٍ ثابت وراسخ، وسعى في كل منطلقاته وأدبياته الفكرية والروحية إلى صياغة الإنسان المسلم الأخلاقي في روحه وسلوكه، ومختلف علاقاته الخاصة والعامة، وذلك بالاستناد على مرجعية الأخلاق والفضائل الأخلاقية الإسلامية التي لا تتغير تبعاً لظروف الزمان ومستجدات الحياة وتطوراتها، بل تبقى ثابتة لا يطالها أي تبدل في محتواها الذاتي، لأنها بالأساس نابعة من الله تعالى خالق الوجود وعلة الخلْق.. فالأخلاق إذاً هي جوهر الإسلام وروحه، والنظام التشريعي الإسلامي هو كيان وهيكل قانوني عملي مُجسِّد لهذه الروح الأخلاقية التي لها ـ كمنظومة قيمية ـ حضور واسع وتأثير بليغ في كافة مجالات وجوانب عقيدة المسلم وشريعته، وحتى تلك الآيات والأحاديث المتعلقة بالعقائد والأحكام والقصص، نجدها مليئة ومشبعة بالمعاني والتوجيهات الخلقية..
ويعود سبب تركيز الإسلام على البعد الأخلاقي، ودعوته لتمكين القيم الأخلاقية في سيرورة الفعل الاجتماعي كمحور للعلاقات ومرجعية للتفاعلات البشرية ذاتياً وموضوعياً، إلى كونه يدرك أن دوام الحياة الاجتماعية وتقدمها وازدهارها ـ وعيش الإنسان الآمن والمستقر فيها على نحوٍ وارعٍ ومسؤول وغائي ـ مرهون بإضفاء معنى حقيقي مستمر على أفعالنا الخلقية المجردة عن المصلحة المادية لا ينتمي إلى عالم المادة المرئي، وهو معنى الإيمان بالله كعلة للكون والحياة.. وذلك كمقدمة ومرجعية لبناء نظام أخلاقي يحقق الإنسان من خلاله حاجته، ويحول دون ميوله ونزعاته الشريرة ويوجّهه إلى استخدام قواه في مجالات يعودُ نفعها عليه وعلى غيره.. ولو أنّه جرى إهمال هذا الجانب القيمي الأخلاقي بما فيه من مبادئ وقيم وفضائل وشمائل، من حياة الفرد والمجتمع، فإنه سيتحوّلُ إلى مجتمع غابة جحيمي، تسوده أفعال التوحش وتتفشى فيه المظالم وسلوكيات التجبر والأنانية والانتقام والخيانة والغش والكذب وسفك الدماء، لتتلاشى الإنسانية والبعد الإنساني الغائي في علاقات الناس ببعضهم، فلا مودة ولا محبة ولا تفاعل إنساني ولا تراحم ولا إخلاص.. وقد أثبتت الأيام والدهور أن الإنسان عاجز لوحده بفكره ومعتقداته ومبادئه «الأخلاقية» الأرضية الوضعية التي علت وتعلو فيها الأخلاقيات العملية النفعية الذرائعية، عن قيادة سفينة البشرية، إلى شواطئ الأمانِ والاستقرار والسلامة، وتحقق مبادئ الحق والعدل.. والسبب أنها ليست مبادئ وأخلاقيات نابعة من الله تعالى محور الوجود والحياة، والتي هي أخلاق مسؤولة تربط الوعي الأخلاقي السلوكي بالإيمان الاعتقادي بخالق مطلق مفارق بطبيعته، وينتصب كغاية يتطلع الإنسان إليها، ويسعى بكل جوارحه لتمثل قيمها وصفاتها عملياً في عملية كدحٍ حياتي ارتقائي نحوه تعالى، يقول عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ..﴾ (الانشقاق: 6).. فكل إنسان ـ المؤمن والكافر، المحسن والمسيء ـ سوف يصير إليه تعالى ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ﴾ (البقرة: 156) باعتباره هو جوهر ومهيار الوجود بل هو حقيقته الكبرى التي تقتضي حكمته وجود هدف سام ومنظور راقٍ للخَلْق بصورة عامة، وللإنسان بصورة خاصة.. وهذه الحقيقة الإلهية حقيقة فاعلة في هذا الوجود، وتلتمس خصائصها وصفاتها ـ التي تكدح نحوها في عملية ارتقاء ـ في آثارها الواقعية في هذا الوجود، وهذا ما يفصله القرآن الكريم، وهو يصف الحقيقة الإلهية للناس، وهو يعرّفهم بربهم تعريفاً يسيراً عميقاً واضحاً، وهو يستشهد بواقع الكون وواقع الناس في منطق فطري واقعي جميل([16]).. بما يعني أن الإنسان بكل وجوده ـ المادي والروحي والفكري ـ رهين ذلك الإله الواحد، ومحاط بآثار قدرته وعظيم نعمته ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ..﴾ (فصلت: 53).. وبالتالي يجب عليه القيام بواجباته تجاه هذا الخالق، والالتزام بمقتضيات هذا الوجوب، وعلى رأسها القيام بالعبادة ﴿ومَاْ خَلقتُ الجِنَّ والإنْسَ إلا ليَعْبِدونِ﴾ (الأنبياء/16)، ووظائف العبودية ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل: 49).. وهذا النظام العبادي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي الموضوع من قبل الخالق عز وجل كمنهج عمل، والمطلوب من الإنسان العبد الالتزام به في حركة حياته الخاصة والعامة، وصولاً لتحقيق غاية الوجود ومعنى الخلق، هو الأكمل والأوفق بحقيقة الإنسان، والأشد توافقاً وانسجاماً مع الهدف من خلقه، ومع الغاية التي هو منته إليها.. بما يضمن تحقيق الكمال والسعادة لهذا الإنسان بعد أن يحقق طبعاً متطلبات وشرائط كونه خليفة الله في الأرض على المستوى الأخلاقي والقيمي والعبادي وغيرها..
وهنا ـ بهذا المعنى ـ لا تكونُ الأخلاق مؤسَّسة أو مفسّرة بواسطة السببية التي تجعلها نسبية محدودة مشدودة إلى الأرض والواقع بما فيه من محددات وشرائط نسبية مرهونة للإنسان، وخاضعة لتصوراته الجزئية، وإنما تكون مؤسَّسة ومبنية ومفسّرة بالغائية المتعلقة بالمفارق الكامل والمتعالي والمطلق الذي هو الله تعالى واجب الوجود وبالتالي واجب العبادة والعبودية والخضوع.. وكل الأنبياء والرسل في كل حركة التاريخ رفعوا ألوية الأخلاق مقرونة بالاعتقاد الديني انطلاقاً من إيمانهم بأن الدين هو أقوى سند للأخلاق والقيم الأخلاقية وللمعايير الخلقية.. وأيضاً انطلاقاً من كون الفطرة الإنسانية مصدراً للأخلاق ومنبعاً للفضائل.. ولكن الفطرة قد تنحرف في واقع الحياة والتطورات الحياتية والمجتمعية، وهنا يأتي الدين ليحذر وينبه ويحاول إعادتها إلى سكة التوازن الأخلاقي..
نعم، إن الإنسان ـ في فطرته وجبلته الذاتية ـ مفطور على حب الأخلاق الحسنة وما يصدر منها، وكره الأخلاق السيئة وما يتفرع عنها.. ومهما اختلف الناس ـ أفراداً أو أمماً ـ في تقييم بعض الأفعال وبعض التصرفات، فإنَّ هناك فضائل وأخلاقا يشتركون جميعاً في حبها واحترامها، كالصدق والأمانة والوفاء والإحسان والتواضع والعدل.. وهناك رذائل وأخلاق سيئة يشترك الناس جميعاً في كراهيتها واستهجانها، كالظلم والعدوان والكبر والكذب والخيانة والأثرة والغدر.. فاشتراك الناس ـ بمختلف أجناسهم وأديانهم وأوطانهم وعصورهم وطبقاتهم وأحوالهم ـ في هذه الميول الخلقية، وتجذُّرُها في نفوسهم وسلوكهم، دليلٌ واضح على فطريتها وأصالتها فيهم.. فللإنسان حاسة خلقية تعمل مثل حواسه الأخرى. بل إن هذه الحاسة الخلقية تعتبر من الحواس المميزة للإنسان. ولذلك وُصف الإنسان بأنه «كائن أخلاقي»، أو «حيوان أخلاقي». بل يمكن أن يقال: إن الإنسان هو الكائن الأخلاقي الوحيد، باعتبار أن الإنسان لا يكون إنساناً مميزاً من سائر الكائنات، بغير مَثل أعلى يَدين له بالولاء([17]).
والأخلاقُ هنا بالمعنى الديني وبالذات الإسلامي، (وحيث أن الإسلام هو دين الأخلاق ورسالته رسالة إتمام الأخلاق([18])، والله تعالى امتدح رسوله واصفاً إياه بأنه على خُلُق عظيم([19]))، تأتي لتكون أخلاق الشريعة والعقيدة والفكر، وتتميز بالعطاء والبذل، وتحمل في طياتها مكارم الأخلاق.. وهي تأتي أيضاً لتكون كجرس إنذار أو كمنظم للسلوك والغرائز، ومجمل القوى الشهوية والغضبية عند الإنسان، التي إذا ما هيمنت واستحكمت، دفعت الإنسان لارتكاب الفواحش وأغرقته بالخطايا، ودفعته للفوضى والعبثية الحياتية.. وكما أنّ الطب (من خلال قوانينه ومعادلاته وأدويته و…، إلخ) يعمل على تنظيم قوى البدن المادية، فإنّ الأخلاق تقوم بتنظيم قوى الروح.. وكما أنّ الطبَ ليس أساسه الحسن والقبح العقليين، كذلك الأخلاق ليس أساسها الحسن والقبح العقليين. فالإنسانُ له قوى روحية، له غرائز، ولكل قوة منها تكاليف ينبغي على الإنسان أن يعرفها ويغذيها بمقدار حاجتها، دون إفراط أو تفريط، كما يفعل مع بدنه.. وإن أهمل قواه الروحية، وذلك بأن أعطى لبعضها أكثر من حاجتها وأنقص نصيب الأخرى، وتركها جائعة، فهنا سيحدث الاختلاف والاضطراب، وهذا هو ما يدعى بالأمراض الروحية (العقد النفسية).. وهذا الأمر لا يحتاجُ إلى أن يُبحث، هل أنه ـ عقلاً ـ حسن أم قبيح؟! لأن أساس الأخلاق سلامة الروح.. فأساسُ الأخلاق عند الإنسان أن تكون إرادته قوية، بمعنى أن تكون إرادته متغلبة على عادته، وعلى طبيعته، فلو شخّص مثلاً: أن الصلاة هي أحد التكاليف الشرعية التي تجلب له الخير في حياته الدنيوية والأخروية، فإن هذا الإنسان يستطيع أن ينهض وقت السحر لأداء الصلاة وتلاوة الدعاء، والاستغفار، والتضرع إلى الله، فينهض بسرعة، ولكن طبيعته ستقول له: نَم واسترح، وهو لا زال مأخوذاً بالنعاس، ويريد أن يستلذ بالنوم.. فها هنا إذا كانت إرادته قوية، فإنها حتماً ستتغلب على طبيعته، وينهض فوراً، ويشرع بأداء عبادته([20])..
إنّ الأخلاقَ التي يدعو إليها الدين هي نفسها أخلاق الفطرة، لأنّ الفطرة السليمة من عند الله، ولكن الدين أقوى في الإسناد والدعم وترسيخ العمل بمعايير الأخلاق والسلوك الأخلاقي، وهو أيضاً أقوى حتى من أخلاقيات القيم والأعراف القيمية الاجتماعية التي تتشكل في أي مجتمع، وتصبح محل تراض وتوافق عام بين أبنائه، يحترمونها ويجلونها وتصبح منظومة أخلاقية قانونية لهم..
وحتى عندما ينظمُ أيّ مجتمعٍ سلوكيات أفراده وعلاقاتهم الذاتية والموضوعية بالاستناد على تلك القواعد الأخلاقية القادمة من التقاليد الأهلية والأعراف الاجتماعية، فإنه لا يمكنهُ الاستغناء مطلقاً عن قيم وأخلاقيات المصدر الديني كداعم في التطبيقات الأخلاقية العملية على مستوى نظم العلاقات والتفاعلات بين الناس؛ والسببُ يعودُ إلى كون تلك الأخلاق العُرفية ـ إذا صح التعبير ـ لها في الأساس استمدادٌ من المصدرين السابقين وتأثر بهما، ولكنها تستمد صِـيَغَها العملية وتعبيراتها الظرفية، من الفكر والثقافة والتجربة البشرية. فهي ـ من هذه الناحية ـ تجسّدُ الخصوصية الأخلاقية للأمم والشعوب، وللعهود والأحقاب التاريخية. ولذلك نجدها أكثر قابلية للاختلاف والتمايز بين الأمم، وأكثر خضوعاً للتغير عبر العصور، ولو بتدرجٍ بطيء في الغالب.. ويُرجِع الماوردي تشَكُّل الأخلاق وانبثاقها إلى أصلين هما الطبع والتطبع؛ فالأخلاق بعضها خُلق مطبوع، وبعضها خلق مصنوع؛ لأن الخلق طبع وغريزة، والتخلق تطبع وتكلف.. فتصيرُ الأخلاقُ نوعين: غريزية طُبع عليها، ومكتسبة تَطَبَّع بها([21]).. على أن الأخلاق بنوعيها لا تستغني عن المعالجة والرعاية والصيانة. قال بعض الحكماء: ليس شيء عولج إلا نفع وإنْ كانَ ضاراً، ولا شيء أهمل إلا ضرَّ وإنْ كان نافعاً([22]).
وعند الحديث عن الأخلاق في الواقع المتحرك، علينا أن نميِّز بين وجهين للأخلاق؛ أحدهما نظري، والآخر عملي؛ فالأول يضع الأسس والمبادئ والنظريات التي يستنِد إليها السلوك الإنساني، والثاني عملي يَبحث في التطبيقات العملية لهذا السلوك، داخل كيان عيني محدد.
يعني يجب أن نفرق بين شكلين أو نمطين للأخلاق، الأخلاق الثابتة (الأصول والقيم والمبادئ العليا)، والأخلاق المتحركة (الخاضعة لتوافقات الواقع)، فالثابتة هي القيم الأصيلة التي تعتمد عليها الحياة، ولا بد منها في كل زمان ومكان، مثل: الصدق، الأمانة، العفة، العدل، المساواة، الحرية.. وما شابهها.
أما الأخلاق المتحركة فهي ليست مبادئ ثابتة بل متحركة بحسب الزمان والمكان، لأنها تمثل نهج العلاقات الاجتماعية، وطريقة ممارسة الحياة وتطورها.. فأسلوب الاحترام أو التعبير أو إدارة العلاقات السياسية أو الاجتماعية يختلف من عصر إلى آخر.. نعم، القيم والمبادئ العليا ثابتة، ولكنّ تحريكها وتطبيقها وتمثلها كمناهج عمل هو المتغير..
إن الأخلاق الثابتة هي القيم الأصيلة التي تتصل بأصل وجود الإنسان في هذه الحياة، في إيمانه بواجب الوجود وانفتاحه عليه في صفاته وقيمه (نظرية الكدح الارتقائي)([23])، وفطرته على قيم وصفات المثال الأعلى، وهي التي تعتمد عليها كل متعلقات حركية الوجود الإنساني في الحياة بكل مواقعها وامتداداتها، ولا بد منها في كل زمان ومكان دونما أي تغيير في بنيتها ومعانيها وجوهرانيتها.. إنها في النهاية قيم الله تعالى، خالق الحياة والوجود، التي طالب البشر بتمثلها وتطبيقها في واقعهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم ومختلف فعاليتهم الوجودية في مستوى الذات والموضوع، مثل: الصدق، الأمانة، العفة، العدل، المساواة، الحرية، وما شابهها، فهي قيم وأفكار صالحة دائماً أبداً، طالما هناك وجود بشري، لأنها ترتبط كما قلنا بالمطلق والنموذج والمثال الأعلى المرتفع الذي هو الله تعالى علة الوجود والخلق والحياة.. فالله تعالى هو أصل الأخلاق وجذرها، لأنه المثال الأعلى والنموذج المرتفع للإنسانية جمعاء في كل حركة وجودها الزمانية والمكانية، لأنه الخالق والعاطي والعلة المطلقة.. وأما الأخلاق المتحركة فهي ليست مبادئ ثابتة، بل ظلال القيم في حركة التطبيق، أي هي سلوكيات ومناهج عمل متحركة بحسب الزمان والمكان، لأنها تمثل نهج العلاقات الاجتماعية وطريقة ممارسة الحياة وتطورها، فأسلوب الاحترام أو التعبير أو إدارة العلاقات السياسية أو الاجتماعية يختلف من عصر إلى آخر.
القيم والمبادئ العليا ثابتة، أما تحريكها وتطبيقها وتمثلها كمناهج عمل فهو المتغير.. مثال: الصدق، قيمة ايجابية مطلوبة دوماً؛ هذا نظرياً، لكنك ـ في الاطار العملي التطبيقي ـ لا تستطيع أن تكون صادقاً في كثير من القضايا.. فهل عليك ـ مثلاً ـ أن تصدق مع عدوك، إذا ألقى القبض عليك في معركة ما لتكشف له عن معلومات سرية تخصُّ بلدك وأمنها ومقومات وجودها؟!! بالطبع لا.. بما يعني أنّ حركة تطبيق القيمة في الواقع العملي هي المتغيرة، وهي التي تختلف عن واقع وجودها المعرفي القيمي النظري.. بما يعني أيضاً أنه يجب ألا نسجن أنفسنا في داخل هيكل القيمة العليا دوماً، لأن ذلك يؤثر سلبا على حركتنا الحياتية ونتاجاتنا العملية.. وهذا ما يمكن تسميته في التطبيق العملي، بـ «الأخلاق الاجتماعية» أو «الأخلاق العملية» المقارنة للسلوك الاجتماعي اليومي المرتبطة بالحياة الضروريَّة.. وهو بالمحصلة، يأتي نتيجة خبرة تراكمية تنتقلُ من حينٍ إلى آخر عبر وسائط مختلفة..
ونتيجة هذا التراكم النظري والعملي في الموضوع المتعلق بالأخلاق، نشأ ما يسمى بعلم الأخلاق، كوسيلة وأداة للعمل بما تقتضيه قواعد الأخلاق ومبادئها ومعاييرها الدينية والبشرية القارّة.. ويعرّف بأنه العلم الذي يوضحُ معنى الخير والشر، ويبينُ ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضاً، ويشرحُ الغاية التي ينبغي أن يقصدها الناس في أعمالهم، وينير السبيل لعمل ما ينبغي([24]).
ويعرّف أيضاً بأنه العلم الفلسفي الذي يختص بدراسة الأسس أو المبادئ التي بناء عليها يمكن أن ننسب قيمة أخلاقية (Moral Value) لسلوك ما. وبهذا الاعتبار، فإنّ علم الأخلاق في الأصل علم عملي؛ لأنّ مسائل الأخلاق بطبيعتها تتعلق بالسلوك الإنساني؛ ومن ثم فإنها تُعد شأناً من شؤون الحياة العملية.. مع أن القدماء نظروا لعلم الأخلاق كعلم عملي، فقط بهذا الاعتبار، أعني باعتبار أن موضوع هذا العلم يتعلق بالسلوك الإنساني.
هذا لا يعني بطبيعة الحال أن الأخلاق التطبيقية لا شأن لها بالأخلاق النظرية.. لأن الأخلاق التطبيقية وإن كانت لا تجد في الأخلاق النظرية حلاً شافياً مضموناً لمشكلاتها؛ إلا أنها بالتأكيد يمكن أن تسترشد ببعض المبادئ النظرية العامة التي أقرها الوعي الأخلاقي الفطري القائم أساساً على ما أودعه الله تعالى في الإنسان من قابليات أخلاقية..
ثانياً ـ الأخلاق في المنظور العلماني:
العالمُ البشري واسع وكبير، ومنذ أن وجد الناس على هذه البسيطة، وأصبحوا شعوباً وقبائل، انقسموا إلى أممٍ وحضارات متعددة ومختلفة ومتنوعة، لكل منها قناعات وأفكار وعادات وتقاليد وقيم وأعراف دينية وغير دينية، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا..﴾ (الحجرات: 13).. هذا التنوعُ الهائلُ في البُنى المُجتمعية الفكرية والاعتقادية ومنظومات القيم الأخلاقية لشعوب الأرض ومختلف ملله ونحله، أدى (وسيؤدي بالضرورة) إلى بروزِ تناقضات واختلافات عميقة في حركة تظهير المصالح بين البشر، تسببت في إشعال نيران التنازع والتدافع المستمر بينهم.. وحتى تكون العلاقات القائمة بين هؤلاء الناس ـ المختلفين في الرؤى والمصالح وربما في تطبيقات الأخلاق العملية ـ متوازنة وسلمية غير صراعية، لا بد من وجود سياجات قانونية سامية تنظم تلك العلاقات، وتمنع تحولها إلى مصدر للصراعات العنفية وإشعال الحروب.. وهذه السياجات الحامية والضامنة للمسؤولية والتوازن السلوكي ذاتاً وموضوعاً، هي القيم الأخلاقية الإنسانية الثابتة والراسخة، والمفترض أن تكون مشتركات قيمية إنسانية بين مختلف أمم البشر ومجتمعاتهم وحضاراتهم.. ولكن اختلاف عقائد الناس وتعدد خلفياتها ومرجعياتها الفكرية والعقلية والدينية، صعّب من التوافق على مرجعية قيمية إنسانية واحدة، ومنظومة أخلاقية متكاملة واحدة، قوامها: الرفق، واللين، والتواد، والتراحم، والتسامح، والتعاطف، والتواضع، والتعاون على البر والتقوى، وحب الخير للغير، مع التجاوز عن الهنات، والتغافل عن الإساءات، والتماس الأعذار، وتفريج الكربات، ومراعاة مواقع الناس وأقدارهم، ومشاركتهم مشاعرهم في أفراحهم وأتراحهم، و…، إلخ.. وهذا التباين والاختلاف وعدم الاتفاق العملي لا النظري فقط على بناء منظومة قيم وأخلاق إنسانية واحدة، دفعت البشرية أثمانه الباهظة من خلال تناقض المصالح وطغيان الجانب السياسي النفعي على حياتهم وعلاقاتهم مع بعضهم بعضاً..
إننا نعتقد أن نقطة البدء والانطلاق في وعي المسألة الأخلاقية وإدراك خلفياتها وتمثلاتها العملية، تأتي من النظرة للحياة والوجود، وطبيعة رؤيتك الكونية ـ أنتَ كإنسان أو كمجتمع ـ لأصل الخلق ومعنى ومبدأ الوجود.. فالدين الإسلامي يؤكد في نظرته ورؤيته الكونية على أنّ كلَّ مخلوق وكائن من أصغر ذرة (وما دونها) إلى أكبر مجرة (وما فوقها وبعدها) راجعٌ في بدئه وخلقه واستمرار وديمومة وجوده إلى مبدأ فياض واحد هو الله تعالى، يقول تعالى: ﴿ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: 102).. وهنا تكمن نقطة الخلاف والتصادم مع الرؤية العلمانية([25])، ليس فقط في موضوعة الأخلاق بل في كل المواضيع المطروحة الأخرى، فلسفية كانت أم سياسية أم اجتماعية وغيرها.. حيث أن الفكر العلماني لا وجود عنده لمطلق أو متعال، ولا حتى غاية كبرى ذات معنى يتطلع إليها الإنسان وينشد تجلياتها القيمية، وليس هناك أمل في وجود حقيقة مستقلة خارج التفكير المادي تكون سنداً أنطولوجياً للأخلاق في حركة الواقع البشري.. وفي ظل هيمنة هكذا تفكير علماني، وغياب المعنى والنظرة المحورية للكون والحياة القائمة على المبدأ الإلهي، والتي يترتب عليها غياب الإيمان بما هو أكثر من المادة والإنسان والتاريخ، يختفي هذا البعد الروحي الأخلاقي عند الإنسان، لتصبح الأخلاق مجرد عملية دنيوية مصلحية تتقوم بأهواء الفرد وحريته الشخصية وقناعاته الحياتية حتى لو كانت مدمرة وعبثية وغير ذات معنى..
إذاً أصل الخلاف العلماني الإسلامي في قضية الأخلاق وغيرها، فلسفي عميق، له علاقة بالمرجعية (الثقافية والمعرفية) والخلفية الاعتقادية، على مستوى معرفة الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة، والمنطلقات التي يتحرك في ضوئها، وسر معنى هذا الوجود، ولا يعود لمقارنات مرتجلة لبعض النماذج السياسية والفكرية النظرية، فعندما نقارن بين العلمانية والإسلام، فإننا نقارن بين فلسفتين إحداهما تستمد جذورها من المادة، وأخرى توازن بين المادة والروح.. وعلى مستوى الأخلاق، يكون السلوك الأخلاقي ـ في ميزان العقل المجرد والمنطق الوضعي العلماني ـ مجرد واقعة مثل أية واقعة مادية أخرى، ولا يمكن أن يكون له معنى إلا في عالم الإيمان بالله تعالى الذي يتجاوز حدود العقل([26]). فالمعاني التي تشير إليها المفاهيم والحقائق الأخلاقية تنطوي على معقولية خاصة تخرق حدود معقولية العقل المجرد، ولا يمكن للعقل المجرد أن يدرك هذه المعاني إلا إذا خرج من طور العقلانية المادية إلى طور العقلانية الدينية، أو قل بالتحرر من قبضة الحضارة والانفتاح على أفق الثقافة؛ لأنَّ الإنسانَ كائنٌ ليسَ ذا طبيعة واحدية مادية كما تدعي الفلسفة المادية، وإنما هو ـ على العكس من ذلك ـ كائنٌ ذو طبيعة ثنائية، تزدوج فيها الروح بالمادة، أو تزدوج فيها الحضارة بالثقافة. فالثقافة، تمثل الجانب الروحي في الإنسان؛ بحيث تبدأ بالتمهيد السماوي بما اشتمل عليه من دين وفن وأخلاق وفلسفة، وستظل تعنى بعلاقة الإنسان بتلك السماء التي هبط منها. أما الحضارة فلا تمثل سوى الجانب العلمي المادي، أو الأداتي والآلي في الإنسان، إذ ليست أكثر من استمرار للحياة البيولوجية ذات البعد الواحد، التبادل المادي بين الإنسان والطبيعة، استمرار للتقدم التقني، وهذا الجانب من الحياة يختلف عن الحيوان في الدرجة والمستوى والتنظيم فقط([27]).
هذا وتقوم أخلاقيات العلمنة إذا صح التعبير على الأسس والمعايير التالية:
1ـ الاستناد إلى المرجعية النهائية للعلمانية والفكر العلماني، وهي مرجعية العلم والعقل، أو ما يسمى بالعقلانية الوضعية، في تقرير مبادئ الأخلاق الواقعية العملية اللازمة للفرد والمجتمع الإنساني، بما يحقق مصلحته كذات حرة أصيلة غير مقيدة بدين أو شرع أو إلزام أخلاقي غير وضعي، وليس عليها وصاية من أحد سوى القانون الوضعي. لتكون هذه الذات محور وجود العالم.
2ـ استتباعاً للنقطة الأولى، تصبح قيم الأخلاق، وقوانينها ومختلف مبادئها، منطلقة من إرادة الإنسان الحرة، ومن علمه وسيرورته الوجودية (تجربته العملية)، وليس من إرادة الدين وتشريعاته وأحكامه. بالتالي عقل الإنسان والطبيعة أصبحا هما المرجع في إصدار القوانين الأخلاقية اللازمة لتنظيم العلاقات المجتمعية والسلوك البشري.. بما ينفي الحاجة للوحي أو النص الديني في ذلك. كما أنّ التزام الإنسان بالقوانين الأخلاقية يأتي كحافز انطلاقاً من مسؤولياته الشخصية وتوجهاته العقلانية وإرادته الطبيعية الحرة، وليس من الأوامر الدينية الصادرة إليه. بعبارة أخرى فإن الأخلاق العلمانية وعلمها وقوانينها باتت لا تستند إلى الدين.
3ـ الأخلاقُ العلمانية أصبحت تعبرُ في الغرب الحديث ـ وفي كل المجتمعات التي تأثرت بثقافته وفلسفته ـ عن الأخلاق الاجتماعية (العرفية) العملية، بحيث أن الغاية والهدف منها لا يخرج عن البعد المادي النفعي في تأمين سبل الوصول لتحقيق الرفاه والسعادة الاجتماعية الدنيوية لا أكثر ولا أقل.. ولا علاقة لها بشيء اسمه معنى أو آخرة أو غايات عليا، في حين تهدف الأخلاق الدينية الإسلامية إلى تحقيق السعادة الفردية والأخروية.
هذا كله يعطينا فكرة عن أن الأخلاق في الفكر العلماني نسبية إجرائية تعلي من شأن الأنا والذاتية الفردية، وترهن كل شيء لمصلحة الفرد بصرف النظر عن مدى الضرر والأذى الذي قد يلحق به، نتيجة طغيان هذا النمط من الأخلاق العملية على حياته وسلوكه، والتي تستند على مادية فجة هي بذاتها نسبية وغير ثابتة بل سيالة ومتغيرة، لم تقدم النفع المباشر والخير الكثير للبشرية في تاريخه الممتد لقرون طويلة، والحروب والصراعات ونهب الثروات والخيرات خير برهان..
إنَّ المشكلة هنا تكمنُ في كيفية معالجة هذه الأخلاق لقضية العدل والمساواة والسعي لتحقيقها في مجتمعات الأخلاق العلمانية ذاتها؟!، وما إذا كان للعدل قيمة في ظل نسبية تلك الأخلاق؟، وهل للإنسان كرامة حقيقية أيضاً، طبعاً نتحدث هنا عن كرامته كروح وجسد وليس فقط كرامة مادة الجسد؟!..
إننا نعتقد أنّ مفاهيمَ وقيم العدل والمساواة والإنسانية لا تتغير مع تقادم الأيام في أي مجتمع بشري، لأنها مطلقات بشرية وفطرة عامة، بل هي قواعد الحياة الثابتة.. من هنا المشكلة الكبرى عند كل تلك التيارات والمذاهب والاتجاهات الفكرية والفلسفية العلمانية هي في عدم قدرتها بنيوياً ومنهجياً على إيجاد أساس متين للأخلاق، ولحقوق الإنسان، بل حقوق سائر الكائنات (الأحياء أو الأشياء).. فعلى (نظرية الاهتمام)، عند بيري، ونظرية (الإرادة الحرة) عند هيجل ونظرية (أنا) الوجودية؛ ما هو أساس الأخلاق والاعتراف باهتمامات الآخرين وبإراداتهم وبوجوداتهم؟!([28]).. إن هذه النظريات تجعل الذات محور وجود العالم كما قلنا أعلاه.. أما الآخرون فيصبح وجودهم ثانوياً، إنما يبرر وجودهم من خلال وجود (أنا) لأنهم ينفعونه، أو لأنه من دونهم لا يجد ثانوي (أنا) من يؤنسه هكذا. وهذا التبرير حتى لو كان مقنعاً يجعل الإنسان يفضل مصالحه الذاتية على مصالح الآخرين. ويرى أن وجوده هو الأولى والأهم، فيصبح التناقص والصراع سمة العالم في حين أن الأخلاق بحاجة إلى قوة كبيرة لتبريرها([29]).. والدين هو هذه القوة الروحية والسند المعنوي المتين والمكين الذي وازن بين الروح والمادة دونما إخلال وطغيان لواحد على الآخر، على عكس الحداثة الغربية بعلمانيتها الفجة التي أخلت بهذا التوزان، وقامت بتقوية الجانب المادي، أو الحضاري (العيش والاستهلاك وابتذال الغرائز)، على حساب تفقير جانب الروح، أو الدين، فأنتجت لنا إنساناً غربياً مادياً غريزياً يعيش صراعاً داخلياً بين القيم الفطرية الروحية والقيم النفسية المادية، أو قل يعيش صراعاً داخلياً بين المثل العليا المسيحية والنماذج السياسية للمجتمع الذي تطورت فيه منفصلة مستقلة عن هذه المثل العليا([30]).
إنَّ العلمانية ـ كفكرة ومرجعية رضيتْ بها دول الغرب وحظيت باهتمام مجتمعاتهم، وباتت عقيدة سياسية عملية لهم، قيماً وسلوكيات عملية سياسية ـ ليس لنا معها نقاش سياسي عملي يخصّهم في قضية اختيار مرجعيتهم الخاصة بهم، إلا عند تحوُلها لعقيدة سياسية صدامية ضد الآخر المختلف، خاصة هذا الآخر العربي الإسلامي بالذات، في محاولات الدول التي تتبناها وتدافع عنها، طمس هوية هذا العربي المسلم، الدينية التاريخية عبر سياسات الفرض والإملاء التي مارسها ويمارسها كثير من عبدة هذا الغرب في فضائنا السياسي العربي والإسلامي، في سعيهم الدائم لنقل كل ما في الغرب من أشكال القيم والسلوكيات اللا دينية، وفرضها على مجتمعات هذه الأمة.. بحيث يكون هذا الطمس والتشويه والتحريف للهوية مقدمة وتمهيد (فكري) للنهب والسيطرة والتحكم بالموارد والثروات.. وهذا ما حدث تاريخياً للأسف، وهو متواصل ومستمر إلى أيامنا هذه بأشكال وأنماط شتى، وتحت غطاء قانوني دولي..
وأما المشكلة بخصوص العلمانية العربية وأفكارها وقيمها ومختلف مذاهب أصحابها ـ وكل ما يرتبط به من اتجاهات ويخرج عن قادتها من آراء وطروحات ـ أن بعض أتباعها ومروِّجيها، يستهدفون فعلياً استئصال الدين والأخلاق الدينية من واقع الحياة الاجتماعية والسياسية، وفي الحد الأدنى قيامهم بتأسيسِ رؤى وأفكار دينية لا علاقة لها بالدين نفسه.. رغم معرفتهم المسبقة باستحالة تنفيذ مثل هذه السياسات الرعناء الكارثية، لأن الإسلام عميق التجذر في ذهنية الناس وفي خلفياتهم الروحية والنفسية والأخلاقية والسلوكية بصرف النظر عن طبيعة تلك التمثّلات الفكرية والسلوكية.. كما أنه دين اجتماعي (سياسي) لا ينفصلُ في قيمه وأفكاره وأخلاقياته ومعاييره السلوكية، عن واقع الحياة الاجتماعية الخاصة والعامة للفرد المسلم، بل يطالبه (ويأمره) بتمثل وتطبيق قيم الإسلام وأحكامه وتشريعاته في كل تفاصيل حياته الخاصة والعامة.. فكيفَ يمكن والحال هذه، التوفيقَ بين الأمر (والشرع) الديني الإسلامي (الإلهي)، وبين واقع الحياة العلماني الذي يرفض أن يكون للدين أي دور في حياة الناس والمجتمع ككل؟!!.. هنا يقع أصل الصدام الفكري والعملي بين فكرة العلمانية والدين الإسلامي..!!.
وهذه إشكاليةٌ كبيرة وخطيرة تدلّنا على مدى هذا الانقسام الحاصل في بلداننا بخصوص فكرة العلمانية بينَ نخب وتيارات سياسية وثقافية حالمة بتطبيق العلمانية (على عللها ومراضها الأخلاقية والاجتماعية في بيئة غير مؤاتية لها)، وبين مجتمعات (رافضة لمعناها ومبناها) وتعتقد أن أول ما تستهدفه هذه الفكرة هو عقيدتها الدينية وأخلاقها الإسلامية وتراثها الإسلامي وأنسجتها التاريخية.. مع عدم تفريق تلك النخب بين معنى الدين وآليات تطبيقه العملية في الغرب الكنسي، وبين معناه وآلية تطبيقه العملية في مجتمعاتنا العربية الإسلامية.. ووقوعها في شراك سحب تجربة الغرب مع الدين إلى مجتمعاتنا.. حيث أن مفهوم (العلمانية) ـ نسبة إلى العِلم أو إلى العَالَم (الدنيوي أو المذهبي الدنيوي) ـ تم طرحه هناك في الغرب، في سياق السّجالات والمواجهات التي دارت بين الكنيسة ورجالاتها من جهة وبين القوى الزمنية والعلمية من جهة أخرى، نتيجة ادعاء (رجالات الكنيسة وعموم مفردات الأكليروس الديني الكنسي) لسلطة الحق الإلهي المقدس.. من هنا جاءت حركة العلمنة ـ كخلاصة لجهود الرفض والمواجهة مع الكنيسة القروسطية ـ لتفصل بين الدين المسيحي والدولة.. في حين أن الإسلام كدين ليس سلطة روحية ولا بشرية.. ولم يحدث أن قامت ضده ثورات وانتفاضات أو حركات معارضة فكرية وسياسية..
وللأسف بقيت تلك النخب متترّسة عند حدودها الفكرية ومقولاتها الذاتية العقائدية الأولى المعادية لدين مجتمعاتها، متبنيةً قوالب فكرية قديمة مغلقة في فهمها وتوصيفها ووعيها لتلك المتغيرات التي أصابت عالمنا العربي في صميمه، وبدأت تستعيد الشعوب من خلالها حيويتها وقوتها ودورها ومكانتها على صعيد الفعل السياسي والمشاركة في صنع المصائر والمآلات الوجودية.
والمشكلة أن كثيرين من هؤلاء الكتبة ـ لا المفكرين ـ سبقتهم التحولات والتغيرات المجتمعية، بمختلف مفرداتها الفكرية والسياسية والعلمية، بأشواط عديدة، وبقوا جالسين خلف حواجز أوهامهم العقدية، ومنغلقين في كهوفهم الفكرية، مستخدمين لغة متعالمة تدّعي القبض على الجوهر المعرفي وامتلاك الحقيقة لوحدها، ومتخشبين حول مجموعة صنميات ورؤى نظرية قديمة ثابتة يسقطونها دوماً على أية أحداث ومتغيرات سياسية ومجتمعية لاحقة، مع أنهم كانوا يتهمون غيرهم على الدوام بالثبات والانغلاق على الذات لغةً ومفاهيم وتحليلات.. أي أنهم باتوا يقعون ويغرقون باستمرار في نفس المستنقعات والمطبات الفكرية والمعرفية التي يتهمون خصومهم بالغرق فيها، بعيداً عن الرؤى النقدية العقلانية المتحركة المعروفة.. فمن ليس معي فهو ضدي، ومن هو ضدي فقد بات عدواً لي، تصح في حقه كل مقولات التخوين وأقذع ألفاظ ومصطلحات التآمر ومصطلحات التزمت العقائدي التاريخي.. وكأننا أصبحنا أمام محاكم تفتيش علمانية جديدة..
وهكذا، لم يتقبّل المسلمون ـ ولن يتقبلوا ـ مصطلح العلمنة لا على المستوى الفكري ولا على المستوى العملي، بالرغم من تطبيقاته في كثير من بلدانهم التي فرض حكامُها ونخبتها «العسكرتارية» التسلطية أيديولوجياتٍ تغريبية لم تلقَ التفاعل ولا الاستجابة المطلوبة للنهوض والتقدم المجتمعي الحقيقي من قبل الفاعل الاجتماعي العربي والإسلامي (وهو شرط موضوعي حاسم للنهضة والتطور والازدهار)، فكانَ أنْ بقيت تلك التطبيقات مجرد دعوات هوائية ومشاريع حداثة وتحديث قشرية نخبوية مكلفة وعقيمة، على الرغم من مرور زمن سياسي طويل على فرْضها في بعض مجتمعاتهم التي حكمتها أيديولوجيات مختلفة، ونقول «فرْضها» بسبب خصومتها النفسية والعملية معهم.. حيث أنهم ربطوا ـ في إرثهم الفكري التاريخي ووعيهم العملي ـ بينها (بين العلمنة) وبين أفكار وسلوكيات أخرى اعتبروها مناقضة ومحاربة ومضادة للدين ولقيم الدين ذاته.. أي أن العلمنة في الوعي الشعبي ما زالت فكرة غير مقبولة وغير مرحب بها، لا تحظى برضى الناس واحتضان بيئتهم المجتمعية العامة.. الأمر الذي دفعهم لرفض الانفتاح على مقتضياتها ومتبنياتها ونتائجها الحداثية العملية الأخرى كونها جاءت لتصدم وتناقض وعيهم الديني ونسيجهم التاريخي الديني.
وطالما أنها (أي العلمانية) تصدم الوعي الجماهيري المتدين بمقولاتها المعادية للدين والتراث الدين، فلن تجد لذاتها أي موطأ قدم في بيئة العرب والمسلمين..
نعم، نحن ندركُ أنّ الحاضر العربي والإسلامي لن ينصلح بنيوياً من دون إصلاح طبيعة نظرتنا إلى الماضي المسيطر علينا حالياً وربما مستقبلاً، خصوصاً بعد هذا الصعود السياسي للتيارات الإسلامية التي تريد الجماهير العربية الإسلامية إعادتها للساحة بعد فشل تجارب الحكم السابق كما ذكرنا، وبعد خلو الساحة تقريباً إلا من هذه الأحزاب الإسلامية التي تخاطب تاريخ الناس الدينية (وهويتها ومشاعرها) المغروسة في عمق وعيهم والتزاماتهم الفكرية، وتلامس أخلاقياتهم وقناعاتهم وعقائدهم الإيمانية.
من هنا، لا بدَّ من العودة لهذا التّراث الكبير بحجمه المادي والروحي، وإعادة درسه والتنقيب فيه وقراءاته في ضوء تجاربنا وتطوراتنا الراهنة عربياً وكونياً. وهذه العودة لا تعني أنْ ننساقَ وراء القديم وهي لا تعني مطلقاً أن نستعيدَ التاريخ المنقضي تكرارياً واجترارياً كما نقولُ دائماً، وإنما هي عودةٌ نقدية لواؤها العقل والتفكير الحر «ما حَكَمَ بهِ العَقل، حَكَم به الشَّرع»، ومصباحها الواقع والتطورات الكبيرة الهائلة في الزمان والمكان.. أي أنها عودة عقلانية صرفة تعني رؤية التراث الماضي، في ما هو، وفي جميع أحواله، لكي نعرف كيف ننفصل لنغادر ونفارق، وكيف نتصل لنتفاعل ونتعاون.. خصوصاً مع ملاحظة أنه لا مجال للحديث عن قداسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية، لأن الإسلام والمؤسسات الدينية الإسلامية لا تهيمن على المجال العام، ولا تعادي العلم والعلماء.. على عكس الغرب الحديث الذي ركّز ـ في فكره وسلوكه ـ على الربط المحكم بين العلمانية والنهضة العلمية والعقلية.. أي اشترط إبعاد الدين (المسيحية بالتحديد) عن الساحة لتحقق النهضة والتطور المجتمعي، واعتبره شرطاً وجودياً لعملية التحقق النهضوي..
ثالثاً: الاستقرار (والثبات) الأخلاقي الإسلامي وإمكانيات تَحقُقه
وردَت كلمةُ «الاستقرار» في المعاجم اللغوية العربية القديمة بمعانٍ حسّيّة حقيقية، ومعان مجرّدة مجازية؛ فقد قال ابنُ فارس في المقاييس: القاف والراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على بَرْد، والآخر على تمكن.. فالأول القُر، وهو البَرد. والأصل الآخر: التمكن. يقال: قرَّ واستقَرَّ. والقَر: مركب من مراكب النساء. ومن الباب القَرُّ صبُّ الماء في الشيء، يقال قررتُ الماء. القَر: صب الكلام في الأذن([31]).. نستخلصُ مما سبقَ أنّ دلالة قَرّ أو استقرّ عند ابن فارس تجمعُ بين دلالات مختلفة: إما دلالة حسّية (البرد)، وإما دلالة مجردة (التمكن)، وإما دلالة مجازية، القر: صب الماء في الشيء، أو صب الكلام في الأذن.
أما الاستقرار في الدّلالة الاصطلاحية؛ فهو كما يقولُ الطاهر بن عاشور: التمكّن في الأرض، وهو مبالغة في القرار. وهذا استقرار خاص غير الاستقرار العام المرادف للكون([32]). والملاحظُ عند ابن عاشور أنه انطلق من الدلالة المعجمية الأصلية (التمكن) لينتقل إلى الدلالة الاصطلاحية الخاصة وهي أنَّ الاستقرارَ هو الثباتُ في الأرض؛ وهو استقرار خاص، مميزاً إياه عن الاستقرار العام الذي يرادفُ الكون، بعبارة أخرى؛ هناك استقراران: استقرار خاص مؤقت، واستقرار عام دائم يحكم الكون والعالم أجمع.
كما ورد لفظ الاستقرار في القرآن الكريم مشتقاً، فقد جاء مرة واحدة فعلاً ماضياً (استقر)، وثلاث مرات اسم فاعل (مُستقِر)، وعشر مرات اسم مفعول (مُستقَر) معرفة ونكرة؛ فيكون مجموع وروده هو أربعة عشر موضعاً في القرآن؛ هذا فضلاً عن صيغ اشتقاقية أخرى مثل (أقررتم، القرار، قرة أعين، القوارير)، وهذا يدل على الحضور المهم للمصطلح القرآني المذكور.. وهذا يدلُّ على تنوع صيغه الاشتقاقية المناسِبة لتعدد دلالاته؛ بمعنى تناسبت دلالاته المعجمية والاصطلاحية مع دلالته العامة (التمكن)؛ أما الدلالة القرآنية للمصطلح، فقد عرفت تعدداً؛ بدا ذلك من خلال فهوم المفسرين لآيات الاستقرار، ومنها: التمكن، الدوام، والمرجع والمصير، والحكَم، والنهاية.. ويستخلص كذلك من مفهوم الاستقرار أنّ هناك استقرارين: استقرار جزئي مؤقت، واستقرار عام دائم يتماشى مع الكون والحياة.
أما بخصوص الاستقرار القيمي الأخلاقي، فنعني به ثبات القيم في مضمونها الذاتي، أي كما هي في أصالتها الأولى، مع تغير أوجه التعبير عنها، وتغير تمظهراتها الشكلية في آليات السلوك والممارسة الخارجية.. أما مضمونها فثابت وراسخ لا يتغير.. ولا يمكن أن تستمر حياة إنسانية (ولا تستقيم) على نحو منتج وفاعل ومؤثر ومتطور ومزدهر، من دون استقرار قيمي وأخلاقي وليس فقط سياسي واجتماعي.. لأن هذه الاستقرار في القيم والأخلاق هو الذي يمنحنا الهدوءَ والثبوتَ، والسُّكونَ والطمأنينةَ، والأمان في العلاقات والبناء والتواصل المجتمعي..
والاستقرار بهذا المعنى نعمة تقاس بها كثير من الأشياء في حركة واقع الناس والمجتمع، ووجود هذه النعمة دافع وسبب للنجاد الفردي والمجتمعي في كل شيء، مثلما أنَّ فقدانه (كعيش الناس في ظل التنازعات والتوترات والتناقضات والصراعات)، يؤدي إلى شلل كبير في إنتاج الناس وسيرها الطبيعي الآمن في حياتها، وعجزها عن فعل أي شيء.. وهذا ما عبَّر عنه القرآن الكريم: ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: 46).
واستقرارُ الفرد في عيشه وعلاقاته وتخطيطه لمستقبله، وانشغاله الآمن ـ إذا صح التعبير ـ بتطوير وجوده الآدمي نحو مواقع أرفع وأرقى تحققُ له معنى الوجود وسبل السّعادة الحقيقية، لا يمكن أن يتحول واقعاً ملموساً إلا بتوافر أسس وشرائط لا تخصه فقط كذات فاعلة، بل تخص وجوده في المجتمع البشري السياسي والأهلي الذي يعيش فيه وينشط في مختلف مجالاته وجوانبه وسبله وطرائقه.. ويأتي على رأسها أن يعيش في ظل دولة تتقوم بالعدل والكرامة والأخلاق الإنسانية.. تسعى لتوفير كافة ظروف ومتطلبات تحقيق العيش البشري المتوازن والازدهار المجتمعي السعيد، من حيث حصول الناس على حقوقها، وتأمين حاجاتها.. فأي بلد فيه موارد وخيرات، وهي من حق الناس، ووظيفة أية سلطة تحكم، تكمن فقط في أن تشرف بالقانون والعدل وعلى توزيع الثروات واستثمارها واستغلالها لصالح الناس فقط، وبما يعود بالنفع العام عليهم وعلى الأجيال اللاحقة.. وهذا أمر بحاجة لرجالات دولة وأفراد مجتمع ممتلئين بالسجايا الأخلاقية والإنسانية، فضلاً عن كونه أيضاً مسألة قانونية وحقوقية بطبيعة الحال.. لكن الأساس في ذلك هو الطوية النفسية والأخلاقية للإنسان نفسه في ضرورة تربيته وتنشئته على الفضائل الأخلاقية..
إنَّ استقرارَ القيم والأخلاق الإسلامية (من صدق ووفاء وأمانة وإيثار وعفة ومودة وتسامح وعفو وصفح ورحمة وصبر وقناعة، وغيرها)([33])، تنطلق في ثباتها ورسوخها من كونها مرتبطة بنظام الشريعة وأساسيات العقيدة، أي أنها مستندة على أساس ديني إلهي يعلم بخفايا النفس وأسرارها، قوله تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: 14)، لتكون هي بنفسها ثابتة وراسخة، فتظهر كحواجز قوية في مواجهة الفوضى والظلم والشر والإفساد، يقول تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا﴾ (البقرة: 229)..
وهذا الاستقرارُ والثباتُ الأخلاقي المُستند على الدين والفطرة ومنهجية الإسلام الأخلاقية، هو الذي يبعث الراحة النفسية والسكينة الروحية في حياة الفرد المسلم.. فالإصرار على الحق والأخلاق الحقيقية والثبات على الالتزام بمقتضياتها في العلاقات الخاصة والعامة، هو السبيل الآمن لتحقق الاستقرار القيمي الأخلاقي في المجتمع، لأنه من دون الاستقامة والثبات على الحق تفوت الثمرة، ولا يصل المسلم إلى الغاية والمعنى.. ولا يمكنه التعايش مع الناس بأخلاق أخرى مفارقة بعيدة عن نسيجه التاريخي والعقائدي، كالأخلاق العلمانية أو أخلاق العادات والتقاليد، بما يعني أنَّ هذا الدين القائم على تكامل البعدين الروحي الأخلاقي والمادي الحياتي العملي، لم يترك للعقل الحرية المطلقة والمنفلتة في أن يكون هو لوحده وبذاته منبعاً أو مصدراً وحاكماً لتحديد منظومة الأخلاق السلوكية التي يجب على البشرية السير في ضوئها، لأنه فاعل نسبي يمكن تطويعه، وهو قابل للخطأ والخضوع لمصالح الناس، وقابل أيضاً لكي يُسخّر نفسه لخدمة الغرائز والقوى الشهوية والغضبية عند الإنسان..
وبطبيعة الحال، لا ينافي هذا ما أقرَّه الإسلام من أخلاق العرب في الجاهلية؛ كالكرم، والشجاعة، والغَيْرة، وغيرها؛ لأن الله تعالى جعل أصلها مركوزاً في الفطرة البشرية، فما بقي منها على الجادَّة دون انتكاسٍ، أقرَّتْه الرسالة، بل أكدت عليه ونمَّته وحدَّدت له مساراته الصحيحة، وما انحرف منها عن الفطرة، أعادتْه التعاليم الربانية بمسالك التربية المختلفة([34]).
وقد يقولُ قائلٌ هنا أن ثبات القيمة الأخلاقية الإسلامية، واستقرارها العملي في رسوخها الرباني الفطري، قد يكون عائقاً أمام حركة الفرد المسلم في ممارسته لحياته وعلاقاته سواء في محيطه الخاص أو العام..!!. بمعنى أنَّ ثبات القيم الأخلاقية التي جاءت في فترة زمنية ماضية، قد لا تتناسبُ مع متغيرات العصر والحياة، ولا تصلحُ لمستجداتها وسيرورتها في الزمان والمكان..!!.. في الواقع إنّ الأخلاقَ الإسلامية هي أخلاق فطرية إنسانية، وهي أخلاق ربانية، ورغم أنها تتسم بالاستقرار والثبات، تتسمُ كذلك بالمرونة والانفتاح والحركية العملية، بما يجعلها متناسبة مع المتغيرات المختلفة والمتنوعة، ومراعية لقوانين الاجتماع البشري في تطوراته العملية.. فمثلاً، عندما يؤكِّد الإسلامُ على قيمة وخُلُق الصدق، ويحذِّر من مغبَّة الكذب، فإنه لا يقف بهذا الخُلُق في دائرةٍ من الجمود والثبات المكلف الذي يصطدمُ بمصالح الإنسان ـ والتي تحدِّدها أحكام الشريعةُ لا الأهواءُ والطبائع ـ فتراه يرخِّصُ في بعضِ المواطن في الكَذِب على أساسِ أنه استثناء محدد، وليس أصلاً راسخاً، ولمصلحةٍ شرعية راجحة كأن تكون في حرب مثلاً، أو أن تسعى في إصلاحِ ذاتِ بيْنٍ بين الناس.. فالمصلحة العليا للفرد والمجتمع المسلم هي الأساس، وهي مصلحة تقوم على الاستقرار الأسري والمجتمعي، كمقدمة للنهضة والإنتاج والازدهار..
ومن معالم الاستقرار القيمي الأخلاقي في الإسلام أنه جعلَ الأخلاق واقعية (عملية) ممكنة التطبيق في حياة الفرد المسلم دون تكلف وتصنع، وإلا فلو كانت مستحيلة التطبيق لبطلَ الثواب والعقاب، ولانتفَتْ معاني الوصايا والمواعظ والتأديبات.. يقول الرسول الكريم، في إضاءة على قابلية تمثل الأخلاق من قبل الفرد المسلم: «إنما العلم بالتعلُّم، وإنما الحلم بالتحلُّم، ومَن يتحرَّ الخير يُعْطَه، ومَن يتقِ الشر يُوقَه»([35]).. وهذا يتأتَّى ـ كما قال العلماء ـ بالصبر عليها، وتكلُّفِ التخلق بها؛ حتى تصير سجية وطبعاً مستقراً وراسخاً.
الهوامش
([1]) باحثٌ وكاتبٌ في الفكر العربيّ والإسلاميّ. من سوريا.
([2]) أنظرْ: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان ـ بيروت، طبعة ثامنة، عام 2005م، ص881. ومحمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان ـ بيروت، طبعة ثالثة، عام 1992م، ج10، ص86.
([3]) الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار القلم والدار الشامية، سوريا ـ دمشق، طبعة عام 2009م، ص297.
([4]) ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج4، ص194.
([5]) علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت، طبعة أولى لعام 1983م، ص101.
([6]) أحمد بن محمد ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، مكتبة الثقافة الدينية، مصر ـ القاهرة، طبعة عام 1998م، ص41.
([7]) الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسة الأعلمي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان ـ بيروت، ط1، 1979م، ص240، بتصرف.
([8]) مقداد يالجن، التربية الأخلاقية الإسلامية، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية ـ الرياض، بلا تاريخ نشر، ص75، ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة باحثين، دار الوسيلة، السعودية ـ جدة، طبعة رابعة، طبعة بلا تاريخ نشر، ص22.
)[9]( Monique Canto ـ Sperber et Ruwen Ogien، La philosophie morale، Paris، Presse universitaires de France ـ PUF، Quatrième édition، 2017، p. 4
([10]) أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة، مكتبة الإعلام الإسلامي، إيران ـ طهران، طبعة عام 1981م، ج2، ص15.
([11]) حسن المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إيران ـ طهران، الطبعة الأولى 1965، ج2، ص305.
([12]) حسن المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إيران ـ طهران، الطبعة الأولى 1965، ج2، ص305.
([13]) ماهر صبري كاظم، حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة، مطبعة الكتاب، العراق ـ بغداد، ط2، عام 2010، ص11.
([14]) عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، دار المعارف، مصر ـ القاهرة، طبعة عام 1967م، ج1، ص5.
([15]) حمدي عبد الرحمن، الحقوق والمراكز القانونية، دار الفكر العربي، مصر ـ القاهرة، طبعة عام 1976م،
ص3 وما بعدها.
([16]) مرتضى مطهري، فلسفة الأخلاق، ترجمة: وجيه المُسبّح، الناشر: مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى، عام 1999م، ص9.
([17]) توفيق الطويل، فلسفة الأخلاق، مكتبة مدبولي، مصر ـ القاهرة، طبعة ثانية لعام 1999م، ص17.
([18]) في إشارة لقول الرسول الكريم(ص): «إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ وفي روايةٍ (صالحَ) الأخلاقِ». (انظر: محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الأعلمي للطباعة والنشر، لبنان ـ بيروت، طبعة عام 2008م، ج68، ص382).
([19]) قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: 4).
([20]) نقد مرتضى مطهري لنظرية نسبية الأخلاق، موقع إشراقات قرآنية، تاريخ المشاهدة: 4 ـ 8 ـ 2023م، الرابط:
https://www.eshraqatquraania.com/2020/09/Criticism-of-the-relativism-of-morals-Mortada-Mutahhari.html
([21]) أبو الحسن الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، تحقيق: محيي الدين هلال السرحان وحسن الساعاتي، دار النهضة العربية، لبنان ـ بيروت، طبعة عام 1981م، ص4.
([22]) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، مصدر سابق، ص4.
([23]) في إشارة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ﴾ (الانشقاق: 6).
([24]) أحمد أمين، كتاب الأخلاق، مؤسسة هنداوي، مصر ـ القاهرة، طبعة 2011م، ص9.
([25]) تعني العلمانية بأبسط معانيها ـ ومن دون الخوض الجدلي في سجالاتها الفكرية والسياسية والتاريخية ـ فصل الدين عن الدولة وعن الحياة العامة، وحَصْر المسائل الدينية كعلاقة ذاتية (رأسية) خاصة بين الفرد وخالقه، وعدم اعتماد الدين في المسائل الأخلاقية والحياتية العامة، لأن الدين ـ في اعتقاد العلمانيين ـ «نسبي» الفكر والمبادئ، ويستند لقناعة شخصية، أي يُقبل عند بعض البشر، ويُرفض عند البعض الآخر.. بمعنى أنها كفكرة وآلية تطبيقية حيادية تجاه الأديان، تؤمن بحرية الاعتقاد والإيمان.
([26]) علي عزت بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة: محمد يوسف عدس، مؤسسة العلم الحديث، لبنان ـ بيروت، طبعة عام 1993م ص177 ـ 178.
([27]) علي عزت بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، مصدر سابق، ص64 ـ 95.
([28]) محمد تقي المدرسي، التشريع الإسلامي؛ مناهجه ومقاصده، طباعة: انتشارات المدرسي، إيران ـ طهران، طبعة عام 1996م، ج3، ص134.
([29]) حسن البلوشي، سؤال الأخلاق في الفكر العلماني، مجلة البصائر، لبنان ـ بيروت، العدد: 55، ص140.
([30]) علي عزت بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، مصدر سابق، ص188.
([31]) أحمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ص7 ـ 8.
([32]) محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، طبعة عام 1984م، ج19، ص271.
([33]) وهذه القيم والفضائل الأخلاقية الإسلامية (الإنسانية)، لها خلفياتها ومحرّضاتها النصية الدينية (القرآنية والحديثية)، فعن خُلُق العفو والصفح يقول تعالى: ﴿وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التغابن: 14)، وعن خُلُق الصبر يقول تعالى: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (هود: 115)، وعن خُلُق الصدق يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: 119)، وعن خُلُق الأمانة يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58)، وعن خُلُق العفة يقول تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (الشورى: 25).
([34]) عادل مناع، ملامح الإطار الأخلاقي في الإسلام، موقع صيد الفوائد، تاريخ المشاهدة: 11 ـ 8 ـ 2023م، الرابط:
http://saaid.org/arabic/694.htm
([35]) محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف، مصر ـ القاهرة، طبعة عام 1995م، ص342.