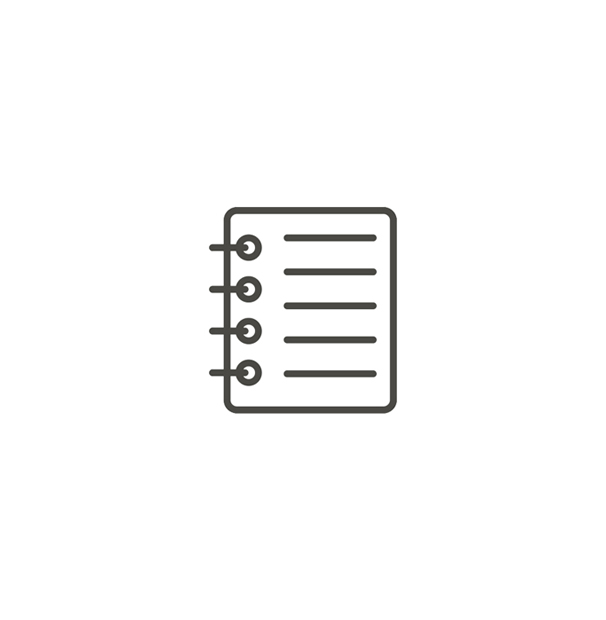المبحثُ الثّالث: الفكرُ الحقوقي في منظومةِ التّفكير الإٍسلاميّة
أوّلاً: ماهية الحقوق الإسلامية
قدم الإسلامُ رؤيته للحقوق الإنسانية التي تختصُ بأساسِ وجود الإنسان في تنظيمِ شؤونه الفردية والمجتمعية، وعلاقاته وآليات تعامله مع نفسه ومع غيره، في مستوياتها الخاصة والعامة، وذلك بالاستناد على ما وردَ في نصوصه من قواعد ومفاهيم وقيم أخلاقية معيارية رصينة تحظى برضى الله تعالى وتنسجم مع مبدأ الفطرة.. والغاية في النهاية، صياغة الإنسان المسلم المتكامل والمنسجم في فكره وقناعاته وحركته الوجودية، والقادر على تحقيق العيش السعيد في الدنيا، ونيل ثواب الله تعالى في الآخرة..
لقد أعطى الإسلامُ ـ من خلال شمولية تلك الحقوق لكافة مواقع حركة الإنسان الحياتية ـ نموذجاً اجتماعياً فكرياً وروحياً فريداً لحقوقٍ لا تتعلقُ فقط بالإنسان بل بالخالق العظيم الذي أمر بها، ودعا الإنسانَ لالتزامها وانتهاجها كتعاليم ربانية في حركته الذاتية والموضوعية، ليكون مقياسُ الموافقة أو المخالفة للإسلام مرتبطاً بمدى انطباق الأفعال (أفعال الفرد) مع منظومة الحقوق..
فقد وردَ لفظُ «الحق» في عدة مواضع ومعان في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقد وردت اسماً من أسماء الله تعالى في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (النور: 25)؛ وقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بالحق مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التوراة والإنجيل﴾ (آل عمران: 3)؛ وقوله تعالى: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (الأنفال: 8)؛ وقوله تعالى: ﴿ما خَلَقْنَا السََّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ (الأحقاف: 3)؛ وقوله تعالى: ﴿ليُنذرَ مَنْ كَانَ حيّاً وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلَى الكاَفِرِين﴾ (يس: 70)؛ وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (الحجّ: 62).
والحقُّ هنا هو نقيضُ الباطل، والنقيضُ للباطل إنما هو الحقيقةُ المطلقة والثابتة يقيناً.. أي الثبوتُ المطابقُ للواقع برتبة اليقين، والواجبُ على من هو عليه، أي هو ثابتٌ في نفسه يقيناً، وملزِمٌ لمن هو عليه.. فالحقُّ لا يعني الثبوت المجرّد فقط، وإنما يضافُ إليه لحاظان، أحدهما اليقين، والثاني الإلزام للغير. فإذا أُطلِق أريد به هذا المعنى المركّب([2]).
تنطلق فكرة الحقوق (الحقوق الفردية الإنسانية) في الإسلام من نقطة أولية هي اعتبار اليد الإنسان خليفة مكرم في الأرض، الأمر الذي يقتضي منحه مزايا وخصائص تناسب وجوده الفاعل من زاوية تكريم الله تعالى له، وبحيث تكون موضع احترام وتقدير عبر وضع مجموعة من المحدّدات والضوابط والشروط لتجسيدها وتنفيذها ورعايتها.. يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلقْنَا تفضيلاً..﴾ (الإسراء: 70).
هذا التكريم والتفضيل وعلو المرتبة الوجودية للإنسان، تأتي لأنه مخلوق منظور لمهمة وجودية كبرى، ويجب تأمين شروط نجاحه فيها.. ومن أهمها إنزال الرسالات والهداية، والأخذ بيده إلى المنهج الأصلح والأمثل، لتأمين مصالحه وضمانها العملي..
إن الله تعالى خلق هذا الإنسان، ونفخ فيه من روحه، وجعله في الأرض خليفة، تكريماً للإنسانية كلها، وجاء ذلك في حوار بديع، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 30).
وعلى هذا الطريق وضع الإسلام مبادئ ومنهج عمل لتحقيق غاية الخلق كخليفة مستأمن على الأرض، بما يكفل الحقوق كاملةً، ويمنح الكرامة للبشريَّة جمعاء، فلم توجد شريعةٌ كشريعة الإسلام العظيمة في هذا الأمر، حتى أنَّها ارتقت فجعلت هذه الحقوق من الواجبات الدِّينية، وحفظت الحياة الإنسانيَّة، فلم تفرِّق بين عناصر المجتمع، رجالاً ونساءً، واعتنتْ بجمهورِ النَّاس جميعاً([3]). وقد تعددت حقوقُ الإنسان التي كَفَلها الإسلام، ومنها حق الحياة، وهو الحقُّ المقدس؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يحرمه عن أحد، أو أن يقوم بانتهاكه، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء: 33).. وحق الحرية الذي يتلخَّص في رغبة الإنسان بالتخلُّص من كلِّ قيدٍ، وتحرُّر ذاته من الانعتاق، والحريَّة لها مكانتها التي تجعل جميع الشَّرائع توليها الاهتمام، وتتنوع الحريات، فلا تقتصر على نوعٍ واحدٍ؛ كحريَّة التَّدين، وحريَّة التَّعبير عن الرَّأي، وغيرها من الحريات([4]).. وحق حرية اختيار الدين، وتجسده الآية: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة/256)، وحق المساواة والعدالة، حيث أن الدين جاء أساساً لتحقيق العدل بكل أشكاله وأنواعه ومستوياته، يقول تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد/25)، والقسطُ كنايةٌ عن العدل، عدلُ الحاكم وعدل المحكوم وعدل القانون وعدل القضاء، وعدل كل ما يتّصلُ بوجود وحركة الإنسان في الواقع.. وأيضاً هناك حقّ العيش بكرامة، وحق التملك والتصرف، وحق إبداء الرأي والمشورة، وحق التعليم والتعلم والسّكن وغيرها.
يعني هناكَ جملة من الحُقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية التي أقرها الإسلام للإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه وديانته أو لونه أو جنسه أو مركزه الاجتماعي.. وهذه مساواة حقيقية لم تصل إليها كثير من تطبيقات الأفكار والنظم الوضعية في عصرنا الحاضر.. فالحقوق في الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً ولا نسخاً ولا تعطيلاً، إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي ليسَ من حقّ بشر كائناً من كانَ أنْ يعطّلها أو يتعدى عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السُّلطات التي تخولها.. والكرامة الإنسانية (كأحد أهم تجليّات الحقوق) تستوجبُ ـ في نظر الإسلام ـ حقوقاً كثيرة (للفرد)، منها: حقُّ الله ورسوله، وحق الحياة الكريمة، وحفظ النفس، وحق حرية الاعتقاد الديني، وحق حرية الفكر والتفكير (الحرية الشخصية)، وحق التملك والكسب، وحق الوالدين، وحق الأولاد، وحق الأقارب، وحق الزوجين، وحق الولادة والرعاية، وحق الجيران، وحق المسلمين عامة، وحق غير المسلمين([5]).
ثانياً: ماهية الحقوق العلمانية الحداثية
الحقُّ في الفكر الوضعي مُختلفٌ اختلافاً جذرياً عن الحقّ في الفكر الإسلامي لجهة الأساس والفضاء المعرفي والفلسفي الحاكم والموجّه؛ فالعقلانية الوضعية العلمانية تعتبر أن الحقّ لا خلفية دينية له، ولا علاقة له بالرؤية الدينية للكون والحياة والإنسان، إنما هو ثمرة تفكير ووعي اجتماعي بشري عبر سيرورة تاريخية، أدت بالمحصلة إلى تمكن الإنسان من الوصول لحقوقه بعد مسيرة طويلة من الكفاح والنضال والمثابرة العقلية والعملية.. تأتي هذه اللفتة الفكرية لنخب الفكر الوضعي نتيجة المناخ الفلسفي القائم على فكرة الحق الطبيعي ومحورية الفرد الإنساني وتأليه فردانيته إذا صح التعبير، والتعامل معه كفرد حر مستقل عن كل المرجعيات غير العقلية والعلمية..
إذاً هذه الرؤية النظرية الوضعية لمسألة الحقوق تستمد جذورها من مفهوم القانون الطبيعي الذي ترتبط به ارتباطاً جدلياً، فالحقوق الطبيعية للإنسان كالحياة والحرية والمساواة هي تشريع للقانون الطبيعي باعتباره مصدراً أساسياً للحقوق الثابتة للأفراد. ومفهوم الحق الطبيعي تعبير قانوني لرؤية فلسفية تبلورت في القرن الثامن عشر([6])، ينادي بأنَّ للفرد في آدميته حقوقاً يستمدُّها من طبيعته، وهي ثابتة لا تُنتزع، ويُفترض ألا تنتزع من أي فرد، وهي حقوق لا يمنحها المجتمع المتمدن، وإنما يعترف بها ويقرها، باعتبارها شيئاً نافذ المفعول في العالم أجمع، ولا تستطيع أي ضرورة اجتماعية أن تسمح لنا أن نلغيها أو نهملها([7]).. ويتأسس مفهوم الحقّ الطبيعي في التصور الحديث على جملة أسس منها، بلورتها كل الأدبيات الأولى لحقوق الإنسان في الفكر الغربي:
1ـ مساواة الجميع في هذه الحقوق.. حيثُ أن للطبيعة قوانينها التي يخضع لها كل إنسان، فالجميع متساوون مستقلون، وليس لأحد أن يسيء إلى أخيه في حياته أو صحته أو حريته أو ممتلكاته([8]).
2ـ أن الحقوق الطبيعية للأفراد سابقة على الوجود القانوني والسياسي، لأن الأفراد يولدون بحقوقهم الطبيعية، وعند نشأة المجتمع المتمدن يأخذون معهم حقوقهم الطبيعية إلى وضعهم المدني التعاقدي([9]).
3 ـ أن الحقوق الطبيعية تقتضي اعتبار الحرية هي أساس الوجود الإنساني.
ومع أن الفكر الإسلامي لا يعارضُ المبادئ الحقوقية الإنسانية (الوضعية) من الناحية الذاتية كحقوق طبيعية لصيقة بالإنسان تظل موجودة معه، وإن لم يتم الاعتراف بها أو تم انتهاكها من قبل سلطة ما، لكنه يربط الحق بالغاية والمعنى والآخرة، ويعيدها لمصدرها الأولي ونبعها الأصلي الإلهي لا الطبيعي، وهو كتاب الله وسنة رسوله(ص)، في حين أنّ مصدر تلك الحقوق في القوانين والمواثيق الدولية هو المنطق الوضعي أو الفكر البشري، أي أعمال العقل العملي..
ثالثاً: آلياتُ تحقّق الحقوق في واقع حياة الفرد والمجتمع
في الواقع، إنّ إصلاح أخلاق الناس لا يكونُ فقط بالمواعظ والنصائح المجردة، لأن سوءها ناجمٌ عن خلل في ظروفهم وأوضاعهم وليس نتيجة خلل في نفوسهم وذواتهم وفطرتهم، ولهذا تغيير الأخلاق ليس هو المقدمة لتغيير الظروف والأوضاع، بل تغيير الظروف والأوضاع هو الذي يجب أن يسبق عملية إصلاح الأخلاق التي لا تتم إلا بالحقوق وضمان تجسُّدها وتحقُّقها.. ولا يمكن أن تتجسد الحقوق في أي مجتمع من دون ضمانات قانونية تحميها في سيرورة التطبيق العملي.. حيث لا يكفي أن نتحدثَ وننظّر عن الحقوق وأهميتها، ولا يكفي أن نقول إن الإنسان مكرَّم وحرّ، ونقف عند هذا الحد، وأن نستنتج أن له الحق في أن يفعل ما يشاء، فتلك هي الفوضى بعينها، أو من حقه أن يحيا كيفما اتفق.. بل لا بد من تقنين هذه الحقوق، أعني وضعها في صورة قوانين محددة قابلة للتنفيذ ومرعية الإجراء.. فالحرية هي ما تجيزه القوانين، كما قال مونتسكيو بحق، عندما توضع الحقوق في قوانين تصبح موضوعية، وتنتفي منها صفة الذاتية، فلا يستطيع أحدٌ أن يفسرها على هواه. ومعنى ذلك، أنها لا بد أن تلتحم في نسيج اجتماعي عام ينظم سلوك الجماعة. وعلى هذا الأساس، نلاحظ أن الحق إن كان معطى طبيعياً يتجسدُ في كونه مثالاً أخلاقياً، فإنه لا يصبح ذا قوة إلزامية، إلا حينما يجري تقنينه، والتواضع عليه بكونه حقاً لكي تكون له قوة إكراهية (إلزامية)([10]). أي أن القوانين الناظمة للدولة هي التي تصون الحقوق..
وحماية هذه الحقوق الفردية وضمان تنفيذها لا يتحقق سوى بإخضاع سلطات الدولة للقانون، لأن السلطات الحاكمة (التي تدير دفة الدولة بما هي مؤسسات وهياكل إدراية) قابلة للعسف والاستبداد والتحكم بآليات تنفيذ الحقوق.. أصلاً بالأساس لم توجد فكرة الدولة القانونية([11]) إلا لضمان الحقوق ومراعاة تنفيذها وحمايتها، وكفالة تمتع الأفراد بها..
طبعاً وردت عدّة تعريفات لمصطلح «دولة القانون»، ومنها تعريف الفقيه «جان ريفيرو» الذي عرفها بأنها: «الدّولة التي تكون فيها السلطة العامة مقيّدة بالقاعدة القانونية التي تلتزم باحترامها، وتهدف إلى حماية المواطن من التعّسف»([12]). وعرّفتها جوسلين سيزاري بأنّها: «الدّولة التي تكون فيها القواعد القانونية سارية على الحكام، ومقيّدة لسلطاتهم باسم الاعتراف بالحرّيّات العامة وحقوق الفرد»([13]). ولعل أفضل تعريف جامع لها هو ما نصّت هيئة الأمم المتحدة في أحد تقاريرها على: «أن مفهوم سيادة القانون هو لبّ مهمة المنظمة. وهو يشير إلى مبدأ في الحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الدّولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبَّق على الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنّب التعسّف، والشفافية الإجرائية والقانونية»([14]).
وتقوم دولة القانون المعنية بتطبيق الحقوق والحريات وضمان تنفيذها، على قاعدة المشروعية السياسية، أي الرضى الشعبي الطوعي عنها، وتُبنى سياسياً وإجرائياً على وجود دستور للدولة باعتباره أصل أي نشاط وفعالية قانونية تمارسها الدولة، ومبدأ التدرج في القوانين، ومبدأ المراقبة والمحاسبة والمساءلة الدورية، ومبدأ الفصل بين السلطات، وهو يعني أن توجد سلطة تتولى مهمة التشريع وسلطة تتولى وظيفة التنفيذ، وسلطة تتولى وظيفة القضاء، وغيرها، بما يحقق مبدأً آخر وهو التداول على السلطة مع ثبات الدولة كمؤسسات وهياكل إدارية..
إنَّ دولةَ المواطنة والحكم الصالح (الرشيد) هي دولة القانون والعدل والمؤسسات.. دولة القيم والحقوق لا دولة الشخص والفرد.. وهي البناء السياسي العملي الأضمن والأكثر فعالية لضمان وصول الفرد إلى حقوقه الجوهرية كاملة دون منّيّة من أحد.. وهي دولة العدل التي تعمل على الاستغلال الأمثل لكافة الموارد البشريّة والطبيعيّة والماديّة بما يخدم الشعب والدولة، ويسهم في ازدهار المجتمع وسعادته ورفاهيته..
إن دولة الحقوق هي الدولة التي تبني مؤسساتها على أسس تشاركية تعددية ديموقراطية محورها حقوق المواطن كشريك أساسي في صناعة القرار والمصير.
المبحثُ الرّابع: صناعةُ الفرد الأخلاقي (إصلاح الفرد وتمكينه حقوقياً)
الحقوق كرادع «ضميري» معياري وكمدخل للتّغيير والتّمكين القيمي
لا شكَّ أنّ للأخلاق دوراً نوعياً في بناءِ وصياغة شخصية الإنسان المتوازن والعادل في سلوكه وتصرفاته مع نفسه ومع محيطه الذاتي والموضوعي، وقد وضعَ الإسلامُ الأخلاقَ في مكانة سامية على هذا الصعيد، حيث بنى مجمل منظومته التشريعية والعقيدية عليها، مطالباً بالعمل بالمقتضى، حتى أنه جعل حسن الخلق من الإيمان، في ضرورة أن ينفتح عليها الفرد المسلم من خلال القواعد التي وضعتها الرسالة الإسلامية، والعمل على بلورتها تطبيقياً في واقع الجماعة والأمة ككل، بعد تركيزها في النفوس، وتزكية الإنسان وتربيته وتوجيهه نحو قيمِ الخير والعدل والإحسان، يقولُ تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (الشّمس: 9 ـ 10)، ويقول أيضاً: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى: 14 ـ 15)؛ وقوله تعالى: ﴿وَإنّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْم﴾ (القلم: 4)؛ وقوله تعالى: ﴿بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ…﴾ (آل عمران: 159)؛ وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ (الأحزاب: 21)؛ وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾ (الجمعة: 4).. وقول الرّسول الكريم(ص): «إنّما بعثتُ لأتمّمَ مَكارمَ الأخْلاق»([15]).. وقول أميرُ المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب(ع): «لا تُخلِّقوا أولادَكم بأخلاقِكم فإنّهُم خُلِقوا لزمانٍ غَير زمانِكم»([16]).
..لكنّ تركيز الإسلام على بناء شخصية المسلم من خلال الأخلاق (التي اعتبرها جوهر الدين وعلامة الإيمان)، لا يعني عدم اهتمامه وتركيزه على أثر الحقوق الفردية في تركيز معايير القيم والأخلاق أكثر في الواقع المجتمعي للفرد المسلم.. لأن العلاقة بينهما تكاملية، إذ أنه عندما تتراجع منظومة الحقوق، تتراجع معها منظومتا العقائد والأخلاق.. وهنا يتمثل التخلف الحضاري بأعلى مقاييسه ودرجاته.
فقد خلقَ اللهُ تعالى الإنسانَ وأكرمه بالعقل، ووفّر له سبلَ العيش وموارده، ومسالك الحياة المفتوحة أمامه تهيئةً لإقامة مجتمعات الحق والعدل والحرية والكرامة الإنسانية، ولكن هذا الإنسان طغت عليه مصالحه وأنانياته، واستغرقَ في خصوصيته وجزئياته ونزعاته الأولى، فتضخمتْ ذاتُه وتجبّر في سلوكه وعلاقاته مع نفسه ومع غيره، واعتبر نفسه محور الوجود كله.. نسي اللهَ فأنساه اللهُ نفسه، ونسي أيضاً معنى الوجود وقيمة الحياة وهدف الخَلْق.. وكان بديهياً أن يفضي هذا المناخ من تناقض المصالح وهيمنة الأهواء ـ وبالتالي شيوع الحرمان والتجبر والظلم والتفاوت والتمييز والإفساد ـ إلى اشتعال بؤر الصراعات وتفجُّر حركة العنف في المجتمعات البشرية.. نعم إنه الظلم والتكبر والهوى النفسي، وانتشار المظالم وتضييع الحقوق في كثير من أمم العالم وحضاراته رغم وجود الرسالات والرسل.
وفي مواجهة هذا الواقع، بقيت القيم الدينية المعيارية هدفاً أسمى للمسيرة البشرية رغم ما خالطها من شوائب وتأويلات، وما اعترى تطبيقاتها من ثغرات وأمراض وتعقيدات عملية.. حيث كان يُدْعَى لها على أعلى المستويات والأصعدة الفكرية وغير الفكرية.. كما بقيت الحقوق ـ بالمعنى السلوكي ـ شبه معدومة في كثير من حضارات العالم ومجتمعاته رغم تمكن بعض تلك الحضارات من إعطاء الحقوق قيمة أكبر من حضارات ومجتمعات أخرى.. ولعل التناقض الأكبر الذي وقع عندنا في اجتماعنا العربي والإسلامي، هو عدم الاهتمام العملي الحقيقي ـ لا النظري ـ بمنظومة الحقوق الفردية الإنسانية، وإعطاء القيم الدينية الاهتمام الأكبر والأبرز، بل ومطالبة الفرد الملتزم دينياً بتطبيق القيم دون اكتراث يذكر بواقعه المعاش.. مع العلم أن هذا الفرد ـ الإنسان هو موضوع التطبيق الأخلاقي، مما يقتضي الاهتمام به وتهيئة ظروف ومناخات نجاح عملية معايرته أخلاقياً ـ إذا صح التعبير ـ في مواجهة ظروف حياة وعيش بشري نسبي قاسٍ ومعقد ومتداخل ومتشابك الرؤى والأفكار ومتضارب المصالح، تهيمن عليه قوى طغيانية شهوية ليس سهلاً التعاطي معه فقط بالمواعظ والتحشيد الفكري المضاد..
ومن خلال مراجعتنا للتراث الديني عموماً، وللعقائد الدينية والأديان ومنها ديننا الإسلامي، نجدها غنية بثقافة القيم والحقوق على الصعيد الكلامي النظري، لكنها تبدو فقيرة للأسف بها على الصعيد العملي التطبيقي، إلا ما رحم ربي.
وقد أفضى هذا الواقع العملي الفقير بالحقوق الفردية إلى انكشاف الفرد المسلم وعريه أمام أزمات الواقع وطغيان السلطات القائمة النازعة تاريخياً إلى تكبيل هذا الفرد وتقييده بقيمه وسحب البساط الحقوقي من تحته، إذا صح التعبير.
من هنا أهمية حديثنا هنا عن موضوعة الحقوق موازاةً مع حديثنا عن القيم والأخلاق الإسلامية، وهي تشكل ـ في نظري ـ مرحلة سابقة على التطبيقات القيمية، بل يمكنني القول إنها أهم من القيم في نقطة اشتغالها الأولى. لأنها هي الطريق التي يجب تعبيدها للوصول إلى احترام الناس للقيم الدينية والإنسانية والأخلاقيات الخاصة والعامة.. إذ كيف يمكن أن تُقنع إنساناً جائعاً ومحروماً ومظلوماً ـ ولا يملك قوت يومه ـ بأنه يجب عليه أن يكون أخلاقياً ومطبِّقاً للقيم الدينية وملتزماً بحدود وضوابط معايير الأصالة الأخلاقية؟!!. لا يمكن أن يقتنع.. ولن يكون ـ إذا اقتنع تحت الضغط والرهبة ـ التزامه بها حقيقياً وواعياً وصحيحاً ودائمياً.
ولهذا علينا اليوم التركيز على موضوعة الحقوق كمدخل فعّال ومنتج لإنتاج فرد مسلم ملتزم واقعياً ـ بلا ضغط ولا تكلف ـ بالفضائل الأخلاقية، أي كمدخل لنشر القيم وتطبيقها فردياً ومجتمعياً.. وبهذا المعنى تكونُ الحقوق أهم من القيم على هذا المستوى (في النتيجة والمآل)، لأنها هي التي المقدمة المفروض العمل عليها للوصول إلى فردوس القيم الدينية.
والتجربة البشرية أثبتت في كل حركة التاريخ، أن القيم الإنسانية أو القيم الدينية لا تعمل لوحدها بل تحتاج لمنظومة فعالة وحاضرة ومنتجة من الحقوق الفردية الجوهرية.
من هنا أعطوا الناس حقوقها، واطلبوا منها المستحيل.. أعطوها الحقوق الفردية وعلى رأسها حق الحرية الواعية والمسؤولية وحق العيش الآمن والهانئ والمستقر، مع تلبية حاجاتها المعيشية دونما إذلال ولا منية، ومن ثم حاسبوها استناداً لمنطق العدل والقانون بقوة وحزم دونما هوادة.. وهذه نقطة يمكن اعتبارها اليوم مطلباً حيوياً وملحّاً للغاية لكل ما يتعلق بمجالات ومفردات اجتماعنا الديني والسياسي العربي والإسلامي على طريق تركيز فكرة المواطنة والحكم الصالح في الواقع القائم عربياً وإسلامياً.
ويجبُ أنْ نعلم اليوم، أنّ الإنسانَ أو الفرد العربي المسلم، مقهورٌ في أيامنا هذه أكثر من أيّ زمنٍ مضى بصرف النظر عن الانتماءات والقناعات والخلفيات الفكرية والسياسية الأيديولوجية التي يؤمن بها أو يلتزمها، لأن الأفكار والأخلاق لا تعمل في فضاء اللا حقوق واللا عدالة.. ولهذا هو فاشل وعاطل ومشلول الإرادة وعديم الإنتاج، ومشكلاته العملية الحياتية إلى تزايد وتراكم بلا حلول مجدية حتى تاريخه.. تشوّهتْ معالمه النفسية والسلوكية، وغُرست فيه أسوأ القيم الدونية المبتذلة من حيث شعر أم لم يشعر.. حولوه إلى حقل تجارب.. ليس كمثله مخلوق في العالم، مطلوبٌ منه أن يقدم كل شيء، وهو لا يُعطى ـ ولم يعطَ ـ أقلّ أو أبسط شيء، من الكرامة والحقوق..!!.
إنّ تطبيقَ الحقوق (منحها أو انتزاعها بالقانون) هي مسألة ستعيدُ بناءَ النفس والذّات الفردية على معايير أصالتها الذاتية الفطرية بعدما داخلتها أمراضُ النفس، وشابتها نقائصُ المصالح والدوافع الأولى والأنانيات والمطامع الفردية واستغلال الناس لبعضها بعضاً.. ومن خلال هذه الحقوق الفردية يمكنُ أيضاً إحداث صدمة التغيير المطلوبة للبدء بالسير على طريق النهضة والتقدم المنشود.. لأن إحساسَ الفرد بوجوده وتقدير كرامته وتلبية حاجاته يعطيه الدافع والمحرض للتحرك الفاعل والحثيث وصولاً لتمثُّلِ حركةِ القيم الأخلاقية في واقعه الذاتي والموضوعي.
ومنذ أنْ خُلق الإنسانُ على هذه البسيطة وبدأتْ مسيرةُ تكامله العقلي، وتوازَنَ وعيه وانضبطَ سلوكه الحياتي، منطلقاً لتدبّر معاشه، ونظم أموره، وتأسيس مختلف مواقع وجوده وشؤونه وعلاقاته الخاصة والعامة، كانَ الدّينُ (وهو فطرة بشرية جوانية) ملازماً ومرافقاً لهذا الإنسان، كما كانت الأخلاقُ والقيم الدينية (بصرف النظر عن نوعيتها ودرجاتها وتكاملها) مواكبة لفعله وحركته من حيث بحثه الدائم عن غطاء ديني قيمي يمنحه المبرّرَ الأخلاقي لعمله وحركته، وعن معنى لوجوده وأفعاله ومدى مطابقتها لوعيه الديني ولقيم الأخلاق أو مناقضتها لها..!!. ولكن ما كانَ أخلاقياً في زمنٍ ما، قد لا يكون بنفس المستوى والقيمة الأخلاقية في زمن آخر في مستويات التطبيق والممارسة.. ونحن هنا نتحدث عن تشريعات وقوانين وأنظمة صاغها الإنسان في ماضيات أيامه، حيث أن كثيراً من الحضارات التي مرت في تاريخنا البشري، تعددت قيمها وتنوعت مسلكياتها ومحدداتها الأخلاقية، واختلفت اختلافاً كلياً وربما جذرياً من طور زمني إلى آخر.. ويمكن من خلال مراجعة بسيطة لتواريخ حضارات ومجتمعات سابقة أن نتعرف إلى كثير من تلك التطبيقات الأخلاقية الاجتماعية العملية التي سادت في تلك الأزمان الغابرة، بحيث تبدو اليوم مقززة ومستنكَرة وغير أخلاقية بالمطلق.. وربما حتى في عصرنا الراهن، حيث تسود مجتمعات العالم لغة المصالح وتحكمها شرائع الغاب للأسف الشديد، تتناقض الأسس والمعايير الأخلاقية بين بلد وآخر.. فما هو أخلاقي (مقدس) عند المسلمين وأتباع الديانات السماوية، قد لا يكون على هذا النحو لدى قوى ومجتمعات دولية أخرى.. وها نحن نرى اليوم ونعاين بأم أعيننا هذه الحملات السياسية والإعلامية والاجتماعية المدافعة عن حقوق المثليين، التي ترفع ألويتها كثير من مجتمعات الغرب.. بل ويعتبرونها أخلاقية يجب صيانتها ورعايتها بالقوانين والأنظمة الدستورية الصارمة…!!.
أي أنّ الموضوعَ برمته ارتبطَ بطبيعة النُّظم والقوانين (وآليات التطبيق الاجتماعية) التي أنتجتها المجتمعات البشرية في مسيرتها الحياتية، ورسخت شؤونها بناءً عليها..
هذا يعني أنّ قيم الأخلاق نسبية متغيرة في حركة السلوك والتطبيق، مع بقاء القيمة كمبدأ راسخة في معناها، ولكنها متغيرة ومتحركة في سلوكيات أصحابها والمعتقدين بها..
نقول هذا الكلام طبعاً مع قناعتنا الراسخة بأن الأخلاق والقيم لا يمكنُ أن تغيرها أحوال البشر وطبائعهم وأمزجتهم وأهواؤهم، وهي لا تخضع للقوى الشهوية والغضبية البشرية.. فالعدل كأرقى وأعلى وأهم قيمة أخلاقية هو أمر ثابت وراسخ عبر كل العصور والأزمان والتواريخ، لأنه هو قيمة بذاته بل ويستمدها من علة الكون وخالق الوجود، الله العادل المطلق في عدالته..
ولكن القضية أنّ حركة تطبيق القيم والمعايير الأخلاقية لا شك أن تتغير وتتكيف مع حركة متغيرات الواقع، وهنا نطرح الإشكالية ـ على صعيدنا العربي والإسلامي بالذات ـ بشكلٍ آخر، فنسأل:
هل يمكننا الوصول إلى تمثُّل القيم والفضائل الأخلاقية في مجتمعاتٍ يعاني فيها الإنسان من الظلم والحرمان والطبقية، وتسوده علاقات الفساد والتسلط والتطرف والفوضى والعبث واللا قانون والسلبطة والنهب؟!.. بأي منطق إنساني أو بأية معايير دينية يمكن أن نناقش ونقنع إنساناً بضرورة تمسكه بأخلاق الدين أو بقوانين المجتمع الذي يعيش فيه، وهو يرى بعينيه ويلمس بيديه، الظلم والبؤس والشقاء، ويعاني من الطبقية والتمييز والفساد، بما ينعكس عليه اضطهاداً وانحطاطاً ومظالمَ لا تُحتمل في عيشه ومختلف شؤونه اليومية؟!..
إن تطبيق القيم والفضائل الدينية بصورة مثالية أو على الأقل واقعية نوعاً ما في هكذا مجتمعات أو بلدان تحارب العدل والمساواة، وتتعيش على الظلم والصراعات والتناقضات، وتتقوم بالفساد والنهب، هو أمر غير ممكن وغير وارد بالمطلق..!!. ولا يوجد مجتمع بشري نجحَ في بناء وإقامة أسس العدالة والمساواة مع إنسانه الذي ينتمي إليه، وهو (أي إنسانه) كان يعيش في ظل الخراب والدمار والظلم..!!.
من هنا أهمية التوازن بين الحقوق والقيم.. إذ أنه، قبل أن نطالب وتُطالِبَ الناس بالتربية والثقافة والوعي الحضاري والمدني وضرورة التنشئة التربوية الصحيحة وأهمية تطبيق القانون والالتزام بمعايير الأخلاق والفضائل (وهذا كله مهم للغاية)، عليك تأمين مناخات التطبيق السليمة.. فــبناء وصياغة «الانسان ـ الفرد ـ المواطن» وليس «الإنسان ـ الرعية (العبد)»، أهم من القانون وحتى الأخلاق ذاتها، لأنه أساس الوجود كله، ولهذا فإعطاؤه حقوقه وتأمين احتياجاته ومتطلباته ـ والسعي الحثيث والجدي، في سبيل تنمية قدراته واستثمار طاقاته ومواهبه الخلاقة والمبدعة ـ هو جوهر التطبيقات القيمية والقانونية.. وهذه مسألة مهمة للغاية في الاجتماع البشري، ما زالت مثار جدل وربما رفض داخل مجالنا الثقافي والحضاري الإسلامي، مع أنها تتعلق بأصل ومعيارية الوجود البشر، وبكل مستوياته العملية المؤسسية العامة والذاتية الخاصة، ثقافةً واجتماعاً، اقتصاداً وسياسةً وغيرها… وهنا تحضرني حادثة تاريخية مهمة لها معاني كبيرة.. حيث يُروى ـ في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ـ أنّ والي أو عامل مصر (مثل رئيس مصر حالياً) حضرَ الى الخليفة عمر معتزاً وشامخاً ومفتخراً بتطبيق حدود الله في مصر، وعلى رأسها حد السرقة، وهو قطع اليد..!!.. فما كان من الخليفة إلا أنْ قالَ له بما معناه: نعم، ولكن «إنْ جاءني جَائعٌ من مصرَ، قَطعتُ يدَك..!!.».. إذاً تهيئة الظروف والمناخات أمور سابقة على تطبيق القيم والقوانين، بما يعني أنّ إحقاقَ الحقوق والواجبات أهم وأولى وأسبق في التطبيق على القيمة حتى لو كانت تستمد وجودها وقوتها من النص المؤسس..!!.
وقد لاحظنا أيضاً ـ على سبيل المثال ـ أن رسالة الحقوق للإمام علي زين العابدين(ع)([17])، ركزت في كل أفكارها وطروحاتها على موضوعة الحقوق وضرورة تهيئة الظروف أمام المسلم لنجاح سلوكه الأخلاقي والالتزام بمعايير الأخلاق وقيمها.. فالحقوق هي التي توازن شخصية الفرد، وتسهم في صياغته صياغة وجودية فاعلة ومنتجة من داخله قبل خارجه.. إذ أنَّ المُحتوى الدّاخلي للإنسان هو القوّة المحرّكة والدافعة له في حركة الحياة، وعندما يكونُ هذا المحتوى طيّباً وجميلاً وقائماً على التوازن ومقتضيات الفطرة السليمة، لا بد أن تكون حياة الإنسان الخارجية، في علاقاته وتعاملاته، إيجابية وحسنة ومنتجة، تحقق له السلامة والسعادة المنشودة.. وهذا أمرٌ لا يتحقّقُ إلا في ظلّ ومناخ الحقوق الفردية والمجتمعية، وضرورة تمثّلها في حركة الفرد.
ولعلَّ الدليل الأبرز والأكبر على ما تقدّم هو ما نراه ونشاهده ونلمسه عملياً في واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية على وجه العموم، حيثُ يمكننا ملاحظة أنَّ الفردَ العربي المسلم (الذي لم يرق بعد لمرتبة المواطن الحاصل على حقوقه أو المجسَّدة حقوقه) كثيراً ما يتصرفُ بشكل مضاد لمَصالحه ومصالح وطنه وأمته.. وهو يفعلُ هذا ليس لأنه كاره لوطنه، بل بدافع انعدام حقوقه، وهيمنة شحنة التشوهات والمتناقضات والعاهات النفسية والاجتماعية والتاريخية المتكدسة عليه، التي مر بها، وبقي يعاني منها، والقصور الذاتي الحقوقي الذي هو واقع فيه نتيجة سيطرة مفاهيم وثقافة الاستبداد المقيم والممتد أفقياً وعمودياً على حركته الوجودية ككل، كالضّبط والرّدع والأمر والنّهي والفوقية والنّخبوية و…، إلخ..
وقد أدركَ الإسلامُ هذه الثغرةُ النفسية والسلوكية، ولهذا كانَ يؤكدُ على ضرورة أنْ يحوز الإنسان على حقوقه وعلى رأسها حق الحرية، ليسَ بمعنى أن يتحرر الإنسان من قيود كل شيء ليصبح خاضعاً لأهوائه وقواه الشهوية والغضبية، بل بمعنى أن يحرِّرَ نفسه من هيمنة العبوديات المصطنعة من خلال التوجه لحقّ الله تعالى في مواقع عبوديته كأساس لتحقُّق الحرية الحقيقية والانطلاق لمواقع المسؤولية الحياتية، فيكون حراً في كل حياته من خلال عمق عبوديته وخضوعه للخالق العظيم.. والله تعالى يريد من الإنسان العبودية الكاملة له (وهو حق لله الخالق وواجب على الإنسان المخلوق) ليطلق له حريته الكاملة المسؤولة التي لا يمكن فصلها عن الالتزام الإنساني نحو الله، والقبول بولايته، والتسليم له ولحاكميته الكلية التكوينية والاعتبارية..
نعم، كان الإسلام ـ في تعاليمه ومفاهيمه وتصوراته وأحكامه المتعلقة بحقوق هذا الفرد البشري من الحياة والحرية والكرامة وغيرها ـ أوّلَ منهجٍ عقدي اعترفَ بتلك الحقوق وأقرّهاَ وضَمِنَ للإنسان ممارستها في فضاء من عدالة الدولة في الدنيا، رابطاً إياها مع عدالة الله تعالى في الآخرة.. وهذا ليس اعتباراً أو مجرد فكرة أو رؤية نظرية أو حكائيات تاريخية، بل هو وقائع عملية متبناةً في منهج الرسالة والرسول(ص) وخط أهل البيت(ع)، ضيّعته الأمة في مواقع التزاماتها العملية في كثير من مفاصل التاريخ.. ولعل الشاهد الأكبر يكمنُ في هذه الرسالة الحقوقية العظيمة التي أبدعها وارث النبوة في عصره الإمام علي زين العابدين السجاد(ع)، من حيث أنها رسالة عملية واقعية تخاطب العقل والعاطفة بنفس ووجدان إنساني متأصل وعميق، من أجل بناء نظام إنساني وفقاً لمنهج عقلاني متوازن، بما يجعله قادراً على أن يحرر طاقات الإنسان الذاتية الهائلة، ويفجرها في الواقع العملي إنتاجاً وعطاءً وحركة إيجابية خيّرة مستمرة.. تبني الحياة من موقع الحرية والوعي والمسؤولية والعدل والتوازن والمساواة.. وهذه هي القيمة الأكبر التي يمكننا استنتاجها من رسالة الحقوق وهي قيمة وحق العدل، عدل الإنسان مع نفسه، ومع غيره، ومع كل مفردات الحياة من حوله.. فالله تعالى أقامَ الوجودَ كله على هذه القيمة العظيمة التي هي أساسُ وجوهر كلّ الرّسالات الدينية، وطلبَ من الإنسان أن يتحرك في خط العدل الذاتي والموضوعي، في علاقاته وآليات وسبل عمله، وسياساته، وبرامجه وخططه وتنظيمه لكل شؤون وجوده الفاعل.. يقول تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحديد: 25). فالله تعالى يؤكد في الآية على أن هدف الأديان كلها وغاية إرسال الرسل والأنبياء كلهم تكمن في إحقاق العدل وإقامة مجتمعاته ودوله في تحرير الإنسان والمجتمعات والحضارات من الأغلال والقيود التي فرضت عليهم وعلى رأسها قيود الظلم والحرمان وهيمنة قوى الشر والقوى الغضبية والشهوية في داخل الإنسان نفسه؛ وتذكير الناس على الدوام (من خلال الأنبياء والرسل والأئمة والكتب السماوية المقدسة، بالإضافة إلى موهبة التمحيص العقلي)، بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، في معانيها وميثاقها، أنْ عودوا للعدالة الإلهية ولميثاقها الذي أشهد اللهُ الإنسان عليه لتوحيده والإقرار بربوبيته والإيمان بكل مقتضيات ومتطلبات هذا الإقرار الذّرّي([18]).. يقول الإمام علي(ع): «ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول»([19]).
خاتمة البحث
تعاني الأخلاق من ثغرات عملية في موضوعة التطبيق، تتمثل في ضعف الحافز الفردي لتجسيدها في حركة الواقع ذاتياً وموضوعياً.. هنا تأتي الحقوق لتكون محفزاً ودافعاً وأرضية صلبة لتمثل الفرد للقيم والمعايير الأخلاقية في سلوكه وعلاقاته..
هذه المشكلة هي من أهم مشكلات عدم تحقق الاستقرار الأخلاقي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.. وبالتالي تحقق الاستقرار الاجتماعية من خلال المصالحة بين الأخلاق والحقوق.. وعدم إحداث فصل بينهما في المقدمة والمآل.
وحتى المشكلات والأزمات الاجتماعية والمعيشية والسّياسية المتفاقمة في كثير من بلداننا، لا يمكنُ حلّها إلا بتكامل ثنائية الأخلاقي والحقوقي.. أي بتحقيق العدالة والتنمية.. إذْ طالما هناك حرمان وظلم وإقصاء، لن يكونَ هناك سلامٌ ولا تنمية ولا أمان ولا ازدهار ولا أخلاق.. وحتى تتحقق تلك الطموحات الكبرى لا بد من تحقيق السلام المجتمعي السياسي الداخلي، وإلا ستبقى مجتمعاتنا تتنقل من فشل إلى آخر ومن هزيمة إلى أخرى، وسيظل العرب والمسلمون متطفلين على موائد الآخرين، منفعلين وتابعين غير منتجين ولا فاعلين..
نعم، لا تطور حقيقي بلا تنمية حقيقية.. ولا تنمية بلا بناء مهارات «الفرد ـ المواطن».. ولا بناء فعال ومنتج للمواطن بلا توعيته على قيم الخير والحق والجمال، وتنظيم حياته وتربيته على المبادئ الوطنية العليا، وبث روح العمل والمبادأة والمبادرة والثقة.
وهذه الاخيرة لها شرط جوهري هو:
إعطاؤه حريته وصون كرامته، ونيله لحقوقه ومن ثم محاسبته على العمل والأداء والنتيجة..
الهوامش
([1]) باحثٌ وكاتبٌ في الفكر العربيّ والإسلاميّ. من سوريا.
([2]) فيصل العوامي، مفهوم الحق، دراسة منشورة على موقع الشيخ فيصل العوامي، ص11، تاريخ المشاهدة: 29 ـ 7 ـ 2023م، الرابط:
https://alawami.org/ar/index.php/post/8754
([3]) مجموعة من المؤلفين، الإسلام وحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13، تاريخ: 2003م، ص224، بتصرف.
([4]) محمد كمال الدين جعيط، الإسلام وحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية، منشورات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السعودية ـ الرياض، طبعة عام 2012، ص12 ـ 13.
([5]) عواد يوسف، حقوق الإنسان في الحياة التربوية، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن ـ عمان، طبعة عام 2008م، ص55.
([6]) عبد العالي المتقي، مفهوم الحق الطبيعي وفلسفة حقوق الإنسان في الفكر الغربي ـ مقاربة أولية، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود، تاريخ النشر: 29 ـ 12 ـ 2017م، تاريخ المشاهدة: 14 ـ 8 ـ 2023م، الرابط:
https://www.mominoun.com/articles
([7]) صفاء الدين محمد عبد الحكيم، حق الإنسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دولياً، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ـ بيروت، طبعة عام 2005م، ص34.
([8]) جون لوك، الحكومة المدنية، ترجمة: محمود شوقي الكيال، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، مصر ـ القاهرة، بلا تاريخ، ص15.
([9]) عبد العالي المتقي، مفهوم الحق الطبيعي وفلسفة حقوق الإنسان في الفكر الغربي ـ مقاربة أولية، موقع مؤمنون بلا حدود، مصدر سابق، نقلاً عن: دينيس لويد، فكرة القانون، ترجمة سليم الصويص، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، الكويت، العدد: 47، تشرين ثاني لعام 1981، ص78.
([10]) الزاهيد مصطفى، الأسس الفلسفية لمفهوم الحق، الشرق الأوسط، تاريخ النشر: 31 ـ 12 ـ 2016م، تاريخ المشاهدة: 17 ـ 8 ـ 2023م، الرابط:
https://aawsat.com/home/article/817596
([11]) عتو رشيد، تجسيد دولة القانون ضمان لحماية الحقوق والحريات، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد6، العدد2، عام 2021م، ص401.
([12])A bderrahim FATAHINE، L’apport de la constitution algérienne de 1989: L’instauration de l’Etat de droit، Mémoire présentée pour l’obtention du magistère، Faculté de droit et des sciences administratives، Université d’Alger، 2001 ـ 2002، p 15.
([13])J ocelyne CESARI، L’Etat de droit en Algérie: Quels acteurs et quelles stratégies? L’Etat de droit dans le monde arabe، CNRS édition، Paris، 1997، p 257.
([14]) انظر: الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة، (s/2004/616) النسخة العربية، وهو بعنوان: سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، المحال على مجلس الأمن المنعقد في جلسته بتاريخ 23 آب 2004م، ص5 ـ 6.
([15]) حديث صحيح، ورد في كثير من المظان التاريخية الموثوقة، راجع: محمد بن سعد الزهري، الطبقات الكبرى، مكتبة الخانجي، مصر ـ القاهرة، طبعة عام 2001م، ج1، ص192.
([16]) محمد الريشهري، موسوعة الإمام علي(ع) في الكتاب والسنة والتاريخ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ـ القاهرة، طبعة عام 2001م، ج10، ص236.
([17]) وهي من أهم معالم تراث الإسلام في التنظير الفكري والمعرفي للمسألة الحقوقية.. وقد اتّفقت المصادرُ والمظانُ التاريخية الحديثيّة على نسبة هذه «الرسالة ـ الكتاب» إلى الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.. وجاء هذا التوثيق والإسناد برواية أبي حمزة الثُمالي (ثابت بن دينار الشهير بابن أبي صفيّة الأزدي الكوفي)، صاحب الدعاء المشهور باسمه الذي يتلى في أسحار شهر رمضان المبارك، وقد توفّي عام (١٥٠) للهجرة، وهو التقى خلال حياته بالأئمة، السجّاد والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام.. وقد ذكر النجاشي في رجالاته أنه كان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث، وروى عنه العامّة. (أنظر: أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران ـ قم، طبعة عام 1997م، ص115، رقم296)؛ وقد نَسبَ الرسالة (الكتاب) إلى الإمام السجاد النجاشيُّ باسم «رسالة الحقوق» عن علي بن الحسين عليهما السلام، ثم أسند روايتها إليه.. لكن المنقول عن الكليني أنّه أوردَها في ما جمعه باسم «رسائل الأئمة عليهم السلام»، مما يدلّ على كون الكتاب «رسالة» بعثها الإمام عليه السلام الى بعض أصحابه. (انظر: الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، إنكلترا ـ لندن، طبعة أولى لعام 1987م، ج11، ص169).. وروى هذه الرسالة أيضاً «المتوكلُ بن عمير»، وينتهي سندُها إلى الإمام محمد الباقر(ع)، وزيد الشهيد بن الإمام علي بن الحسين عن أبيهما علي بن الحسين(عليهم السلام).. وقد وردَ نصُّ الرّسالة في كتاب «الخصال» للشيخ الصدوق. (راجع: محمد علي القمي، الخصال، تصحيح وتعليق: علي أكبر غفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران ـ قم، طبعة عام 1982م)، وفي كتاب «تحف العقول» لأبي شعبة الحراني. (راجع: الحسن بن علي بن شعبة الحرّاني، تحف العقول عن آل الرسول، تقديم وتعليق: حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للطباعة والنشر، لبنان ـ بيروت، طبعة سابعة لعام 2002م، ص184).. وأُلقيتْ على الرسالة عدة شروحات، كما أنها تُرجمت إلى عدة لغات.
([18]) نسبة إلى عالم الذّر (عالم الميثاق) الذي قطعَ الإنسانُ فيه العهدَ والميثاقَ لربه تعالى حسب ما تحدثت كثير من الروايات، في أن يوحّده ويؤمن بربوبيته، فلا يتغافل ولا يشغله عنه شاغل ولا مانع.. يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف: 172).
([19]) ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، دار الكتاب العرب، لبنان ـ بيروت، طبعة عام 2007م، ج1، ص23.