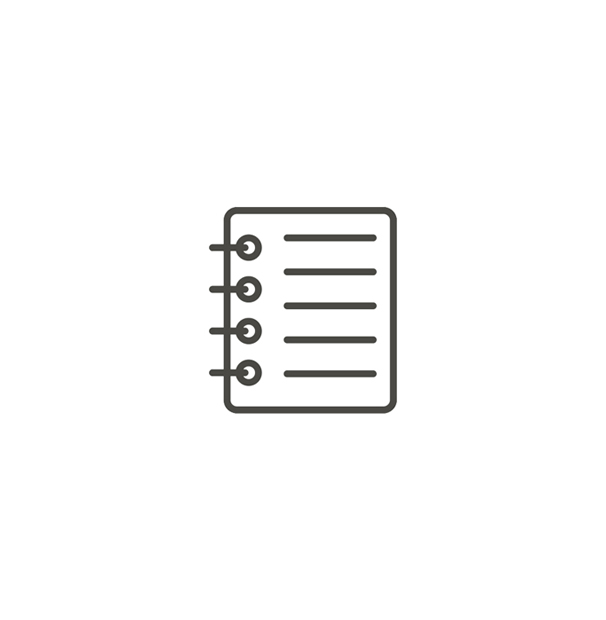أ. مشتاق بن موسى اللواتي(*)
لقد ورد حديث الافتراق، أو حديث الفرقة الناجية، في مصادر متعدِّدة للحديث عند المسلمين من مختلف المدارس الفكرية.
فقد أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده؛ كما رواه أحمد في مسنده، وكلٌّ من الترمذي وابن ماجة وأبي داوود في سننهم؛ ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.
وأخرجه الكليني في الكافي؛ والصدوق في الخصال ومعاني الأخبار.
وأقدم نصٍّ وردنا منه هو ما في مسند الربيع بن حبيب(175هـ). وهذا هو نصّه: «ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلُّهنّ إلى النار، ما خلا واحدة ناجية، وكلُّهم يدّعي تلك الواحدة»([1]).
وقد تعدَّدت طرقه، وتنوَّعت ألفاظه وألسنته. وعلى الرغم من ذلك فقد واجهت رواياته بعض المشكلات، سواء من ناحية السند أو المتن. كما تعرَّضت لنقود عدّة من جهة السند، والمتن، والتطبيق، والآثار التي تتركها في الأمّة. وبناء عليه اختلفت تقييمات العلماء والمحدِّثين له، على النحو التالي:
أوّلاً: المصحِّحون له، والمحتجّون به
فقد صحَّح وحسَّن بعض رواياته جماعة من المحدّثين، كالحاكم في مستدركه، والترمذي في سننه، وابن حِبّان في صحيحه. ولكنْ تجدر الإشارة إلى أن الرواية التي علَّق عليها الحاكم بأنها كثيرة الأصول، وصحَّحها الترمذي، لم تشتمل على عبارة «كلّها في النار إلاّ واحدة». كما أن الذهبي تعقَّب الحاكم حول أحد رواتها، وهو محمد بن عمرو، قائلاً: «ما احتجّ مسلم به منفرداً، بل بانضمامه إلى غيره»([2]).
كما أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده أو في الجامع الصحيح الذي يعتبر أصحّ كتب الحديث رواية، وأعلاها سنداً، عند الإباضية، كما صرَّح الشيخ السالمي في تنبيهاته على الكتاب.
واعتبر شارحه السالمي الحديث من أعلام النبوّة؛ لأنه أخبر عن شيء من الغيب، فوقع مشاهداً([3]).
وسئل ابن تيميّة عنه فأجاب بأنّ الحديث صحيحٌ مشهور في السنن والمساند، كسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وغيرهم. وأشار إلى بعض ألفاظه، منها: ما اشتمل على عبارة «وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة، كلّها في النار إلاّ واحدة»؛ وفي لفظ: «على ثلاث وسبعين ملّة»؛ وفي رواية: قالوا يا رسول الله|: مَنْ الفرقة الناجية؟ قال: مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ وفي رواية: قال «هي الجماعة، يد الله على الجماعة»([4]).
واستدل به الفقيه المقاصدي الشاطبي في الموافقات، في بحثه عن حجّية سنّة الصحابة. وعلَّق عليه شارحه بالقول: للحديث طرق كثيرة، من رواية كثير من الصحابة، بألفاظٍ متقاربة، وممَّنْ رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وقال الترمذي: إنّه حسن صحيح([5]).
ونقل عن العلامة المجلسي تعليقه على إحدى روايات الصدوق: «إن أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء، وإنْ لم يكن صحيحاً بزعم المتأخِّرين»([6]).
وممَّنْ صحَّحه من المعاصرين المحدِّث السلفي الألباني، وأدرجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وعلَّق على الرواية الأخرى للترمذي، والتي اشتملت على عبارة «كلّها في النار إلاّ ملّة واحدة، ولمّا سئل عنها، قال: «ما عليه أنا وأصحابي»، قال الألباني في تعليقه: «ضعيفٌ بهذا السياق. وقد حسَّنه الترمذي في بعض النسخ، وهو ممكنٌ باعتبار شواهده، ولذلك أوردتُه في صحيح الجامع». وعلَّق على رواية معاوية بن أبي سفيان، وهي أيضاً تشتمل على عبارة «كلّها في النار إلاّ واحدة، وهي الجماعة» بقوله: «صحيح». ولم يعبأ الألباني باشتمال سندها على أزهر بن عبد الله الهوزني المعروف بالنَّصْب، و ذكر بأنّه وثَّقه العجلي وابن حِبّان. و قال فيه الأزدي: يتكلَّمون فيه، و قال ابن حجر في التقريب: صدوق، تكلَّموا فيه؛ للنصب. ولم يصحِّحه الحافظ في تخريجه على الكشّاف، بل اكتفى بتحسينه. غير أنّ الألباني اعتبر النَّصْب مجرّد رأي، ولم يرَ مانعاً من تصحيحه طالما كان صدوقاً([7]).
واستشهد به الشيخ أبو زهرة في سياق حديثه عن اختلاف المسلمين، وذكر بأن علماء السنّة تكلَّموا في صحّة هذا الحديث، الذي روي بعدة روايات مختلفة. وأضاف: ولقد قال المقبلي: رواياته كثيرة يشدّ بعضها بعضاً، بحيث لا يبقى ريب في حاصل معناه»([8]). ولكنْ تجدر الإشارة بأنّ النصّ الذي أورده لم يشتمل على عبارة «كلّها في النار إلاّ واحدة».
واعتبره الدكتور البوطي وصيّة النبي| في الاقتداء بالسلف، والانضباط بقواعد فهمهم للنصوص، والتقيّد بمبادئهم. واستدلّ بما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، وذكر أن فيه الإفريقي الذي ضعَّفه أكثر علماء الحديث، ولكنْ رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داوود بطرقٍ أخرى من حديث أبي هريرة، بألفاظ قريبة، وصحَّحه الترمذي، وقال: حسن صحيح([9]).
وصرَّح الكاتب الهلالي بأنه مستفيض، فقد ورد من حديث أبي هريرة ومعاوية وأنس بن مالك وأمامة الباهلي وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن عوف وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء ووائلة بن الأسقع، ورواية هذا الجمع، الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ترقى بالحديث إلى حدّ التواتر أو ما هو قريبٌ منه([10]).
ونظراً إلى كثرة طرقه ورواياته في مصادر المسلمين ادّعى بعضهم، كابن البطريق، الإجماع عليه. وذهب السيد نعمة الله الجزائري إلى تواتره([11]). وذهب بعض المتأخِّرين من الزيدية، مثل: الشيخ أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة، إلى أنّ الأمة مجمعةٌ على صحّته. ورأى الشيخ يحيى بن حمزة أنّ الأمّة تلقَّته بالقبول([12]).
وأورد العلاّمة المجلسي جملة من روايات افتراق الأمّة من مصادر الفريقين، وأيَّدها بما ورد عند الفريقين أيضاً عن إخبار النبيّ| حول اتباع هذه الأمة سنن الأمم السابقة شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، مشيراً إلى تواتر الأخيرة([13]).
ولكنّ السيد الخوئي ردَّ الدعوى بتواترها بقوله: «ودعوى التواتر فيها جزافيّة لا دليل عليها، ولم يذكر من هذه الروايات شيءٌ في الكتب الأربعة»([14])، ممّا يوضِّح لنا أن بعض دعاوى التواتر ليست موضع اتّفاق العلماء، بل وقعت مورد نقدٍ وردّ من بعض العلماء المختصّين.
وممّا سبق يتّضح لنا أنّ أكثر الذين صحَّحوا هذه الروايات سلكوا طرقاً تصحيحية غير مباشرة، أقرب إلى منهج الوثوق منه إلى منهج الوثاقة وصحّة الإسناد؛ وذلك بالنظر إلى كثرة الروايات والطرق والألفاظ، وتعاضدها وشدّ بعضها بعضاً، وانجبار ضعفها، أو تحقّق مصاديقها في الواقع حسب نظرهم، أو تأييدها بروايات أخرى، وما إلى ذلك من القرائن والشواهد.
ثانياً: النقود الموجَّهة إلى سنده
لقد وُجِّهت إليه نقودٌ كثيرة من ناحية السند. واختلف العلماء في صحته، إلى درجة أن بعضهم يقول: إنه لا يصحّ من جهة الإسناد أصلاً؛ لأنه ما من إسناد روي به إلاّ وفيه ضعيفٌ، وكلّ حديث هذا شأنه لا يجوز الاستدلال به([15]). ومن القائلين بذلك الفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي، الذي يقول: «ذكروا حديثاً عن رسول الله| أنّ القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمّة، وحديثاً آخر: تفترق هذه الأمّة على بضع وسبعين فرقة كلّها في النار حاشا واحدة، فهي في الجنّة»، ثم قال: وهذان حديثان لا يصحّان أصلاً من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجّةً عند مَنْ يقول بخبر الواحد، فكيف بمَنْ لا يقول به»([16]). ومع ذلك فقد احتجّ ابن حزم بإحدى روايات افتراق الأمّة في بطلان القياس في كتبه الأصولية والفقهية. ففي الإحكام استشهد بحديث «تفترق أمّتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة قومٌ يقيسون الأمور برأيهم، فيحلّون الحرام، ويحرِّمون الحلال»، وصرَّح بوثاقة أحد رواته المعروفين بالنَّصْب عند علماء الحديث، وهو حريز بن عثمان. وقال عنه: إنّه ثقة، وقد روينا عنه أنه تبرّأ ممّا نسب إليه من الانحراف عن عليّ.
كما احتجّ به في المحلّى. غير أنّ المحقق الأستاذ أحمد محمد شاكر عقَّب عليه في الهامش بقوله: «رجال إسناد الحديث ثقات كلّهم، إلاّ أنّه حديثٌ ضعيف جدّاً»، وذكر آراء عدد من أئمّة الجرح، كأبي زرعة، ويحيى بن معين، بأنه لا أصل له، وأن نعيم بن حماد قد اشتبه عليه، ونسبه بعضهم إلى الوهم. وأيّاً كان فيلاحظ أنّ هذه الرواية لم تشتمل على الزيادة المختلف فيها، والتي تصرِّح بهلاك الجميع، ما عدا واحدة.
وتناول السيد السقّاف كثيراً من طرقه مبيِّناً نقاط ضعفها من ناحية السند. فذكر بأنّ هذا الحديث رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو ضعيفٌ.
ورُوي عن معاوية مرفوعاً، وفي السند أزهر بن عبد الله الوزني، وهو أحد كبار النواصب، الذين كانوا ينتقصون من سيِّدنا عليّ×، وله طامات وويلات، كما أورده ابن الجارود في الضعفاء.
ورُوي عن أنس بن مالك من سبعة طرق، كلّها ضعيفة، ولا تخلو من كذّاب أو وضّاع أو مجهول.
ورُوي عن عوف بن مالك مرفوعاً، وفي سنده عبّاد بن يوسف وهو ضعيف، أورده الذهبي في ديوان الضعفاء.
ورُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً عند الترمذي في السنن، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
ورُوي عن ابن أمامة مرفوعاً عند ابن أبي عاصم في السنّة، وفي إسناده قطن بن بشير، وهو ضعيف ومنكر الحديث. وقد قال عنه البخاري: منكر الحديث.
ورُوي عن سيِّدنا عليّ(كرّم الله وجهه) عند ابن أبي عاصم في السنّة، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيفٌ جدّاً»([17]).
وناقش العلماء بعض الطرق التي استند عليها الفريق الأوّل في تعزيز طرق الحديث.
فقال الشيخ زاهد الكوثري: «وأمّا ما ورد بمعناه، في صحيح ابن ماجة وسنن البيهقي وغيرهما، ففي بعض أسانيده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفي بعضها كثير بن عبد الله، وفي بعضها عبّاد بن سيف وراشد بن سعيد، وفي بعضها الوليد بن مسلم، وفي بعضها مجاهيل، كما يظهر من كتب الحديث»([18]).
ونقد الشيخ القرضاوي طرق التصحيح غير المباشرة المتقدِّمة، ولم يقبلها. فالحديث وإنْ قال فيه الترمذي: حسنٌ صحيح، وصحَّحه ابن حِبّان والحاكم، مداره على محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي، ومَنْ قرأ ترجمته علم أن الرجل متكلَّم فيه من قِبَل حفظه، وأنّ أحداً لم يوثِّقه على الإطلاق، وكلُّ ما ذكروه أنهم رجَّحوه على مَنْ هو أضعف منه، ولهذا لم يزِدْ الحافظ في التقريب على أنْ قال: صدوق، له أوهامٌ، والصدق وحده في المقام لا يكفي ما لم ينضمّ إليه الضبط، فكيف إذا كان معه أوهام. ومعلومٌ أنّ الترمذي وابن حِبّان والحاكم من المتساهلين في التصحيح. وقد رُوي الحديث بهذه الزيادة، وهي «كلّها في النار إلاّ واحدة» من طريق عدد من الصحابة، عبد بن عمرو ومعاوية وعوف بن مالك وأنس، وكلّها ضعيفة الإسناد، وإنّما قوّوها بانضمام بعضها إلى بعض. والتقوية على كثرة الطرق ليست على إطلاقها، فكَمْ من حديثٍ له طرق عدّة ضعَّفوه، كما يبدو ذلك في كتب التخريج والعلل وغيرها، وإنّما يؤخذ بها في ما لا معارض له، ولا إشكال في معناه»([19]).
ويظهر أنّ العلاّمة السبحاني مال في البداية إلى تقوية سنده، وجبر ضعفه، بناءً على تضافر نقله، واستفاضة روايته، في كتب الفريقين: الشيعة؛ والسنّة، وبأسانيد مختلفة، ربما تجلب الاعتماد، وتوجب ثقة الإنسان به. ولكنّه، وبعد البحث في مضامين الروايات، وفحص نصوصها، لاحظ اختلافها من جهاتٍ شتّى، بحيث لا يمكن الاعتماد على واحدٍ منها.
ويلتقي الشيخ الخشن مع هذه النتيجة، فيرى أنّ دعوى تواتر الحديث مجازفةٌ، ولولا الملاحظات الواردة على متنه، من اضطراب وعلامات الوضع وغيرهما، لم يكن بعيداً حصول الوثوق بصدوره، بعد تضافر روايته من طرق الفريقين([20]).
أمّا بالنسبة إلى ما رواه الصدوق في الخصال فإنّ العلاّمة الصافي في بحثه حول حديث الافتراق انتهى إلى أنّ كلا الطريقين للصدوق فيهما عدّة مجاهيل، ومجروحين لا اعتبار برواياتهم([21]).
وإحدى روايات الصدوق تنصّ على افتراق الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة. وهذه في طريقها بكر بن عبد الله، وهو مجهول. كما اشتملت على تميم بن بهلول، وهو مجهول، فقد ذكره التستري في قاموس الرجال، وأشار إلى أنّ حديثه منكر، وذكر في ترجمة أبيه أنه ليس له، ولا لابنه، ذكرٌ في الرجال، وقال: خبرهم منكرٌ. ومن رجال هذه الرواية بكر بن عبد الله، وهو مجهول أيضاً([22]).
والرواية الثانية تنصّ على افتراق الأمّة على اثنتين وسبعين فرقة، وهي من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك. وهي نفس الرواية التي رواها أحمد في المسند، مع اختلاف يسير جدّاً في بعض الألفاظ، من قبيل: إن رواية أحمد كرّر فيها لفظ الجماعة مرّتين، بينما في رواية الصدوق ثلاث مرّات. كما أن رواية أحمد في طريقها خالد بن يزيد، بينما رواية الصدوق فيها مجاهد بن أعين، ومحمد بن الفضل، وأبو لهيعة، ولم يَرِدْ ذكرٌ للأوّل والأخير في الأصول الرجاليّة. وسعيد بن أبي هلال تكلَّم فيه أحمد، وضعَّفه ابن حزم، كما أن روايته عن أنس مرسلةٌ، كما في التهذيب واللسان([23]).
والجدير بالذكر أنّ للصدوق روايةً ثالثة بسندٍ آخر، وقد سبقت الإشارة إليها، لم يلتفت إليها كثيرٌ من الباحثين؛ لأنّها وردت في باب مختلف. وقد أوردها الصدوق عن أمير المؤمنين×، ضمن رواية طويلة جاوزت خمساً وعشرين صفحة، تضمَّنت إحدى فقراتها مضمون حديث الافتراق على النحو التالي «افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنّة». أمّا سندها فهو: حدّثنا أبي (والد الصدوق) قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: حدّثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله× قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، أنّ أمير المؤمنين…».
وقد وصفها الشيخ وهبي بالمعتبرة([24]). ولكنّ البحث في رواتها يكشف عن وجود اختلافٍ بين العلماء في ذلك.
وقد نقل عن العلامة المجلسي أنّ أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء، وإنْ لم يكن صحيحاً بزعم المتأخِّرين».
والواقع أن الخلاف في سندها ليس جديداً، كما سيتّضح لاحقاً، وإنْ كانت طريقة القدماء في التوثيق يغلب عليها أسلوب الوثوق بالخبر المعتمد على القرائن المحفوفة والشواهد الموصلة إلى الوثوق بصدورها، من قبيل: ورودها في أحد الأصول المشهورة، وكون رواتها من شيوخ الإجازة، وتلقّي الأصحاب لها بالقبول، وعدم تعارضها مع الكتاب والسنّة المقطوع بها والعقل، وما إلى ذلك. أمّا المتأخِّرون فكثير منهم اعتمد على وثاقة الطريق، طبقاً للتقييمات الرجالية، جرحاً وتعديلاً، وبناء على توافر شروط الحجّية وعدمها.
وعلى كلّ حال فقد اختُلف في اثنين من رواتها، وهم: محمد بن عيسى اليقطيني؛ والقاسم بن يحيى.
فالأوّل وثَّقه النجاشي، وقال: «ثقة، عين، جليل في أصحابنا، كثير الرواية، حسن التصانيف. وقال الكشّي: كان الفضل بن شاذان يحبّه، ويثني عليه، ويمدحه، ويميل إليه. ولكنْ نقل النجاشي عن الصدوق، عن شيخه ابن الوليد، أنه قال: ما تفرَّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يُعتمد عليه. الأمر الذي جعل الشيخ الطوسي يصرِّح بتضعيفه. وقيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة.
وناقش السيد الخوئي ذلك، وانتهى إلى أن عمدة تضعيفه مستند على استثناء ابن الوليد شيخ الصدوق لما تفرَّد به عن يونس. وهذا يعني أنّ النقاش ليس فيه شخصياً، إنما في ما يرويه عن يونس بإسناد منقطع، إلاّ أن يونس يرويه مرسلاً. وممّا يؤكد ذلك أنّ الصدوق روى عنه في الفقيه من غير طريق يونس. وقد تخيَّل الشيخ الطوسي بأن استثناء ابن الوليد له مبنيٌّ على تضعيفه، وهو ليس كذلك، بل هو مبنيٌّ على اجتهاد ابن الوليد([25]).
أمّا القاسم بن يحيى فقد ضعَّفه ابن الغضائري، وتابعه العلاّمة الحلّي على ذلك. ولكنّ جمعاً من العلماء لا يعتدّون بتضعيفاته؛ لعدم ثبوت نسبة كتاب الضعفاء إليه؛ ولأسباب أخرى. وفي المقابل نجد أنّ بعض المتأخِّرين قد وثَّقوه، كالبهبهاني في تعليقته الرجالية، والسيد الخوئي في معجمه، كلٌّ حسب مبناه. فالبهبهاني وثَّقه بناءً على عدد من الشواهد، من قبيل: رواية الأجلّة عنه، وكثرة رواياته، والإفتاء بمضمونها، وعدم تضعيف المشايخ الماهرين بأحوال الرجال له. أمّا السيد الخوئي فقد وثَّقه بناءً على توثيق ابن قولويه لرجال كامل الزيارات، وأيَّد ذلك بحكم الصدوق بصحّة ما رواه في زيارة الحسين× في الفقيه عن الحسن بن راشد، وفي طريقه إليه القاسم بن يحيى، بل ذكر أنّها أصحّ الزيارات عنده([26]). وتجدر الإشارة إلى أنّ السيد الخوئي قد عدل عن مبناه الأوّل بتوثيق جميع رواة كامل الزيارات، مكتفياً بتوثيق شيوخه المباشرين.
وهكذا نجد أن هذا السند أيضاً وقع مورداً للأخذ والردّ، ولم يسلم من الاختلاف بين العلماء، بين مصحِّح ومضعِّف.
وبالنسبة إلى ما رواه الصدوق في معانيه، عن عبد الله بن عمر، والتي مطلعها «سيأتي على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل، ويحدِّد في نهايتها الملّة الناجية بقوله: «ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي»([27])، فيظهر أنّها نفس الرواية التي رواها كلٌّ من الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مع اختلافٍ يسير في سندها ومتنها. فسند الصدوق ينتهي إلى عبد بن عمر، ولعلّه تصحيف في أحدهما. كما أنّ في سندها عند الجميع الإفريقي عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، وقد ذكر الحفّاظ أنّ الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلاّ من طريق الإفريقي، عن ابن يزيد، عن عبد الله، فقال الترمذي: إنّه حديث مفسّر غريب، لا نعرف مثل هذا إلاّ من هذا الوجه. وقال الحاكم: إنّه تفرَّد به الإفريقي، وهو ممَّنْ لا تقوم به حجّة. ونصّوا على تضعيفه، ومنعوا من الاحتجاج به([28]). ويلاحَظ أن روايتين من أصل أربع روايات أوردها الصدوق في كتابَيْه في هذا الصدد هما من طرق غير الإماميّة.
أمّا سند الكليني في الكافي فقد ذكر الشيخ الخشن بأنه ضعيفٌ بأبي خالد الكابلي، الذي لم تثبت وثاقته([29]). كما أنّ البهبودي لم يُدرِج هذه الرواية في كتابه (زبدة الكافي) أو (صحيح الكافي).
وفي المقابل وصف الشيخ وهبي سند الكافي لهذه الرواية بالمعتبر([30]).
ولعلّ مردّ ذلك إلى اختلاف العلماء في بعض قواعد التوثيق والتضعيف. فقد يُقال: إنّه لم يرِدْ في الكابلي توثيقٌ أو مدح صريح بهذا الاسم في أيٍّ من الأصول الرجالية. بل قال عنه ابن شهرآشوب: «ينتمي إليه الغلاة، وله كتاب»([31]).
نعم، ورد في الكافي عن أبي عبد الله×: كان سعيد بن المسيّب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقاة عليّ بن الحسين×.
ولكنّ الرواية ضعيفةٌ؛ بجهالة إبراهيم بن الحسن([32]). وفي رجال الكشي ما مفاده أنه كان يعتقد بإمامة محمد بن الحنفية، ولما عرف حقيقة الإمام السجّاد شكر الله تعالى، واعتقد بإمامته، وزار الإمام، فعرفه، وأخبره باسمه من دون لقاءٍ سابق بينهما. ولكنْ قد يُقال: إنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الواقعة بأنّه كان صحيح الاعتقاد في الإمامة، ولا تدلّ على التوثيق.
وفي المقابل ذكر السيد الخوئي أنّ أبا خالد الكابلي روى عنه عبد الحميد الطائي في تفسير القمّي([33]). وهذا قد يدرجه ضمن التوثيق العامّ للقمّي. وذكر في ترجمة كنكر أنه يكنّى أبا خالد الكابلي، روى عنه ضريس في كامل الزيارات([34]). وصرَّح في موردٍ آخر بوثاقته، قال: «وعلى فرض الترديد بين كون أبي خالد القمّاط كنيةً ليزيد أو كنكر لا يضرّ؛ فإنّ كلَّ واحد منهما ثقةٌ([35]). أضِفْ إلى ذلك قد يقال بوجود شواهد تؤكِّد بأنّ أبا خالد الكابلي هو نفسه أبو خالد القمّاط، الذي نصّ النجاشي على توثيقه([36]). هذا عن حال سند هذه الروايات. وهناك رواياتٌ أخرى في هذا الموضوع، في بعض كتب الأمالي وبعض المصادر المتأخِّرة، ولكن لا تخلو أسانيدها من مقال.
وممّا سبق نخلص إلى القول بأنّ أبرز روايات الإمامية حول افتراق الأمّة هي الأخرى لم تسلم من المناقشة والنقد، والاختلاف في التقييم من حيث الإسناد، كما اتّضح من الشواهد المتقدِّمة.
وهنا أودّ تسجيل استغرابي ممّا انتهى إليه الكاتب خميس العدوي، حيث استنتج رأي الإمامية من خلال رأي أحد الباحثين منهم، وعمَّمه على الإماميّة بشكلٍ عامّ!
قال: «والحقُّ لم أقِفْ على تحليلهم السندي لهذه الروايات، حتّى ألقي عليه هنا لمحة، ولكنّي اكتفي بما كتبه مالك وهبي». وبعد عرضه لبعض ما نقله الشيخ وهبي من روايات الفريقين، ولبعض دعاوى الإجماع أو التواتر في نقلها، قال: «ومن كلامه هذا يظهر أنه لا علّة في سند الحديث عند الشيعة، وإنْ كان يبدو مشككاً في دعوى إجماع نقل كافّة الأمّة له، وكذلك من تواتره»! وقال في موردٍ آخر: «وقد ناقش الكاتب ـ وهبي ـ بعد ذلك كثيراً دلالات المتن، وهذا ما يقودنا إلى تقرير موقف لدى الشيعة هو أقرب إلى ما قرَّرناه عن الإباضية، وهو أنّ المجال العلمي يسمح لديهم بمناقشة متن الرواية»([37]). والواقع أنه لا ضير في الاكتفاء بإيراد رأي باحثٍ منهم، ولكنْ من دون نسبة رأيه إلى مذهبه بشكلٍ عامّ، أو تعميمه على المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها، ولا سيّما مع العلم بوجود اختلافات غير قليلة في الاجتهادات الفكرية والفقهية. ولا بدّ في هذه الحالة من استقصاء وتتبُّع آراء فقهائهم وعلمائهم في ذلك. وقد كنتُ أتمنّى على الكاتب العدوي أن يتوسَّع قليلاً في بحثه عن موقف علماء الإمامية حيال هذه الروايات، ليجد عن كثب مناقشاتهم ونقودهم، سواء للسند أو المتن، ويلاحظ أن مجال التحليل النقدي والبحث الاجتهادي لديهم متاحٌ للمتأهِّلين، ليس فقط في متون الروايات وإسنادها، بل حتّى في المناهج والقواعد النقديّة نفسها، كما سبقت الإشارة إلى نماذج منه.
ثالثاً: النقود الموجَّهة الى المتن
هناك جملة من النقود التي وجِّهت إلى متون الروايات التي وردت حول افتراق الأمّة إلى سبعين فرقة. غير أننا نكتفي بالإشارة إلى أهمّها:
1ـ مخالفة القرآن الكريم
يرى بعض الناقدين لهذه الروايات أنّ بعض المضامين التي تحملها هذه الروايات لا تنسجم مع القرآن الكريم. ومن البداهة بمكانٍ أنّ القرآن والسنّة لا يتنافيان ولا يتكاذبان. فاذا تبيَّن في بعض ما رُوي عن النبيّ| أنه يتعارض في مدلوله مع مدلول النصّ القرآني تعارضاً عميقاً مستحكماً ومستقرّاً، بحيث يتعذَّر معه توجيهه أو معالجته وتفاديه حسب قواعد الجمع العرفي، فعندها لا يمكن قبول مثل هذه الروايات، ولا بدّ من التوقُّف عن الاعتماد عليها على أقلّ التقادير. فمثلاً: لو كان العموم القرآني ممّا لا يقبل التخصيص؛ لكونه نصّاً في مدلوله لا يحتمل الخلاف، ولا يتقبَّل قرينة عليه؛ لتعيَّن القول بإسقاط الخبر؛ لاستحالة صدور التناقض من الشارع، وحيث إن الكتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة ـ في الفرض المذكور ـ فلا بدّ من أن يكون الكذب منسوباً إلى الخبر، ويتعيَّن لذلك طرحه. وهذا المبدأ المنهجي الأصولي تقتضيه مسلَّمات العقيدة الإسلامية؛ لأنّ القرآن والسنّة ينتهيان إلى مصدر إلهيّ واحد. والسنّة تأتي مؤكِّدة للقرآن، ومبيِّنة له، ومفصِّلة لمجملاته، وشارحة لعموماته، إلى جانب تأسيسها لأحكام جديدة([38]). يقول تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم: 3 ـ 4) ويقول: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: 7)، ويقول ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: 44)، وغيرها من الآيات الدالّة على ذلك. ولا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تتصادم السنّة مع القرآن، أو تخالفه، وإلاّ فإنّه يعني أنّ الله تعالى ورسوله يتعارضان ويتخالفان مع بعضهما. كما لا يمكن أن يتعارض القرآن مع نفسه، أو السنّة مع نفسها، فإنّهما من مصدرٍ واحد: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً﴾ (النساء: 82)، وهذا من شأنه أن يقود إلى التشكيك فيهما ـ النصّ القرآني؛ والسنّة ـ، وفي مصدرَيْهما، ممّا يؤدّي في النتيجة إلى نقض الغرض الإلهي من إرسال الرسل وإنزال الكتب لهداية البشرية، مضافاً إلى ترتُّب مفاسد أخرى، ممّا يحيلها العقل، وتأباها أصول الإسلام ومصادره الأصلية.
وقد ورد عن النبيّ| وأهل بيته^ رواياتٌ مستفيضة مؤكِّدة لهذا المبدأ.
فمنها: ما ورد في الكافي، للكليني، عن أبي عبد الله الصادق× قال: خطب النبيّ| بمنى فقال: أيّها الناس، ماجاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلتُه، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقُلْه»([39]).
وعن أبي عبد الله الصادق× أنّه قال: «كلُّ شيء مردودٌ إلى الكتاب والسنّة، وكلُّ حديثٍ لا يوافق كتاب الله فهو زخرف». والرواية صحيحة سنداً([40]).
وعنه× أيضاً: «كلّ حديث مردودٌ إلى الكتاب والسنّة، وكلّ شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرفٌ». وعنه: «ما لم يوافق الحديث القرآن فهو زخرفٌ». وهما صحيحتان سنداً([41]).
كما ورد في مسند الربيع بن حبيب، عن النبيّ|، قال: «إنّكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم عنّي فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعنّي، وما خالفه فليس عنّي»([42]).
وقد توسَّع الأصوليون في بحث هذه الروايات، صدوراً وسنداً ودلالةً، وصنَّفوها إلى مجموعات، وتوقَّفوا طويلاً عند تحديد دلالاتها ومراداتها، وموارد تطبيقها، وشروطه.
وقد توسَّع الفقيه المفكِّر السيد محمد باقر الصدر في بحث مفاد هذه الروايات في تسع نقاط، وختم بحثه فيها بقوله: «يمكن تفسير مفاد هذه الأخبار بنحوٍ آخر، لا يحتاج معه إلى جلّ الأبحاث المتقدّمة، وذلك التفسير هو أنّه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم، أو ما ليس عليه شاهدٌ منه، طرح ما يخالف الروح العامّة للقرآن الكريم، وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه. ويكون المعنى حينئذٍ أنّ الدليل الظنّي إذا لم يكن منسجماً مع طبيعة تشريعات القرآن، ومزاج أحكامه العامّ، لم يكن حجّة. وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونيّة الجدّية مع آياته». كما اختار بعض العلماء ذلك([43]).
وهناك آراءٌ أخرى في هذا الموضوع، غير أننا لسنا في صدد بحثها هنا.
يذكر أنّ جماعة من المحدِّثين رفضوا التسليم بحديث عرض الروايات على القرآن. فقد اعتبره بعضهم، كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، بأنه من وضع الزنادقة.
والغريب أنّ الشافعي قرَّر عدم صحّته، ولكنّه أيَّد رأيه هذا بتعارضه مع قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾([44]).
ولعلّ منشأ الرفض عند بعضهم هو عدم الالتفات إلى المراد الدقيق من الحديث، أو لسدّ الباب على محاولات توظيفه بشكلٍ غير سليم، بحيث يؤدّي إلى ردّ كلّ رواية لم يرِدْ مضمونها في القرآن الكريم.
ويظهر أنّ هذا الموقف من بعض المحدِّثين كان في مواجهة بعض الاتجاهات الفكرية، كالمعتزلة، الذين أنكروا بعض المرويّات؛ لتعارضها مع القرآن الكريم، حسب منظورها.
والذي يقرِّب الفجوة أن بعض العلماء قرَّروا على المستوى التطبيقي العمل بمضمونه، مستندين على بعض ما رُوي عن السيّدة عائشة، التي كانت تردّ ما يخالف القرآن ممّا يرويه الصحابة عن النبيّ|. فعندما سمعت حديث أنّ الميت يعذَّب ببكاء أهله عليه، أنكرَتْه، وحلفت أنّ الرسول ما قاله، وقالت: «أين أنتم من قول الله سبحانه: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. وكذلك حين سُئلت إنْ كان النبيّ| رأى ربَّه؟ قالت: «مَنْ حدَّثك أنّ محمداً رأى ربَّه فقد كذب، ثم قرأت قوله تعالى: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾([45]).
وأيّا كان الأمر فلسنا في مضمار بحث هذه المسألة هنا، ولكنْ رأَيْنا تقديم نبذة موجزة عنها؛ ليكون القارئ على علمٍ بها؛ تمهيداً لطرح ما وجِّه إلى روايات الفرقة الناجية من نقودٍ على هذا الأساس.
ما قيل حول أوجه التعارض مع الكتاب
ومن النقود التي وُجِّهت إلى حديث افتراق الأمّة، بناءً على هذا المبدأ، أنّ معناه باطلٌ بصريح القرآن، الذي يقرِّر أنّ هذه الأمة هي خير الأمم وأفضلها، وأنّها خير أمة أخرجت للناس، وأنّه جعلها أمة وَسَطاً، في حين جعلها هذا الحديث أسوأ، وأسوأ من اليهود والنصارى. فمضمونه ينافي خيريّة هذه الأمّة، وكونها مفضَّلة، وأنّها أمّة مرحومة([46]). كما أنّ هذا الحديث، وخاصّة بزيادته: «كلّهم في النار إلاّ واحدة»، مخالف للأحاديث الكثيرة المتواترة في معناها التي تنصّ على أنّ مَنْ شهد الشهادتين وجبت له الجنّة، ولو بعد حينٍ من العذاب، كما في البخاري ومسلم. وإن الفرق المختلفة قليلٌ فيها يكفر ببدعته([47]).
والواقع أن ما ذكروه في هذا المضمار؛ لردّ روايات هذا الحديث، هو موضع تأمُّل، وقابلٌ للمناقشة والردّ؛ إذ قد يرد عليهم بأنّ هذا الحديث يدلّ على أنّ الأمة المرحومة هي المتمثِّلة في الفرقة الناجية، وبالتالي فلا منافاة بينهما([48]).
ومن جهة أخرى هل يمكن أن يلتزم أحدٌ بأنّ خيريّة الأمّة تكون على إطلاقها، حتّى لو صدر منها مخالفات ومفاسد ومنكرات تتصادم مع الخيريّة، أم أنّها مشروطة ومقيَّدة بضوابط وشروط، منها: الإيمان، والاستقامة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والعمل بمقتضاهما؟! يقول العلاّمة المقداد السيوري في تحديد المراد من قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: 110): فيكون وجودهم مقيَّداً بالخيرية، والخيرية مقيَّدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد من ذلك أنّ من شأنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»([49]).
ثم إن تقرير حتميّة خيريّة أمّة من الأمم مهما صدر منها من مخالفات وانحرافات لا يمكن الالتزام به؛ لما يستلزمه من نتائج فاسدة، تصطدم مع مبادئ العدل والإنصاف.
أمّا ما ذكر من تعارضه مع الروايات الكثيرة الأخرى التي تقرِّر دخول من يشهد الشهادتين الجنّة فيمكن ردّه بأنّ روايات الافتراق لم تقرِّر خلود الفرق الهالكة في النار أبد الآبدين. والروايات الكثيرة الواردة حول الشهادتين يقال فيها ما قيل حول مسألة الأمّة المرحومة، فلا تفهم على إطلاقها، ولا ترتّب النتيجة المذكورة على مجرّد التلفّظ بهما فقط، بل لا بدّ من تقييدها بالعمل بموجبات الشهادتين، كما ورد عنه| في روايات أخرى، من قبيل: ما روى البخاري: «كلّ أمتي يدخلون الجنّة إلاّ مَنْ أبى، قالوا يارسول الله، ومَنْ يأبى؟ قال: مَنْ أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني فقد أبى»([50])؛ وكذا بما رواه مسلم: إنّ رجلاً قال للنبيّ|: دلَّني على عمل أعمله يدنيني من الجنّة ويباعدني من النار، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، فلمّا أدبر قال رسول الله|: إنْ تمسَّك بما أمرتُه دخل الجنّة»([51]). وهذا يعني أنّه لا بدّ من التمسُّك بموجبات الشهادتين كسبيلٍ للنجاة. وهناك مَنْ حملها على المآل الأخير لمَنْ يشهد الشهادتين. وبهذا يتبيَّن إمكانية الجمع بين هاتين المجموعتين من الروايات، وعدم وجود تعارضٍ مستحكم بينهما.
2ـ اضطراب المتن
إنّ الناظر والمتأمِّل في متون روايات افتراق الأمّة يلاحظ وجود اختلافات كثيرة بين مضامينها، حيث تختلف ألفاظها وألسنتها إلى درجة لا تتَّفق بعضها في المعنى. ويتّضح من مقارنة نصوصها أن أجواء الصراع بين الفرق والاتّجاهات الفكرية والفقهية والسياسية قد انعكست عليها، بالحذف والإضافة في متونها؛ بغية التأكيد على شرعيّتها وصدقيّتها وإقصاء غيرها.
ومن الأمثلة التي تكشف عن اضطراب متونها واختلافها أنّه ورد في بعضها، في ما رواه ابن أبي عاصم: «ألا وإنّ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء»؛ وفي بعضها: «لم ينجُ منها إلاّ ثلاث»؛ وفي بعضها: «كلُّها في النار إلاّ السواد الأعظم».
وفي بعضها، كما عند ابن حِبّان: «إنّ اليهود افترقت على إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين فرقة، والنصارى على مثل ذلك»، وجاء في بعضها أنّ أمته ستفترق إلى اثنتين وسبعين فرقة، كما عن الصدوق؛ وفي أخرى: إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ وهناك روايات تشير إلى ثلاث فرق، كما عن الحاكم.
ومن جهةٍ أخرى إن بعضها تستثني فرقة واحدة من النار؛ وبعضها العكس تماماً، تقرِّر هلاك واحدة ونجاة البقية.
وفي رواية أشير إلى الافتراق وعدد الفرق، دون عبارة «كلّها في النار إلاّ واحدة».
وقد بلغ التلاعب في متنه؛ بدافع إسقاط بعض الفرق والاتّجاهات المعارضة للنظام السياسي والاجتماعي والثقافي القائم، أن أضاف بعضهم في آخره: «من أضلِّها وأخبثها الشيعة»؛ وفي رواية: «شرُّهم الذين ينتحلون حبَّنا أهل البيت ويخالفون أعمالنا»؛ وأضاف آخرون: «شرّهم الذين يقيسون الأمور بآرائهم»، في إشارة إلى الحنفية؛ وفي بعضها: «كلّهم في الجنّة إلاّ القدرية»، إشارة إلى المعتزلة؛ وفي بعضها: «إلا الزنادقة».
وفي المقابل ورد في روايةٍ أن الناجية هي الجماعة، ولا يبعد أن تكون إشارة إلى عام الجماعة، أو النظام السياسي القائم آنذاك، كما في جملة من الروايات المحذِّرة من الخروج على الجماعة([52]). وجاء في روايةٍ: قيل: ومَنْ الناجية؟ قال: أهل السنّة والجماعة([53]).
ويذكر الدكتور الجابري أنّ إحدى الروايات تضمَّنت عبارة «ثمّ تتبع الفتن بعضها بعضاً، حتّى يخرج رجلٌ من أهل بيتي يقال له: المهديّ، فإنْ أدركته فاتّبعه»، أي إنّها تعتبر الفرقة الناجية من الشيعة ـ حسب تعبيره ـ.
ونقل عن ابن المرتضى، صاحب المنية والأمل، أنه أورد روايةً في آخرها: «أتقاها وأبرّها المعتزلة».
وأضاف الجابري: «بينما يورد مصدر خارجيٌّ الحديث بصيغة تجعل الفرقة الناجية هي الخوارج بالذات»([54]).
وتجدر الإشارة إلى أنّ العلاّمة فضل الله استظهر أنّ عبارة «وهُمْ شيعة عليّ»، الواردة في بعضها للإشارة إلى أنها الفرقة الناجية، ليست من أصل الحديث، وإنّما هي شرح أو بيان أو تطبيق له. ورأى بأنّ النبيّ| قد بيَّن في كثيرٍ من الأحاديث السبل الموصلة إلى الحقّ، والمتمثِّلة بالتمسُّك بالكتاب وأهل البيت^([55]).
وأيّاً كان فإنّ من المعلوم أنّ بعض تصنيفات الفرق ومسمّياتها لم تكن معروفة في عصر النبيّ|، ولا في عصر الخلفاء الأوائل، ولم تكن الفرق والمذاهب قد تشكَّلَتْ آنذاك.
ويلاحَظ هنا، على الرغم من أنّ النبيّ| كان يخبرهم عن أمرٍ خطير يؤول إليه حال الأمّة من الفرقة والضعف في المستقبل، ومع ذلك فإنّه لم يسبِّب لديهم أيّ استغرابٍ أو تعجُّب.
ثم هل يعقل أن ترِدَ كلّ هذه الروايات المتضاربة عن النبيّ|، دون أن تكون قد عبثت فيها الأيدي، في مناخات الصراع الفكري والسياسي الذي شهده المسلمون؟!
وجاء في بعضها، كما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: «كلّها في النار إلاّ ملّة واحدة، قالوا: ومَنْ هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي».
وقد نقد الباحث السقّاف هذه الرواية من منظور الحوادث التاريخية التي وقعت بين الصحابة بعد وفاة النبيّ|؛ إذ كيف يعقل صدورها من النبيّ|؟! لأنّ الصحابة افترقوا في عهد رابع الخلفاء الراشدين سيِّدنا ومولانا أمير المؤمنين عليٍّ إلى ثلاثة فرق: فرقة معه، وهي التي على الحقّ بنصوص الأحاديث الكثيرة المقطوعة؛ وفرقة قعدت ولم تناصر إمام الحقّ، ولم تقاتل مع أحد الفريقين، وقد ندم أفرادها؛ وفرقة مع معاوية، وهي الفئة الباغية، بنصّ رواية البخاري ومسلم: «عمّار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار». وتساءل السقاف: وعليه فإنّ عبارة «ما عليه أنا وأصحابي» مع أيّ فرقة من هذه الفرق الثلاث تكون؟([56]).
ونظراً للتضارب في متون هذه الروايات انتهى الشيخ السبحاني إلى القول: «إنّ مشكلة اختلاف نصوص الحديث لا يقلّ إعضالاً من مشكلة سنده، فقد تطرَّق إليه الاختلاف من جهاتٍ شتّى، لا يمكن معه الاعتماد على واحدٍ منها»([57]).
ولكنْ من جهةٍ أخرى قد يُقال: إنّه على الرغم من هذا الاضطراب والاختلاف الملحوظ في كثيرٍ من روايات الفرقة الناجية، ممّا قد يثير علامات استفهام مشروعة تجاهها، إلاّ أنه في نفس الوقت يلاحظ بأنّ ثمة قاسماً مشتركاً يكاد يكون قائماً بينها أو بين أغلبها، وهو الذي يشير إلى مسألة افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة. وقد يقال بأنّ واقع الفرقة بين المسلمين يشهد بصدقها.
ولكنْ على فرض صحّة ذلك فإنه لا يعني أنّه لم يشكِّك أحدٌ في حديث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كما صرَّح الباحث وهبي([58])؛ إذ ليس من المعقول إغفال كلّ هذا الجدل حوله.
ثم اذا اعتبرنا هذا الجدل حول رواياته اتّفاقاً فما هو الاختلاف إذن؟
كما أنّ الكاتب العدوي، وعلى الرغم من حشده الملاحظات على هذه الروايات، وبيان ما يترتَّب عليها من نتائج خطيرة على الأمّة، ومع تناوله لما يعتور متونها من اختلاف كبير، بحيث لا يمكن أن تكون ـ حسب تعبيره ـ نبويّة خالصة، مع ذلك ذكر بأنه يستسيغ صدورها من النبيّ|، بحسب إحدى الروايات الورادة عن النبيّ|، مشيراً إلى الرواية الموافقة لما في مسند الربيع. غير أنه أضاف: ولكنْ لا على نحو الإنباء بالغيب المستقبلي، بل من جهة استشراف المستقبل والوعي الحضاري لمسيرة البشرية، والتدبُّر العميق لمنطق القرآن الكريم([59]).
ولسنا هنا في صدد مناقشة فكرة استبعاد إنباء النبيّ| لبعض المغيّبات المستقبلية، ولا سيّما إذا كانت عن طريق إطلاع الله تعالى له عليها، فذلك موكول إلى الدراسات العَقْدية([60]).
ولكنْ ما نودّ إثارته هنا أنّه من غير المنطق أن يخبر النبيّ| الصحابة عن تفرُّق المسلمين إلى فرقٍ كثيرة لا ينجو منها إلاّ واحدة يوم القيامة، دون أن يحفِّزهم إلى الاستفسار عن تلكم الفرقة الناجية، وعن أوصافها، ومعالمها، وعن الفرق الهالكة، وأسباب هلاكها، وعن أسباب الفرقة. أمّا أن تمرّ الواقعة هكذا دون أن تثير أيّ استغرابٍ أو تأسُّفٍ أو استفهامٍ لدى المسلمين الأوائل، سوى سؤالاً عادياً مفاده: ومَنْ هي الناجية؟ ثمّ يردّ عليهم النبيّ| بأنّها ما عليه هو وأصحابه، أو الجماعة، وما شابه من الردود غير الشافية، فهذا لا يتَّفق مع منطق الاجتماع البشري.
إلاّ إذا قيل بأن شيئاً من ذلك قد حصل، ولكنّ الرواة حذفوه؛ لدواعي الاختصار وما شابه. ولكنّ هذا ـ إنْ صحّ ـ فإنّه سيشكِّل شاهداً على وقوع التصرُّف بالحذف في هذه المرويّات، ممّا يفتح الباب لافتراض حذف أمورٍ أخرى منها.
ومن جهةٍ أخرى دأبت الاتّجاهات الإقصائية والتكفيرية لدى مؤرِّخي الفرق والمقالات وبعض المحدثين على التركيز على ما ورد في ذيل بعض الروايات، وهو «كلّها في النار إلاّ واحدة»، وجرت محاولات تطبيقها على بعض التيّارات الفكرية. والواقع أن هذه الاتّجاهات المتشدِّدة تغفل حقيقة أنّ بعض روايات الحديث لم تتضمَّن هذه العبارة، واكتفت بذكر الافتراق، وعدد الفرق فقط.
وهذا حديث أبي هريرة، الذي رواه أبو داوود والترمذي وابن حِبّان والحاكم، وفيه يقول: «افترقت اليهود على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعين فرقة، وتفرَّقت النصارى على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعين فرقة، وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة»([61]).
وقد شكَّك عددٌ من العلماء في هذه الزيادة؛ فقال ابن الوزير في العواصم والقواصم: «وإيّاك والاغترار بـ «كلّها هالكة إلاّ واحدة»؛ فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة».
وقال ابن حزم: «إنّها موضوعة، غير موقوفة، ولا مرفوعة».
وذكر الشوكاني، عن ابن كثير، أنّ هذه الزيادة ضعَّفها جماعةٌ من المحدِّثين.
أما ابن الوزير فإنّه صحَّح رواية معاوية بهذه الزيادة، في كتابه الروض الباسم. وإنّ تضعيفه ليس من جهة السند، بل المتن؛ فإنّه استشكل على دخول معظم المسلمين النار([62]). غير أنّ كلمة ابن الوزير السابقة تشدِّد على فساد الزيادة، واحتمال كونها مدسوسة.
وقد نبَّه غير واحد على سهو السخاوي في المقاصد الحسنة، حيث ذكر حديث أبي هريرة بالزيادة المذكورة. وتبعه في ذلك العجلوني في كشف الخفا، والشوكاني في الفوائد المجموعة([63]).
وعلى نقيض الاتجاهات التكفيرية والإلغائية، التي حاولت فرض وصايتها على الأمّة، معتبرة نفسها القاعدة والأصل لهذا الدين، والاتّجاه الذي يمتلك الحقيقة كلّها دون غيرها، وحكمت على غيرها بالهلاك والبوار، ورسَّخت شرعيتها بالاستناد إلى السلطة السياسية وأجهزتها الإعلامية والفكرية والتنظيرية، وُجد اتّجاه متفائلٌ ومتسامح، اعتقد النجاة لمعظم تيّارات الأمّة واتّجاهاتها الفكرية ومدارسها الفقهية، على ما بها من اختلافات. ومن ثم ظهرت رواياتٌ تؤيّد هذه النزعة التفاؤلية.
يقول الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق: «ولكن ممّا يدعو إلى الارتياح ويثلج الصدر أن الشعراني في ميزانه قد روى من حديث ابن النجّار، وصحَّحه الحاكم بلفظ: «غريب»، وهو: ستفترق أمتي على نيِّف وسبعين فرقة، كلّها في الجنّة إلاّ واحدة». وأضاف العجلوني في كشف الخفا أنّه رأى في هامش الميزان في تخريج أحاديث مسند الفردوس، للحافظ ابن حجر، عن أنس، عن النبيّ|: تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلّها في الجنّة إلاّ الزنادقة»([64]).
بينما شكَّك في الأخير بعض المحدِّثين، كالسيوطي في اللآلئ المصنوعة، حيث قال: لا أصل له، أي بهذا اللفظ([65]).
وحكم عليه الألباني بالوضع([66]).
كما قد يرد عليه بأنّه يؤدّي إلى فتح الباب واسعاً للاختلافات الدينية، وتبريرها، حتّى لو كانت متضادّة.
وفي المقابل صرَّح المؤرِّخ المعروف المقدسي(380هـ)، صاحب أحسن التقاسيم، أن هذا الحديث أصحّ إسناداً، بينما الحديث الآخر الذي يقرِّر نجاة فرقةٍ واحدة أشهر([67]).
وإذا صحّ هذا الكلام فإنّه قد يعزى إلى الظروف السياسية المتوترة، والبيئات الثقافية المتشدِّدة، التي تلقي بثقلها وتأثيرها على المؤرِّخين والمحدِّثين والكتّاب والخطباء والأدباء والإعلاميين والمناهج، فيركِّزون على بعض الروايات والحكايات والأخبار، ويتناولونها في كتبهم ومقالاتهم وخطبهم ودروسهم، حتّى تحوز على الشهرة والذيوع، إلى درجةٍ تغدو معها ثقافة عامّة راسخة، يردِّدها الجميع، حتّى الصبيان في الكتاتيب. وفي ظلّ هذه الأجواء تتشكَّل الانطباعات والنظرات السلبية إلى التيّارات والاتّجاهات الأخرى المخالفة لها في الرأي والفكر. ولعلّه إلى هذا أشار الشيخ شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، بقوله: «ولكنّ عصور التعصُّب المذهبي العنيف حملت المسلمين تراثاً بغيضاً من التراشق بالتهم، والترامي بالتعصُّب والفسوق والضلال، فتبادل الفقهاء ـ أصحاب الفروع ـ نوعاً من التهم، وتبادل المتكلِّمون ـ أصحاب العقائد ـ مثل ذلك، وتلقَّف المخدوعون من الخَلَف هذه التُّهَم، وملأوا بها كتبهم، وأسرفوا في الاعتداد بها، حتّى جعلوها مقياس ما يُقبَل من الآراء أو يُرفَض»([68]).
وفي خضمّ هذا الاختلاف والجَدَل حول روايات الفرقة الناجية وطرقها وأسانيدها، وما يكتنف متونها من اضطراب وعلل قادحة، بحيث أدّت إلى ارتباك مواقف بعض العلماء، وتضارب آراء المفكِّرين حيالها، يطالعنا العلاّمة محمد جواد مغنيّة ـ كعادته ـ، فيحسم موقفه منها بقوله: «اشتهر عن النبيّ| أنّه قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة. وقد كثر الكلام وطال حول هذا الحديث؛ فمن قائلٍ: إنه ضعيف لا يعوَّل عليه؛ وقائلٍ: إنّه خبر واحد، وهو ليس بحجّة في الموضوعات؛ وقال ثالث: إنّ كلّها في النار من دسائس الملاحدة؛ للتشنيع على المسلمين؛ ورواه رابعٌ بلفظ: كلّها في الجنّة إلا الزنادقة. ثم قال: ونحن على شكٍّ من هذا الحديث؛ لأنّ الأصل عدم الأخذ بما ينسب إلى الرسول| حتّى يثبت العكس. ولكنْ إذا خُيِّرنا بين «كلّها في النار» وبين «كلّها في الجنّة» نختار الجنّة على النار؛ أولاً: إنّها أقرب إلى رحمة الله.
ثانياً: إن الفرق الإسلامية على أساس الاختلاف في الأصول لا تبلغ 73 فرقة، والاختلاف في الفروع لا يستدعي الدخول في النار؛ لأنّ الخطأ فيها مغتفرٌ إذا حصل مع التحفُّظ، وبعد الجدّ والاجتهاد. وختم كلامه بقوله: وما أبعد ما بين هذا الحديث المنسوب إلى النبيّ| وقول ابن عربي في كتاب الفتوحات: لا يعذّب أحدٌ من أمّة محمد| ببركة أهل البيت^([69]).
ورُبَّ قائل: إنّ الشيخ مغنية لم يتَّبع المنهج العلمي المتَّبع في نقد الروايات، من ناحية البحث في أسنادها وطرقها، ومدى اتّصالها، وسلامتها من النقد، حسب قواعد الجرح والتعديل. ومن جهة أخرى إنّه لم يدرس متون الروايات، ولم يقُمْ بأيّ مقارنة أو موازنة أو تحقيق في هذا المضمار، بل أغفل دراسة مجمل عملية النقد الداخلي والخارجي، ومن ثم فإنّ ما انتهى إليه من رأيٍ لا يعدو أن يكون مجرّد وجهة نظر شخصيّة استحسانية!
ورغم أنّه لم يتَّضح لنا مستوى تتبُّعه للروايات وأسانيدها، فإنّه يظهر من كلامه المتقدِّم أنّه أشار إلى ما انتهى إليه الجدل حول سنده، وأنّه في أحسن الظروف فإنّ خبر الواحد لا يحتجّ به في الموضوعات ـ حسب رأيه ـ، وكذا حسب بعض المباني العلمية([70]). كما أنّه لم يغفل ما يعتري كثيراً من متونه من اضطراب، حيث ذكر أهمّ ما قيل في هذا الشأن. وبعد أن رأى أن حالة الشكّ والإرباك تخيِّم على مروياته، سواء من جهة السند أو المتن، فإنّ المرجع عندها هو أصل عدم الأخذ به، والتوقُّف عن الاحتجاج به. والواقع أنّه قدَّم خلال فقرة موجزة خلاصةً جامعةً لبحوثٍ مطوَّلة.
3ـ إشكاليّة العدد بين الروايات والواقع التاريخي
من الإشكالات التي واجهت حديث الافتراق، أو حديث الفرقة الناجية، حقيقة الأعداد التي وردت فيها. وعلى الرغم من الاختلاف والاضطراب في بعض متونها من هذه الناحية أيضاً، كما اتّضح في ما سبق من البحث، فإنّ المشهور منها ينصّ على أن اليهود انقسموا إلى إحدى وسبعين، والنصارى إلى اثنين وسبعين، وسوف ينقسم المسلمون إلى ثلاث وسبعين فرقة.
وأوّل ما يلفت النظر هنا الترتيب العددي التصاعدي المتدرِّج لانقسام أتباع الديانات الثلاث: 71، 72، 73 فرقة. وأوّل الاسئلة التي ترِدُ على البال: ما هي طبيعة هذا الترتيب العددي؟ ومدى واقعيّته؟ وهذا بدوره يقود إلى عددٍ من التساؤلات والتفسيرات. وممّا قيل في ذلك: إنّ الأعداد ليست مقصودة في نفسها، بل ذكرت على سبيل المبالغة، والتدليل على عمق الخلاف وكثرة الانقسام، وهو ما تعارف عليه العرب في محاوراتهم وأساليبهم في الكلام. ويؤيِّده ما جاء في القرآن الكريم: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ﴾ (التوبة: 88)، حيث ذهب بعض المفسِّرين إلى أنّ المقصود من العدد هنا المبالغة، لا العدد المخصوص([71]).
ورُدَّ هذا القول بأنّ الروايات وردت فيها أعداد معينة محدَّدة، ممّا يوحي بأنها مقصودة، وليست لمجرد المبالغة. فلو كان الغرض منها مجرّد الإشارة إلى كثرة الفرق لكان اكتفى بالقول، على سبيل المثال: إنها ستفترق إلى سبعين فرقة أو أكثر من سبعين فرقة، كما افترقت الأمم السابقة. ولكنْ ما معنى أن يشير إلى انقسام هذه الأمم طبقاً لترتيب عدديّ تصاعديّ معيَّن؟! إنّه بكلّ بساطة يوحي وكأنّ الأعداد المذكورة حقيقيّة. وهذا ما يثير الغرابة والارتباك في فهم هذه الروايات.
وفي المقابل يُطرح تساؤلٌ مفاده: إذا لم يقصد من هذه الأعداد الإشارة فقط إلى كثرة الفرق وكثرة الانقسامات التي ستقع في الأمة، فما مدى واقعية هذه الأعداد من الناحية التاريخية؟
هل انقسم اليهود بالفعل إلى إحدى وسبعين فرقة، والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة؟
ودَعْنا من هؤلاء، فهل انقسم المسلمون بالفعل إلى ثلاث وسبعين فرقة؟
ثم ما هو تعريف الفرقة هنا؟ وما المقصود منها؟ هل المقصود الإشارة إلى الانقسامات الحاصلة على مستوى الأصول الاعتقادية أم أيضاً الحاصلة على مستوى الأصول الفقهية؟ وبالإضافة إلى الانقسامات الواقعة على مستوى التفاصيل، سواء في العقيدة أو الفقه، هل تقتصر الانقسامات على المذاهب العقدية والكلامية أم كذلك تشمل المذاهب الفقهية؟ وهل تشمل الخلافات التي تقع ضمن التيّار الفكري العقدي والفقهي الواحد، كما هو الحال بالنسبة لأهل الحديث والأشعرية والماتريدية والسلفية والصوفية والزيدية والاثني عشريّة وما شابه؟
كما قد تطرح تساؤلاتٌ عن مدى شمول هذه الروايات للخلافات التي تقع على صعيد المناهج والبرامج العملية في الإصلاح والتغيير بين جماعات العمل السياسي؟
قد يُقال بأنّ هذه وأمثالها غير مشمولة؛ لأنها لا تعدو أن تكون مجرّد وجهات نظر في القراءة الميدانية لمختلف الساحات، وتقدير الأولويات فيها، ممّا لا تستلزم النجاة والهلاك الأخرويين اللذين تتّحدث عنهما هذه الروايات.
ولكنْ يمكن الإجابة عنها بأنها وإنْ كانت لا تعدو الاختلاف في تقدير الأساليب والوسائل، ولكنّها في بعض الأحيان تقود إلى إيجاد انقسامات حادّة بين أتباعها وقياداتها، بحيث تنتهي إلى تبادل اتّهامات خطيرة، ووصف بعضها بعضاً بأوصاف منفِّرة، تصل إلى الخيانة والعمالة، بل يلجأ بعضها إلى التفسيق والتضليل أيضاً. وقد ينتهي بها الأمر في بعض الأحيان إلى التقاتل وما إلى ذلك. فإذا كانت هذه الروايات تهدف في ما تهدف إليه إلى التحذير من مغبّة الفرقة والانقسام في صفوف المسلمين؛ للحيلولة دون وقوع الوهن والضعف في جسم الأمّة، كما ذكر بعضهم، فإنّ مثل تلكم الخلافات العملية العميقة لا تكون بمنأى عنها، على الأقلّ من هذه الجهة.
ومن جهةٍ أخرى، وبناء على كون الأرقام المذكورة حقيقيّة، فهل المقصود منها وقوع هذه الأعداد من الفرق والجماعات في زمنٍ معين أم أنّها سوف تظهر خلال الفترة الزمنية الممتدّة منذ رحيل النبيّ| إلى يوم القيامة؟
وهل الهدف منها هو الإخبار والإنباء بالوقوع الحتمي لهذا الافتراق في جسم الأمّة أم الغرض هو التحذير من وقوعه وحفز الأمّة للسعي لاتّخاذ تدابير تحول دون وقوعه؛ لأن من شأنه إضعاف الأمّة وإفشالها وإخفاق دورها الرسالي؟
ثم إنّ الفرقة التي ضمنت الجنان والنجاة في الآخرة هل ضمنتها لكلّ أفرادها منذ نشأتها وإلى يوم القيامة؟ وما هو معيار الانتساب إليها؟ هل يكفي مجرَّد الانتماء الموروث أم أن المسألة تخضع لموازين الفهم والقناعة والصلاح والاستقامة؟
وفي المقابل هل الفرق الهالكة يكون كلّ أفرادها هالكين، وبالجملة؛ لمجرَّد انتسابهم الدموي والوراثي إليها؟ ولكنّ التساؤل الذي يثور هنا هو: ما مصير المستضعفين والغافلين، والذين لم تبلغهم الحجّة ولم يبلغهم البيان أصلاً؟ هل يعقل أن يعامل هؤلاء نفس معاملة الجاحدين والمكذِّبين والمكابرين في إنكار الحقيقة؟
تظلّ التساؤلات السالفة وأمثالها مطروحة؛ لغرض فهم هذه المرويّات ودرايتها، دون إجاباتٍ حاسمة عليها. الأمر الذي يزيد الموقف ارتباكاً وتحيُّراً في دراية حديث الفرقة الناجية وتطبيقه، ومن ثم صعوبة الاستناد إليه وحده لتقرير أحكام خطيرة، من قبيل: الحكم على كلّ فرق المسلمين بالهلاك والبوار في الآخرة، والتكفير أو التضليل ـ على أقلّ تقدير ـ في الدنيا.
وفي سياقٍ متّصل فإنّ من المعروف أنّ تيارات المسلمين الفكرية لم تجمع على عددٍ من المسائل الخلافية في هذا المجال، من قبيل: مصير مرتكب الكبيرة، ومدى حتمية الوعد والوعيد الإلهيّين. فقد ذهب الأشاعرة إلى أنه لا يجب على الله تعالى شيء من ذلك. وعلى عكس ذلك قرَّر المعتزلة ومَنْ وافقهم بأنّ ثواب المطيع وعقاب العاصي إنْ مات بلا توبة واجبان على الله تعالى. بينما ذهب الشيعة الإمامية إلى أنّ الله تعالى يجب عليه الوفاء بالوعد، وهو ثواب المطيع؛ لأنّه مقتضى العدل والإنصاف، ولا يجب عليه عقاب العاصي وتحقيق الوعيد؛ لأنّه حقّ الله تعالى، فيجوز عليه إسقاطه([72]).
ولكنْ في خضمّ هيمنة مفاهيم التضليل والتكفير غابت مثل هذه القواعد والآراء عن ذاكرة مؤرِّخي الفِرَق ووعي علماء الكلام، ولا سيّما عند محاولاتهم المتكلِّفة لاحتكار الفرقة الناجية، ورمي معظم تيارات المسلمين في أتون النيران، مع أنه كان الأجدر بهم ترك الخوض في هذه المسألة المتعلِّقة بمصير البشر الأخروي لمالك يوم الدين.
لقد تحمَّس بعض مؤرِّخي الفِرَق والمقالات لهذه الروايات، ووجدوا فيها ضالّتهم نحو تقسيم المسلمين إلى فرق ضالّة هالكة، واحتكار النجاة والجنان لفريقٍ معين، واندفعوا في تأليف كتبٍ خاصّة عن فرق المسلمين وتيّاراتهم، وتعسَّف بعضهم؛ بغية إيصال العدد إلى ثلاث وسبعين فرقة، إلاّ أن تلكم المحاولات أخفقت، ولم تحظَ بالنجاح.
فأبو الحسن الأشعري، صاحب كتاب «مقالات الإسلاميين»، صرَّح بأن أصول الفرق عشرة، وعند تعداده لها ذكر إحدى عشرة فرقة! وفي المحصلة النهائية تجاوز عدد الفرق عنده المائة فرقة!
وعند الشهرستاني، صاحب كتاب «الملل والنحل»، بلغ عدد الفرق ستّاً وسبعين فرقة، تفرَّعت عن أصل أربع فرق، هي: القَدْرية؛ والصفاتية؛ والخوارج؛ والشيعة.
وقد تأرجح العدد عند الخوارزمي بين ثلاث وخمسين واثنين وسبعين فرقة.
أمّا ابن حزم، صاحب كتاب «الفصل»، فقد عدَّها خمس فرق رئيسة، وهي: أهل السنّة؛ والشيعة؛ والمعتزلة؛ والمرجئة؛ والخوارج.
في حين عدّها الملطي أربع فرق، هي: القدرية؛ والمرجئة؛ والشيعة؛ والخوارج.
بينما الفرق الرئيسة عند القاضي عبد الجبّار المعتزلي هي خمس: المعتزلة؛ والخوارج؛ والمرجئة؛ والشيعة؛ والنوابت، وهم أهل الحديث.
أمّا النوبختي فإنّ أصول الفرق عنده أربعة، هي: الشيعة؛ والمعتزلة؛ والمرجئة؛ والخوارج([73]).
وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى، عن ابن أسباط وابن المبارك، بأنّ أصول البِدَع أربعة: الروافض؛ والخوارج؛ والقدرية؛ والمرجئة، واعتبرا الجهميّة من الكفّار، فلا يدخلون في الفرق الاثنتين والسبعين. ووافقهما عليه فريقٌ من أصحاب أحمد، وخالفهما فريقٌ آخر، فقالوا: هم داخلون في الفرق الاثنتين والسبعين. وعلَّق عليه ابن تيمية بقوله: «فعلى قول هؤلاء يكون كلّ طائفة من المبتدعة الخمسة اثنتا عشرة فرقة، وعلى قول الأوّلين يكون كلّ طائفة من المبتدعة الأربعة ثماني عشرة فرقة. وهكذا ذهل هو الآخر عن الحِسْبة الصحيحة، فجعل من مجموع الفِرَق ـ بناء على كون أصولها خمسة ـ ستّين فرقةً!([74]).
وحاول ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» أن يوصلها بطريقةٍ متكلفة غير واقعية إلى ثلاث وسبعين فرقة، بعد أن صنَّفها إلى فرق رئيسة؛ وأخرى فرعية، فقال: «إنّ أصول الفرق هي الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية، وقال بعض أهل العلم: أصل الفرق هذه الستّ، وقد انقسمت كلّ فرقة منها اثنتا عشرة فرقة، فصارت اثنتين وسبعين([75]).
ولم يخبرنا ابن الجوزي لماذا اقتصرت الفرق الأصلية عنده على ستّ فرق؟ وما الذي جعل كلّ هذه الفرق الرئيسة تنقسم وتتفرَّع بنفس العدد، لتصل إلى عدد الفرق الهالكة حسب روايات الفرقة الناجية؟
إنّها في الواقع محاولة نظريّة أقرب إلى عملية حسابيّة مركَّبة من القسمة والضرب، يعوزها الدليل التاريخي والسند الواقعي.
ويلاحظ أنّ تركيزه انصبّ على تكملة عدد الفرق الهالكة فقط؛ لتتطابق مع روايات الافتراق، وبصرف النظر عن التحقُّق الفعلي والتاريخي.
وعلَّق الشيخ السالمي، عند شرحه للحديث، بقوله: «فوقع مشاهداً، فإنّ افتراق الأمّة قد كان على ما وصف رسول الله| على ثلاث وسبعين فرقة؛ فعشرون منها في المرجئة؛ وأربع وعشرون في الشيعة؛ واثنتا عشرة في المعتزلة؛ وسبع عشرة في المحكمة، وقيل في تفصيلهم غير ذلك»([76]).
ويلاحظ أنه اختار تقسيم الفرق الرئيسة على أربع فرق، وفاقاً للنوبختي، تفرَّعت منها أعداد مختلفة، لتنتهي في المحصّلة الأخيرة إلى ثلاث وسبعين فرقة، حسب رواية الفرقة الناجية.
وهكذا تضاربت الآراء والتحليلات، سواءٌ في أصول الفرق أو في فروعها أو في أسمائها، بين المؤرِّخين والمحدِّثين والفقهاء.
وللخروج من هذا المأزق وهذا الارتباك، الذي يفرض اتّخاذ موقف من أحد المواقف الثلاثة، وهي: إمّا ردّ الروايات؛ أو التصريح بإجمالها، وعدم إمكانية فهمها؛ أو تقديم تأويلاتٍ مخالفة لظاهرها.
وبالفعل فقد سلك بعضهم مسلك التأويلات المتكلَّفة، ومن أبرزها: ما ذهب إليه الرازي، الذي يقول: «إنْ قيل: إنّ هذه الطوائف التي عددتها أكثر من ثلاث وسبعين، ورسول الله لم يخبر بأكثر؟ وأجاب قائلاً: «يجوز أن يكون مراده| من ذكر الفرق الفرق الكبار، وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة». ولمّا أدرك بأنّ هذا التفسير لا يحلّ الإشكال بين العدد الذي حدَّدته الروايات والأعداد الفعلية المزعومة التي ذكرها هو، وذكرها غيره؛ لأنّها لم تصل إلى هذا العدد، وليس معلوماً إنْ كانت ستصل إليه أو تتجاوزه أو تظلّ أقلّ منه في المستقبل، استدرك، فقدَّم تأويلاً غريباً، فقال «وأيضاً فإنّه أخبر أنهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة، ولم يجز أن يكونوا أقلّ، وأمّا إنْ كانت أكثر فلا يضرّ ذلك»، وأردف قائلاً: «كيف، ولم نذكر في هذا المختصر كثيراً من الفرق المشهورة، ولو ذكرناها كلّها مستقصاةً لجاز أن يكون أضعاف ما ذكرنا»([77]).
وهكذا اضطربت الأعداد عندهم، فلم يتَّفقوا في تعدادها، سواء على مستوى الفرق الرئيسة أو الفرعية. وظهر أن أغلب تلكم المحاولات كانت قائمة على التكلُّف والتعسُّف؛ تمسكاً بروايات الفرقة الناجية.
والواقع كما يقرِّر أحد الباحثين المختصّين أنّ أصول الفرق لا تصل إلى هذا العدد، بل لا يبلغ نصفه، ولا ربعه، وأنّ فروع الفرق يختلف العلماء في تعريفها. وأنتَ في حيرةٍ حين تأخذ في العدّ.
وعلى فرض صحّة الحديث لا ينحصر الافتراق في ما كان في العصور الأولى، وقبل أن يدوِّن هؤلاء العلماء الأعلام مصنَّفاتهم([78]).
ولهذا لجأ الرازي إلى هذا التفسير التصالحي بين قبول رواية الفرقة الناجية وبين إشكالية العدد التي تواجهها. وبموجبه فتح الباب على مصراعَيْه لمحاولات التفريع والتفريخ والتكثير لأعداد الفرق، وقدَّم تبريراً لكلّ المحاولات غير المنهجية وغير الموضوعية التي قام بها سَلَفه من مؤرِّخي الفِرَق والملل والمقالات، ومَنْ نحا نحوهم فيما بعد. وفاته بأنّ تأويله هذا لا يُبقي أيّ معنى لتحديد العدد في الروايات، ولا سيّما إذا جاوزها الواقع إلى يوم القيامة بأعداد مضاعفة؛ لأنّه مع هذا الوضع سيكون ذكر العدد ـ على فرض قصده ـ لغوياً وعبثياً! كما فاته، من جهةٍ أخرى، أنّه في كلا الفرضين اللذين ذكرهما سيكون من الصعوبة بمكانٍ تحديد فرق معيَّنة على أنّها هي المقصودة؛ وذلك لغياب المعيار الموضوعي في الرواية.
والنتيجة الوحيدة التي تنتج من تأويل الرازي هو تشجيع الأمّة على التنافس لإنتاج مزيدٍ من خطاب التبديع والتضليل، وتبادله بين مذاهبها وتيّاراتها.
إن الاندفاع وغياب المنهج العلمي في بحوث الفِرَق والمقالات والملل أوقع المؤرِّخين والمتكلِّمين في هذا المأزق. لقد اتَّخذ بعضهم من روايات الافتراق تكأة لإنتاج تراث غدا في جانبٍ منه وبالاً على الأجيال؛ لما يقوم به من توسيع الفجوة، ونشر الكراهية بين تيارات المسلمين.
وأيّاً كان فإنّ ممّا يثير العجب والدهشة لدى الدارس إغفال المؤرِّخين والمتكلِّمين للواقع التاريخي الفعلي والميداني للفرق والتيارات الفكرية، بل وتجاهلهم لعاملَيْ الجغرافيا والتاريخ، وقفزهم على عامل الزمن، بل إلغائه من حسابهم تماماً، أثناء لهاثهم هذا وراء تحشيد كلّ إمكاناتهم الفكريّة والبحثيّة لإيصال عدد الفرق إلى ثلاث وسبعين فرقة. لقد ذهلوا عن حقيقة أنّ حركة التاريخ لا تنتهي عند عصرهم، وأن عقارب الزمن لا تتوقَّف عند أزمنتهم. وفاتهم أنّه هَبْ أنّ هذه الأعداد من الفرق، التي جهدوا للوصول إليها، قد وُجدت بالفعل حتّى عصورهم، فهل ستتوقَّف عملية التوالد والإنتاج لفرقٍ وجماعاتٍ أخرى بعدهم؟ إن هذا الوضع يتَّسق تماماً مع طبيعة الأجواء المشحونة بالعصبية والانفعال والاندفاع، التي من شأنها أن تفقد المرء وعيه وانتباهه لأمور واضحة. إنّ سيطرة أجواء التعصُّب والسجال التبديعي، ودعاوى امتلاك الحقيقة كلّ الحقيقة من قبل فئة دون غيرها، هي التي تقف وراء إنتاج هذا النوع من التفكير حتّى يومنا هذا.
كلمة الختام
لقد اتّضح لنا من خلال الاستعراض السابق حال هذه الروايات من جهة الإسناد والمتون، من منظور مختلف التيارات الفكرية للمسلمين. وتابعنا الجدل حول مدى صحّتها ومدى صدور بعض ألفاظها. كما لاحظنا بعض التطوّرات التي مرَّت بها بعض ألفاظ الروايات، والزيادات التي أضيفت إليها تحت دواعٍ أيديولوجية وسياسية. ورصدنا المحاولات المتكلِّفة الرامية إلى تطبيقها بشكلٍ إقصائي على فرق المسلمين. لقد تبيَّن من البحث أنّ هناك جدلاً من غير دليل حول بعض أسانيد الروايات وتطبيقاتها، بل حول أصل صدور بعض ألفاظها الخطيرة. والواقع أنّ المرء يستغرب كيف تُتَّخذ مثل هذه الروايات حجّة في الإقصاء في الدنيا، وضماناً لاحتكار مقاعد الجنان لفريق دون آخر في الآخرة.
وفي ختام البحث نودّ التأكيد على الأمور التالية:
1ـ إنّ أهل الفقه في الرواية والدراية مدعوّون إلى تكثيف الجهد نحو إعادة البحث في مثل هذه الروايات، بل في عموم المرويّات، ولا سيّما المشابهة لها، وذلك وفق منهجٍ تاريخيّ يرصد التطوّرات والزيادات التي طرأت عليها مع الزمن، ودراسة خلفياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بدارستها حسب القواعد التي تركِّز أو تقتصر على بحث سلاسل الإسناد، وتهمل مراجعة ونقد المتون، أو تقلِّل من شأنها، مع إغفالٍ كبير للمنهج التاريخي في النقد.
2ـ أهمية القيام بمراجعة نقدية لمصادر البحث في الفِرَق والمقالات والملل والنحل، والأدبيات والمفاهيم والشروح التي تأسَّست عليها، وضرورة قراءتها في ضوء سياقاتها ومناخاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية، وعدم التعامل معها كمرجعيّات مسلَّمة، موثوق بها في دراسة وتقييم المذاهب والفِرَق والتيارات المتعدِّدة للمسلمين ولفكرهم.
3ـ التوقُّف عن اتّخاذ روايات الفرقة الناجية قاعدةً للنظر والتعامل مع تيارات ومذاهب وفرق المسلمين بعضهم مع بعض. والكفّ عن جعلها محوراً ومستنداً لتكريس ثقافة التفرقة، والنفي، وتعميق الهوّة بينهم.
4ـ ليس من الصواب إغفال الجوامع الكبرى والمساحات المشتركة بين المسلمين، سواء في الأصول أو الفروع، في العقيدة أو الفقه أو المنظومة القيمية الأخلاقية، في غمرة الانشغال بالمسائل الخلافية بينهم. بل من المفترض الاتّكاء على قاعدة المشتركات، وبحث مسائل الخلاف عبر منهجٍ علمي موضوعي، وبأسلوب الحوار والجدال بالتي هي أحسن، وباستخدام خطابٍ خالٍ من الاستفزاز والتجريح والإلغاء والنفي.
5ـ إن التوظيف الإقصائي لهذه الروايات وتغييب القراءات المعتدلة لها عبر التاريخ أسهم في إيجاد بيئة التعصُّب والكراهية. فمن الأهمية بمكانٍ أن يجد الرأي الآخر حيالها، والتفسير الآخر والقراءة المعتدلة لها، الطريق إلى الناس، سواءٌ عبر المنابر ووسائل التوجيه والتعليم والتثقيف الديني؛ لإيجاد اتّجاهات متوازنة وثقافة معتدلة في الأمّة، وهي مسؤولية العلماء والمفكِّرين والكتّاب ومجامع الفقه وجوامع العلم ومراكز البحث وأهل القرار في مجتمعات العرب والمسلمين.
6ـ لا خيار أمام المسلمين من مختلف المذاهب والتيّارات أينما وُجدوا إلاّ احترام هذا التنوُّع المذهبي المتجذِّر، والتعامل مع بعضهم طبقه، ونبذ مفاهيم الإلغاء والاستئصال، وتركيز مفاهيم التعارف والتعايش والتعاون في المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص، وتعميق ثقافة المواطنة في بلدان المسلمين.
الهوامش
(*) باحثٌ مهتمّ بالفكر العربي الإسلامي، من سلطنة عمان.
([1]) الربيع بن حبيب الأزدي، المسند: 17، مكتبة الاستقامة، مسقط، سلطنة عمان.
([2]) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين 1: 6، دار المعرفة، بيروت. وراجع: أبو عيسى الترمذي، الجامع الصحيح، سنن الترمذي 5: 41، دار إحياء التراث العربي، بيروت؛ ويوسف القرضاوي، تاريخنا المفترى عليه: 272، الطبعة الثانية، 2006، دار الشروق، القاهرة.
([3]) مسند الربيع، تنبيهات السالمي: 3؛ عبد الله بن حميد السالمي، شرح الجامع الصحيح 1: 67، الطبعة الثالثة.
([4]) ابن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى 3: 345، الشبكة الإسلامية، الإنترنت.
([5]) أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات 4: 452، الطبعة الرابعة، 1999م، دار المعرفة، بيروت.
([6]) أبو جعفر محمد بن عليّ الصدوق، الخصال: 611 (الهامش)، صحَّحه وعلَّق عليه: علي أكبر الغفاري، 1389هـ، طهران.
([7]) ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة 3: 480، ح1492؛ وكذا 1: 358، ح204، موقع الألباني، الشبكة المعلوماتية. وراجع: شرح العقيدة الطحاوية: 260، 261، 383، خرَّج أحاديثه: ناصر الدين الألباني، الطبعة الثامنة، 1984م، المكتب الإسلامي، بيروت.
([8]) محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية: 11، دار الفكر العربي.
([9]) محمد سعيد رمضان البوطي، السلفية مرحلة مباركة لا مذهب إسلامي: 11، الطبعة الأولى، 1988، دار الفكر، دمشق.
([10]) سليم بن عيد الهلالي، بشارة المشتاق بصحّة حديث الافتراق، الأردن، موقع النصيحة الإسلامية.
([11]) مالك وهبي، التكفير وحديث افتراق أمّة الرسول|، موقع علم الإسلام، الإنترنت.
([12]) محمد يحيى عزان، حديث افتراق الأمّة تحت المجهر: 32، مركز التراث.
([13]) محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 28: 20، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية، 1983م.
([14]) أبو القاسم الخوئي، البيان في تفسير القرآن: 221، الطبعة الثامنة، 1981م، دار الزهراء، بيروت.
([15]) عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق: 7 (الهامش)، حقّقه: محمد عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
([16]) ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والنحل 3: 248، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 1975؛ وأيضاً: الإحكام في أصول الأحكام 8: 25، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، 1983؛ وكذا المحلّى 1: 62، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
([17]) حسن بن عليّ السقّاف، تنبيه الحذّاق ببطلان حديث الافتراق، موقعه على الإنترنت؛ وكذا كتابه صحيح شرح العقيدة الطحاوية: 630 ـ 635.
([18]) السبحاني، بحوث في الملل 1: 23، الطبعة الأولى، 1410هـ، مطبعة الخيام، إيران.
([19]) يوسف القرضاوي، تاريخنا المفترى عليه: 273، الطبعة الثانية، 2006، دار الشروق، القاهرة.
([20]) جعفر السبحاني، بحوث في الملل 1: 24؛ حسين أحمد الخشن، العقل الإسلامي بين سياط التكفير وسبات التفكير: 71، دار القماطي، 2005، بيروت.
([21]) صائب عبد الحميد، الوحدة الإسلامية والمسار الأحدب، مجلة رسالة التقريب، العدد 7، مجمع التقريب، طهران.
([22]) محمد يحيى عزان، حديث افتراق الأمة: 9.
([24]) مالك وهبي، التكفير وحديث افتراق أمّة الرسول|.
([25]) أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 17: 116 ـ 117، الطبعة الثالثة، 1983م، دار الزهراء، بيروت.
([26]) المصدر السابق 4: 322، 14: 64؛ الخصال: 611 (الهامش).
([27]) أبو جعفر الصدوق، معاني الأخبار: 323، الطبعة الأولى، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1990.
([28]) محمد عزان، حديث افتراق الأمّة: 17.
([29]) حسين أحمد الخشن، العقل الإسلامي بين سياط التكفير وسبات التفكير: 71.
([30]) مالك وهبي، التكفير وحديث افتراق أمة الرسول|.
([31]) محمد بن عليّ ابن شهرآشوب، معالم العلماء: 139، دار الأضواء، بيروت.
([32]) أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 8: 134.
([37]) خميس بن راشد العدوي، رواية الفرقة الناجية: 28، 31 ـ 32، الطبعة الأولى، 2009، مكتبة الغبيراء، سلطنة عمان.
([38]) محمد تقي الحكيم، الأصول العامّة للفقه المقارن: 241، 244، الطبعة الثانية، 1979، دار الأندلس، بيروت.
([39]) أبو جعفر الكليني، الأصول من الكافي 1: 69، الطبعة الرابعة، 1401، دار صعب ودار التعارف، بيروت.
([40]) محمد باقر المجلسي، مرآة العقول: 229، ج1، الطبعة الثانية، سنة 1404هـ، دارالكتب الاسلامية، طهران.
([41]) محمود الهاشمي، تعارض الأدلّة الشرعية، تقريراً لبحث السيد محمد باقر الصدر: 315، الطبعة الأولى، 1975، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
([42]) الربيع بن حبيب، المسند: 17.
([43]) محمود الهاشمي، تعارض الأدلّة الشرعية: 251؛ منير الخباز، الرافد في الأصول، تقريراً لبحث السيد السيستاني: 11.
([44]) أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات 4: 402، دار المعرفة، 1999، بيروت؛ وكذا سالم البهنساوي، السنّة المفترى عليها: 251، الطبعة الأولى، 1979، دار البحوث العلمية، الكويت.
([45]) الشاطبي، الموافقات 3: 17، 4: 404؛ وكذا: محمد الغزالي، السنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: 16، 22، الطبعة الرابعة، 1989، دار الشروق، القاهرة؛ القرضاوي، كيف نتعامل مع السنّة النبوية: 113، 2002، دار الشروق.
([46]) القرضاوي، تاريخنا: 273؛ وكذا السقّاف، تنبيه الحذاق.
([48]) مالك وهبي، التكفير وحديث افتراق أمّة الرسول|.
([49]) المقداد السيوري، كنـز العرفان في فقه القرآن 1: 405، انتشارات مرتضوي، 1373، طهران. وراجع الوجوه الأخرى التي ذُكرت في هذا الصدد، ومناقشتها: حيدر حبّ الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 71، الطبعة الأولى، 2011.
([50]) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري: 1388، ح7280، بيت الأفكار الدولية، 1989.
([51]) مسلم بن حجاج، صحيح مسلم: 39، ح14، بيت الأفكار الدولية، 1998.
([52]) حسن السقّاف، تنبيه الحذاق؛ يحيى محمد عزان، حديث الافتراق تحت المجهر: 11.
([53]) عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل 1: 13، دار المعرفة، بيروت.
([54]) محمد عابد الجابري، الفرقة الناجية وثقافة الفتنة، منتديات المغرب العربي، الإنترنت.
([55]) محمد حسين فضل الله، اتّجاهات وأعلام: 191، دار الملاك، بيروت.
([57]) جعفر السبحاني، بحوث في الملل والنحل.
([58]) مالك وهبي، التكفير وحديث افتراق أمّة الرسول|.
([59]) خميس بن راشد العدوي، رواية الفرقة الناجية: 56، 82.
([60]) جعفر الهادي، معالم النبوّة في القرآن الكريم، محاضرات الشيخ جعفر السبحاني: 436، 447، 461، الطبعة الثانية، 1984، دار الأضواء، بيروت؛ أحمد بن حمد الخليلي، جواهر التفسير 1: 118، الطبعة الأولى، 1984، مكتبة الاستقامة، روي، سلطنة عمان.
([61]) القرضاوي، تاريخنا: 272.
([62]) عبد الكريم الشيرازي، الوحدة الإسلامية، مقالة التقريب بين المذاهب ودراسة علم التوحيد، عبد المتعال الصعيدي: 88، مؤسسة الأعلمي، 1992، بيروت؛ القرضاوي، تاريخنا: 373؛ ناصر الألباني، السلسلة الصحيحة 1: 358، ح204.
([63]) ناصر الألباني، السلسلة الصحيحة 1: 358، ح204؛ وكذا يحيى عزان، حديث الافتراق: 8.
([64]) عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي الإسلامي: 100، دار الكتاب اللبناني، 1982؛ وكذا عبد الحسين شرف الدين، الفصول المهمّة في تأليف الأمّة: 27، الطبعة السادسة، دار النعمان، النجف. وإسماعيل بن محمد العجلوني، كشف الخفا ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، ح644، المكتبة الإسلامية، الإنترنت.
([66]) ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، ح1035، الإنترنت.
([67]) عبد الكريم الشيرازي، الوحدة الإسلامية، مقالة التقريب بين المذاهب، عبد المتعال الصعيدي: 88. وراجع: السبحاني، بحوث في الملل والنحل 1: 25.
([68]) محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة: 56، الطبعة الثالثة عشرة، 1985، دار الشروق، القاهرة.
([69]) محمد جواد مغنية، التفسير الكاشف 2: 30، الطبعة الثالثة، 1981، دار العلم للملايين، بيروت.
([70]) محمد الحسيني، مطارحات في قضايا قرآنية: 68، 71، الطبعة الأولى، 2000، دار الملاك، بيروت.
([71]) الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان 5: 84، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1986، بيروت.
([72]) محمد جواد مغنية، معالم الفلسفة الإسلامية: 174، دار القلم، الطبعة الثانية، 1973، بيروت.
([73]) محمد عمارة، تيّارات الفكر الإسلامي: 354، دار الوحدة، 1985، بيروت؛ الحسن بن موسى النوبختي، فرق الشيعة: 17، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 1984.
([74]) ابن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى 3: 350، الطبعة الثالثة، دار الوفاء، موقع مشكاة، الإنترنت.
([75]) عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام: 98.
([76]) عبد الله بن حميد السالمي، شرح الجامع الصحيح 1: 67.
([77]) فخر الدين الرازي، اعتقادات المسلمين والكفّار: 75، دار الكتب العلمية، بيروت، الإنترنت.
([78]) محمد محي الدين عبد الحميد، الفرق بين الفرق، للبغدادي، المقدّمة: 7، دار المعرفة، بيروت.