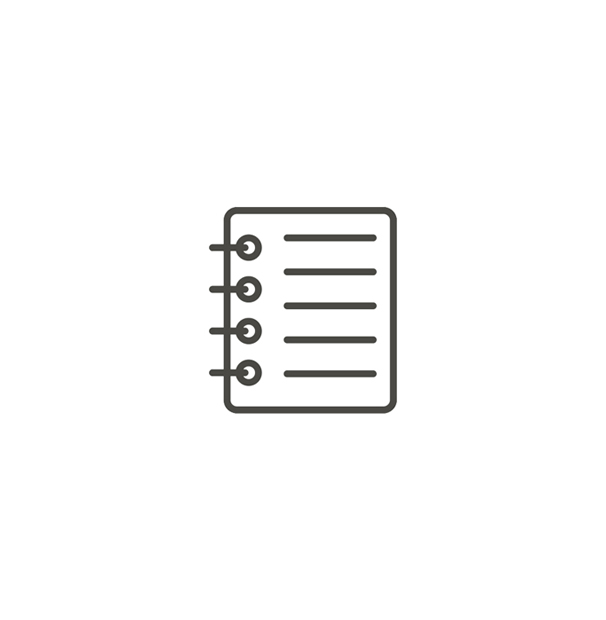د. الشيخ عبد المنعم العبد الله([1])
مقدّمةٌ
من الضروري ـ جدّاً ـ عند العقلاء سواء أكان على صعيد الأفراد أم المؤسسات بكافة انتماءاتها وتوجهاتها الدينية، وغير الدينية، أن تجعل ساعة وقفة مع الذات، بل فلتكن لحظة تقويم دقيق للمسار والاتجاه الذي اتخذته وسيلة وطريقاً ناجعاً لبلوغ الهدف.
فالهدف قلما نختلف عليه نحن السالكون إلى الله الطالبون رضاه؛ ولكن كم من العناصر الدخيلة التي تتسلل إلى نفوسنا بلباس جذاب وخفي لتحرفنا عن مسارنا يميناً وشمالاً وربما إلى عكس الاتجاه!!.
أريد أن أضع بين أفئدتكم أسئلة في لحظة تأملٍ بعيدة عن الحسابات المادية والطموحات الفتانة، هل حقيقة نرضي الله في أعمالنا..!؟، هل نرضي الله في أقوالنا..!؟، ألم ندخل في سلوكنا وثقافتنا اعتبارات ما أنزل الله بها من سلطان!؟.
أود أن أجيب عن هذه الأسئلة ولو بنقدين اثنين، كلاهما مهم، ثم تشخيص للداء، ورفع لشبهة، وخلاصة.
الأوّل: نقدٌ مهمّ
لطالما نتحدث ـ بانتقاد ـ عن العدو الخارجي وعن مؤامراته وفتنه المستمرة التي نحاول كشفها لمحاصرتها وتقويضها في مهدها؛ لأنه لا جدوى من المحاولة بعد فوات الأوان.
إن عدونا الخارجي يكيل بمكيالين؛ فهو ينادي بالحرية في مكان والقمع في مكان آخر، ويرفض الاعتداء والتجاوز في مكان، ويشرعه في مكان آخر…
إنها لعبة سياسة المصالح الخاصة ولم ولن تنطلي إلا على المغفلين أو على الذين جعلوا القرآن عِضِين.
إن حياة الإنسانية واستمرارها مرهونة بإقامة الحق والعدل، ورفض الفساد والباطل ألم يقل المولى تعالى﴿﴾: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ القُرَى بِظُلم وَأَهلُهَا مُصلِحُونَ﴾، وأيضاً: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهلِكَ القُرَى بِظُلم وَأَهلُهَا مُصلِحُونَ﴾ [هود: 117].
وقال أيضاً في حق الفاسقين: ﴿وَإِذَا أَرَدنَا أَن نُّهلِكَ قَريَةً أَمَرنَا مُترَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا القَولُ فَدَمَّرنَهَا تَدمِيراً﴾ [الإسراء: 16].
إنها سنة الله ولن تجد لسنة الله تبدلاً وتغيراً ولن تجد لسنة الله تحويلاً، فهل تدبرنا!..؛ فهل اتعظنا قبل يوم الحسرة والندامة!.
الثاني: نقد في غاية الأهمّية
لا ينكر عاقل أن لدى الإنسان أهواء ورغبات وشهوات، وقد حذَّرنا القرآن الكريم من اتباع الهوى، وما أدراك ما الهوى!؟، إنه السبيل لانحراف السبيل، فإذا كان سبيل الله واحداً لا يتعدد؛ والمفروض أن نسير عليه، فعلينا أن نتنبّه إلى خطر سبيل غيره؛ لأنه من السّبل التي توصل إلى الضلالة، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُستَقِيما فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153].
فكما أن عدونا الخارجي يكيل بمكيالين علينا أن لا تسوقنا أهواؤنا فنكيل أيضاً بمكيالين..؛ فالأولى أن نحصن أنفسنا من عدونا الداخلي الذي ما كان إلا أكثر خطراً من عدونا الخارجي، لأنه لم يكن بالحسبان، فهو كخفي الأمراض أشد نكالاً على الجسم من ظاهرها؛ فكم من إنسان قتله داؤه وهو غافل عنه!؟
الثالث: الداء الفتّاك
إن السلوك والولوج في طيات مدارك العلم مما حضّ عليه القرآن الكريم، ورغب فيه النبي(ص) والأئمة الطاهرون؛ إلا أنه بدأ يتسرب إلى نفوسنا وعقولنا مفهوم مغلوط عن حقيقة العلم والعالم؛ فأصبحنا نميّز ونفاضل بين البحوث العلمية على أساس عرض الأفكار بقالب المصطلحات الأصولية، والمنطقية، والفلسفية..،والتفنن في دقة تعقيد العبارة وغلقها! وكأن تفاضل مراتب العلماء ـ علمياَ ـ قائم وفق ميزان المصطلحات وجاذبيتها!!، وما المصطلحات في حقيقتها إلا أداة ووسيلة لبيان المقصود والمراد؛ وإصابة كبد الهدف والحقيقة والواقع.
فهل يعقل أن تكون المصطلحات مرادة لذاتها!، فنعطيها طابعاً قدسياً وجلالاً علمياً وعملياً..؛ فنعلي شأن مستعملها على من لم يتفنن في استخدامها..!!.
والسؤال المهم: من أين استقينا هذا المبدأ!!؟، أنجد هذا في خطاب علاّم الغيوب!؟، أم في مكنون علم سيد المرسلين؟!، أو في مخزون الأوصياء الراضين المرضيين(عم)!؟، أم في أسرار الصحابة والتابعين الأجلاء!؟..
إنّ ما عرفناه من منهج الإسلام العزيز، أن الرِّفعة والكرامة بالتقوى ولا تقوى حقيقية مع الجهل؛ فالجاهل المتقي، والعالم المتقي لا يستويان مثلاً، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلنَكُم شُعُوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13].
وقال أيضاً: ﴿أَمَّن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحذَرُ الآخِرَةَ وَيَرجُو رَحمَةَ رَبِّهِ قُل هَل يَستَوِي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الأَلبَابِ﴾ [الزمر: 9].
وهكذا يتعانق وحي القرآن مع وحي قلب المعصوم حيث يقول رَسُول(ص) أنه قال: أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى ألا هَلْ بَلَّغْتُ؟([2]).
أقسام العلم
فالعلم علمان: العلم الحق، والعلم المضل وكلاهما له مراتب ودرجات:
1ـ العلم الحق: فدرجاته بحسب شدة التقوى وضعفها، وأفضل وسيلة ممكنة لمعرفتها سلوكنا يقول تعالى: ﴿وَنَفس وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهَا * قَد أَفلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَد خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 7 ـ 10].
2ـ العلم المضل: له دركات بحسب شدة الوهم والعناد. يقول تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَاستَيقَنَتهَا أَنفُسُهُم ظُلماً وَعُلُوّاً فَانظُر كَيفَ كَانَ عَقِبَةُ المُفسِدِينَ﴾ [النمل: 14].
أقسام العالم
والعالم على نوعين:
1ـ عالم ترَف وتفاخر، منغمس في لذة المصطلحات ورونقها؛ فلا يحلو له المعنى إلا بلباسها فعلمه قشور لم يتذوق طم حلاوة اللبّ. يقول تعالى: ﴿يَعلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَيَوةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ هُم غَافِلُونَ﴾ [الروم: 7].
2ـ وعالم قد تجرد من تخدير الفاضل منها؛ وحظ النفس والهوى؛ بزهو زينتها، فأحكم الشدَّ، وأسهَم كبد الغاية والمبتغى، فنال الرضى ودنا فتدلى.
فهل مفاضلة أهل العلم منوطة بفن صناعة وإنتاج المصطلحات..!!؟، أم أنه لا اعتبار له؛ لأنه من زخرف الحياة الدنيا الفاتنة، وأوضح الموضوع بمثال: فلو أن رجلاً تزين بأفخر الثياب، وآخر اكتفى بالجيد منها، فهل يفضَّل ويقدم الأول على الثاني لمجرد رونق ثيابه!!؟.
فعن أبي عبد الله(ع) قال: طلبة العلم ثلاثة؛ فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل، فصاحب الجهل والمراء مؤذٍ ممار متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم، قد تسربل بالخشوع وتخلى من الورع، فدق الله من هذا خيشومه، وقطع منه حيزومه([3])، وصاحب الاستطالة والختل ذو خب([4])، وملق؛ ويستطيل على مثله من أشباهه، ويتواضع للأغنياء من دونه، فهو لحلوائهم هاضم، ولدينه حاطم([5])، فأعمى الله على هذا خبره، وقطع من آثار العلماء أثره، وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنك في برنسه([6])، وقام الليل في حندسه([7])، يعمل ويخشى وجِلاً، داعياً مشفقاً، مقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه، مستوحشاً من أوثق إخوانه ([8])، فشد الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه([9]).
الرابع: شبهة
ربما يتبادر أمراً لا أقصده، مفاده: أن الكاتب يرفض المصطلحات واستعمالها في الخطابات والبحوث العلمية التي تبانى عليها العلماء!!!.
والجواب أوضحه في نقطتين:
أوّلاً: إن ما انتقدناه هو الدخول في المصطلحات والغوغول فيها والحرص عليها لشبهة الاعتقاد أنها سرّ رتبة الباحث وشهرة علمية التي متميزة وتفاضله عن غيره.
ثانياً: إنّ المدقّق المتأمل في روح البحث يميز الفرق بين نوعين من الاصطلاحات:
1ـ ما لا فائدة منه؛ إلا كمصطلح نحب أن نطعِّم به البحث لبيان علمية الباحث ودقته.
فعندما يطرح الباحث الدليل على وجود الله مثلاً، فيقول:نبيِّن ذلك بطريقين:
الأوّل: بالعلة على وجود المعلول؛وهو المعبَّر عنه بالطريق (اللّمي).
الثاني: بالمعلول على وجود العلة؛وهو المعبَّر عنه بالطريق (الإني).
ففي الحقيقة إن التعبير باللمِّي والإنِّي من الترف العلمي الذي لا داعي له؛ لأنه لم يزد المعنى سوى اسم المصطلح.
2ـ ما تحصل الفائدة به، فالاصطلاح في فكره لبيان تمام المعنى، فهو خادم للمعنى المراد، فمصطلح (التناقض) مثلاً؛ لا بُدَّ من ذكره عندما يقع الباحث فيه. وكذا لو كان مصطلحاً قرآنياً كما بين سنته تعالى مثلاً في الاستدراج، يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِآيَاتِنَا سَنَستَدرِجُهُم مِّن حَيثُ لَا يَعلَمُونَ * وَأُملِي لَهُم إِنَّ كَيدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: 182 ـ 183].
وكذا سنّة كيده تعالى على من يكيد ظلماً، يقول تعالى: ﴿إِنَّهُم يَكِيدُونَ كَيداً * وَأَكِيدُ كَيداً﴾ الطارق: 15 ـ 16].
الخلاصة
إن الحياة الرسالية التي ينبغي على العالم الرباني تجاوزها هي عدم الغوص في بحور المصطلحات العلمية التي ـ غالباً ـ ما تعبِّر عن التّرف العلمي الذي ـ للأسف ـ على أساسه أصبح المقياس والميزان في رتبة العالم ودرجة ورفعته في أكثر مراكز دراساتنا الشرعية ـ، مع أن المقياس الحقيقي للعالم ليس منوطاً بملَكة التَّفنن في استخدام المصطلحات العلمية..، بل بقدرته على الوصول للحق، وتوصيله للناس بشكل واضح ومبين، وقد أكد القرآن الكريم على أن رفعة العالم العالية تكمن بالفهم الصحيح، ومعرفة الحق والعمل به بإخلاص؛ كي يرتقي في مقامات التقوى ودرجاتها؛ لينال الجزاء الكريم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلنَكُم شُعُوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13].
وقد حذرنا الإسلام الحنيف من مزالق الانكباب على العلم بغية العاجلة الزائلة؛ فمن كلام لأمير المؤمنين(ع): ومن طلب العلم للدنيا والمنزلة عند الناس، والحظوة عند السلطان، لم يصب منه باباً إلا ازداد في نفسه عظمة، وعلى الناس استطالة، وبالله اغتراراً، ومن الدين جفاء فذلك الذي لا ينتفع بالعلم، فليكُفَّ وليُمسك عن الحُجَّة على نفسه، والندامة والخزي يوم القيامة([10]).
([1]) أستاذ الدراسات العليا في جامعة المصطفى(ص) العالمية في دمشق.
([2]) أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 3: 226، دار الوطن الرياض، ط1، 1420هـ ـ 1999م.
([6]) تحنك في برنسه: أي: ترك الناس و توجه للعبادة.
([8]) فهو يحرص من أعز إخوانه تعكير صفو خلوته بذي الجلال والجمال عزَّ اسمه تعالى.